
هكذا تحدث سعد البازعي
أحمد المطلق


قراءة تحليلية في خطاب الدكتور سعد البازعي
التقرير بنسخة PDF
يُعدّ الدكتور سعد البازعي واحدًا من أبرز الأسماء في المشهد الثقافي السعودي والعربي منذ الثمانينات، حيث ساهم بفاعلية في تشكيل الخطاب النقدي وتطوير مساراته، عبر كتاباته، محاضراته، وظهوره الإعلامي الممتد لعقود. لقد تميز بحسّ تحليلي عميق يجمع بين المنهج الأكاديمي والانفتاح على قضايا الثقافة المعاصرة، ما جعله يُشكّل مرجعية فكرية لدى جيل من المثقفين والباحثين.
ينطلق هذا التقرير من الحاجة إلى توثيق وتحليل هذه التجربة النقدية المتراكمة، لا من خلال الكتب والدراسات فحسب، بل عبر لقاءاته التلفزيونية والإعلامية التي مثّلت مرآة صادقة لتطور أفكاره وتحولاته المعرفية. فهذه اللقاءات لم تكن مجرد محاورات عابرة، بل مواقف فكرية معلنة، تتجلى فيها ملامح رؤيته الأدبية، وأسئلته عن الحداثة، والمثقف، والهوية، والنقد.
بهذا المسار المنهجي، يسعى التقرير إلى تقديم ملف أدبي نقدي شامل للدكتور سعد البازعي، يمكّن القارئ من التعرّف على أبعاد مشروعه الثقافي، وتفاصيل مسيرته، من خلال صوته هو، كما عبر عنه في فضاءات الحوار والظهور العام.
المقدمة
منهجية التقرير
يعتمد هذا التقرير على منهج وصفي-تحليلي يقوم على متابعة وتحليل اللقاءات التي شارك فيها الدكتور سعد البازعي منذ أول لقاء منشور وحتى اليوم، مع التركيز على:
- تحليل زمني: تتبع تطور خطاب الدكتور البازعي عبر مراحل زمنية محددة، وربطها بسياقاتها الثقافية والاجتماعية.
- تحليل موضوعي: تصنيف محتوى اللقاءات بحسب الموضوعات التي ناقشها، مثل، موقفه من الحداثة والنقد العربي، دور المثقف في المجتمع، العلاقة بين المركز والهامش، قراءاته للثقافة الغربية، آراؤه حول الرواية والشعر والسرد
- تحليل لغوي وفكري: دراسة المصطلحات التي يوظفها، والأساليب الحجاجية التي يتبعها، ومدى ثبات أو تحول موقفه في القضايا الجوهرية.
- الاستناد للنصوص الأصلية: جميع التحليلات مبنية على نصوص اللقاءات كما وردت، سواء في البرامج التلفزيونية أو الأمسيات الثقافية أو الحوارات المسجلة، دون اجتزاء أو تأويل خارج السياق.
- المقارنة بالنتاج الكتابي: كلما أمكن، يُستأنس بمقارنة مواقف الدكتور البازعي في اللقاءات مع ما ورد في كتبه ومقالاته، لإبراز التقاطعات أو الفوارق إن وجدت.



عمل على هذا التقرير:
- أحمد المطلق - رائد أعمال في المشاريع الثقافية والمشرف على منصة أدب ماب.
- فريق عمل أدب ماب - مجموعة من الشباب والشابات الكتّاب والمحررين والمصممين.
سعد البازعي في أرقام
٥ مليون+
إجمالي عدد مشاهدات لقاءات د. سعد البازعي على منصة يوتيوب.
(فيديوهات ٣٠ دقيقة وأكثر لاتشمل المكررة منها)
٦ مليون+
عدد مشاهدات تغريدات د. سعد البازعي على منصة X خلال سنة واحدة.
(٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٥)
٤٠٠ لقاء+
عدد اللقاءات، المحاضرات، الندوات، المقابلات التي أجراها د. سعد البازعي طوال مسيرته.
(بناء على منشورات د. سعد البازعي في منصة X)
٢٠٠ لقاء+
عدد اللقاءات، المحاضرات، الندوات، المقابلات المنشورة على منصة يوتيوب.
(فيديوهات ٣٠ دقيقة وأكثر لاتشمل المكررة منها)
٤٠ لقاء+
عدد اللقاءات، المحاضرات، الندوات، المقابلات التي أجراها د. سعد البازعي خلال سنة واحدة.
(٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٥)
٩٠ ألف+
عدد متابعين الدكتور سعد البازعي في منصة X.
٤٠ ألف+
عدد منشورات الدكتور سعد البازعي على منصة Xمنذ إنشاء حسابه في فبراير ٢٠١١.
(تشمل إعادة النشر والردود والاقتباسات)
٣٥ كتاب+
عدد الكتب التي ألفها أو ترجمها د. سعد البازعي.
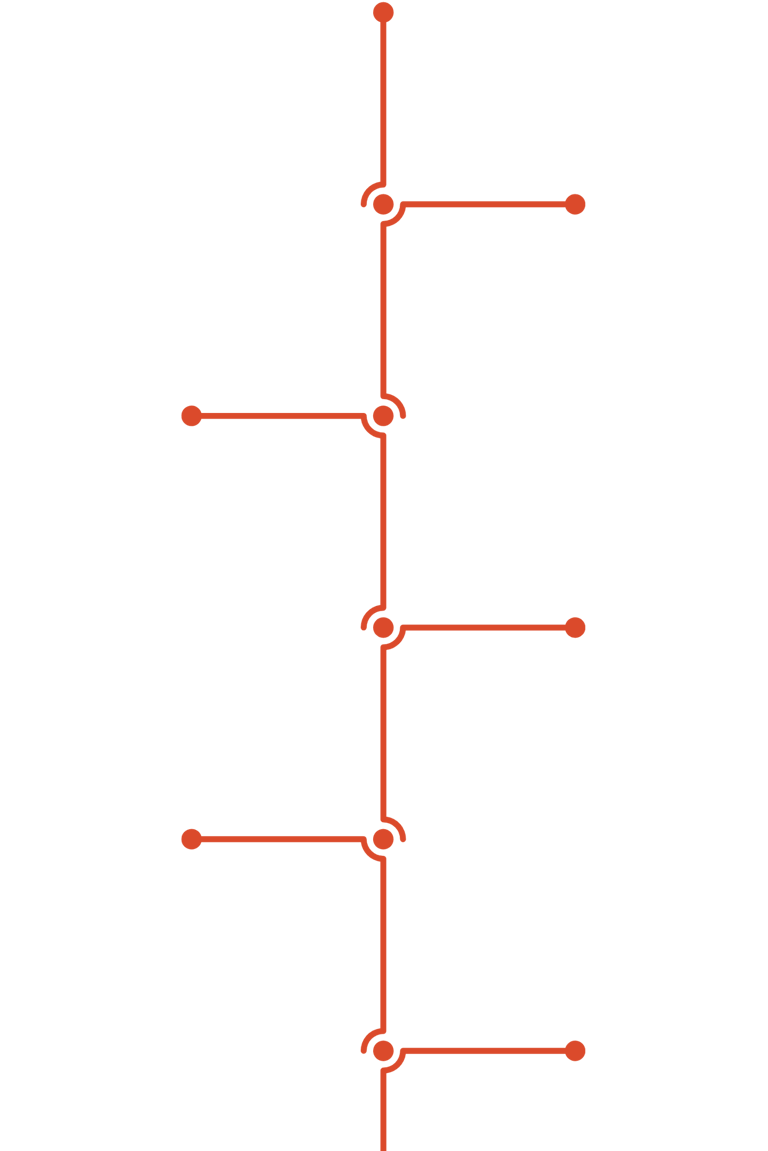
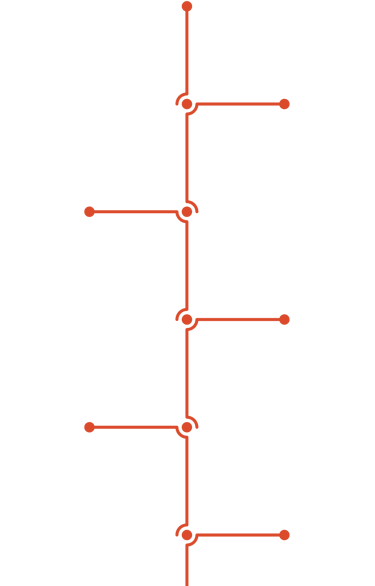
وُلِد سعد البازعي في عام ١٩٥٣ م في مدينة القريات، وينتمي لعائلة البازعي من القصيم، عمل والده في التجارة مع "عقيلات الشمال"، ثم انتقل ليعمل رئيس بلدية دومة الجندل.
مسيرة الدكتور سعد البازعي
تأثر في طفولته بالمحيط الشفهي للشمال من خلال البيئة البدوية والشعر النبطي والمسامرات، وكان لمكتبة سكاكا العامة التي افتتحها خاله الأمير عبدالرحمن السديري، دور محوري في توجيه اهتمامه بالقراءة الشعرية والأدبية.
تنقل بين الشمال والرياض في طفولته، ما أثر على انتظام دراسته، فدرس جزءًا من الابتدائية في الرياض، ثم عاد للشمال، لكنه يعتبر الرياض مدينته الحقيقية من حيث التكوين.
دخل قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود رغم أنه لم يكن قويًا فيها في بداياته إلا أنه اكتشف طرقًا جديدة لتعلّم اللغة، وبدأ من هناك رحلته مع الأدب الأجنبي.
عمل في الصحافة مبكرًا، وكان في تلك الفترة أيضًا يكتب الشعر ويعرضه على أصدقائه، لكنه لاحقًا تخلى عن الشعر لصالح البحث الأكاديمي بعد الابتعاث إلى الولايات المتحدة.
في عام ١٩٨٣ نال الدكتوراة وتخصّص في الاستشراق، وكتب أطروحته للدكتوراه عن الصورة العربية في الأدب الغربي.
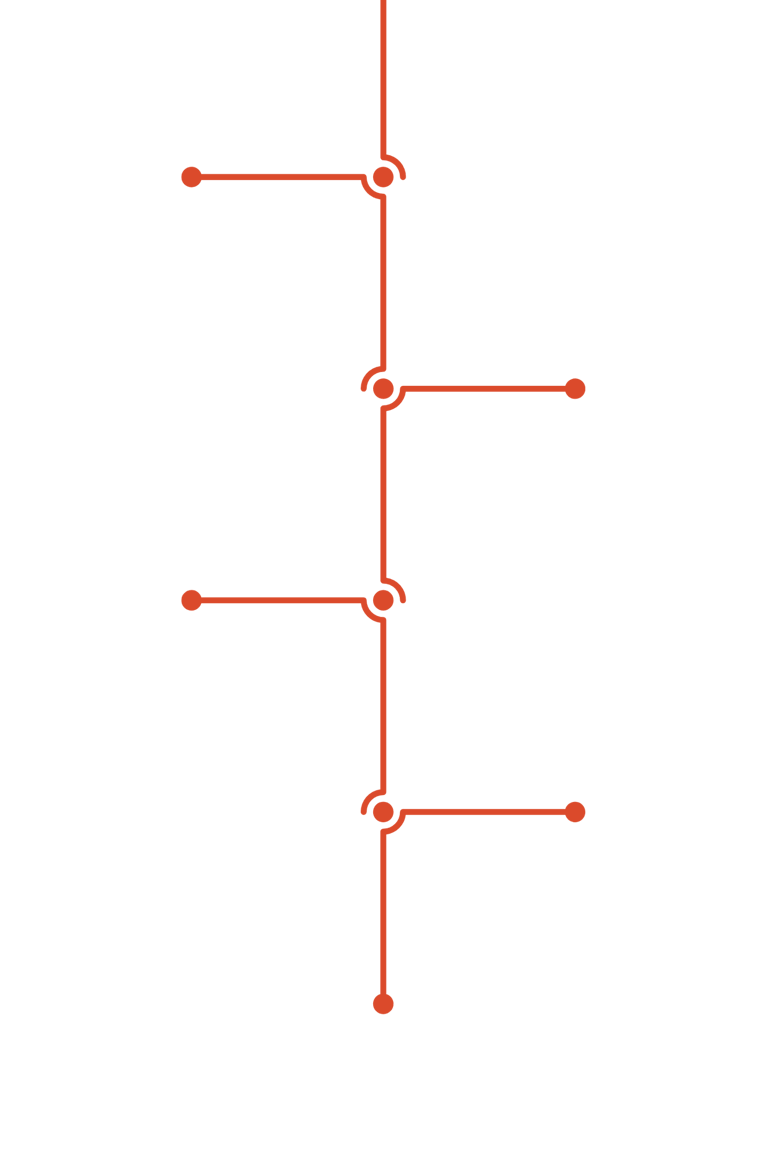
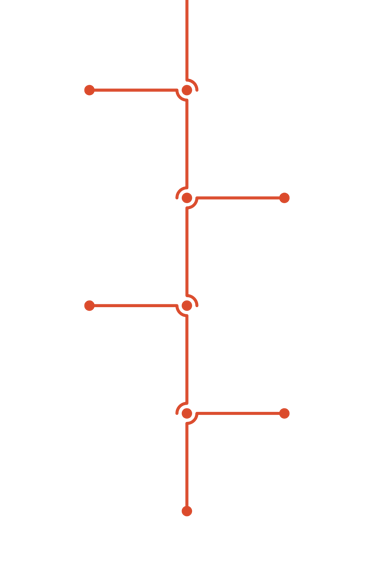
بدأ مشواره النقدي عبر إصدار كتابه الأول "ثقافة الصحراء" ١٩٩١، الذي مثّل انغماسه الفعلي في الأدب السعودي، رأى في النصوص الشعرية والقصصية الجديدة ظاهرة لجوء الأدباء إلى الصحراء كرمز بديل عن المدينة.
بدأ بخوض معارك الأصالة والمعاصرة منذ الثمانينات، ويعتقد أن التيار التجديدي كسب المعركة بوضوح، وأن التغيير الثقافي الحالي غير قابل للرجوع.
شغل مناصب عديدة في لجان وهيئات، آخرها رئيساً لجائزة القلم الذهبي وقبلها لجائزة البوكر العربية ٢٠١٤، يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة. كما كان عضوًا سابقًا في مجلس الشورى السعودي ٢٠٠٩.
نال د. سعد البازعي عددًا من الجوائز والتكريمات البارزة، من بينها؛ جائزة كتاب العام من وزارة الثقافة والإعلام (٢٠١٢)، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في فرع النقد الأدبي (٢٠١٧)، جائزة البحرين للكتاب عن كتابه هموم العقل (٢٠١٨)، تكريمه كشخصية ثقافية لمعرض الكويت الدولي للكتاب (٢٠٢٣)، كذلك حصوله على جائزة الدوحة للكتاب العربي (٢٠٢٤).
على امتداد أكثر من أربعة عقود، تبلور خطاب الدكتور سعد البازعي كأحد أكثر الخطابات الثقافية والنقدية تركيبًا وامتدادًا في المشهد السعودي والعربي. وقد تشكّل هذا الخطاب عبر تقاطعات متعددة بين النقد الأدبي، الترجمة، الفلسفة، الفكر الغربي، والاستشراق، منطلقًا من خلفية أكاديمية متينة، وتجربة نقدية انخرطت في حركة الحداثة منذ الثمانينات، وامتدت لتشمل قضايا العالم المعاصر من زاوية عربية واعية. أبعاد الخطاب عند البازعي:
ملامح خطاب د. سعد البازعي
نقد الأدب بوصفه مدخلًا لفهم الحياة
يرى البازعي أن الأدب الحقيقي لا ينفصل عن الحياة، بل يتشابك معها عبر مستويات سردية ولغوية تعكس التحولات الاجتماعية والفكرية. لذا، فإن موقفه من الأعمال الأدبية ينبع من "ذائقة معرفية" تشترط المعنى والجمال معًا، بعيدًا عن الاستسهال الجماهيري.
جدل الحداثة والأصالة
يُعد البازعي أحد رموز الحداثة السعودية في الثمانينات، لكنه لم يكن حداثيًا بالصوت العالي، بل بالتحليل النقدي المتأني. ولذلك ظل يراجع هذا المشروع، ويطرح أسئلته على ذاته وعلى المشهد الثقافي، بما في ذلك العلاقة بين ثقافة الصحراء، المدينة، والهوية الوطنية.
الترجمة والمثاقفة لا تعني التبعية
يحمل مشروع البازعي في الترجمة رؤية تتجاوز النقل، نحو "إعادة فهم الذات" من خلال الآخر. وهو ينتقد "قصور العرب في فهم الغرب"، مقارنة بما أنجزه المستشرقون في فهم العرب، ما جعله ينشغل بقضايا الاستشراق، الغيرية، والعولمة، ويترجم أعمالًا نوعية مثل "جدل العولمة" لنغوغي واثيونغو.
نقد الفكر الغربي من داخله
لا يتبنى البازعي موقفًا عدائيًا من الغرب، بل يمارس تفكيكًا داخليًا لمقولاته الكبرى، خاصة فيما يتعلّق بالحداثة، العقلانية، الفلسفة، واليهودية في الفكر الغربي. وهو يتفاعل بوعي مع مفكرين مثل إدوارد سعيد، ميشيل فوكو، تيري إيجلتون، وعبدالوهاب المسيري دون التماهي الكامل مع أيٍّ منهم.
تجاوز الثنائيات والحدود الصلبة
يتحرّك خطابه خارج الثنائيات المألوفة؛ شرق/غرب، تراث/حداثة، أدب/فكر. فالأدب عنده لا يُفصل عن الفلسفة، ولا يمكن فهم المفاهيم النقدية دون وعي اجتماعي وسياسي. يتقصّد المناطق الرمادية التي يصعب تصنيفها، حيث تتكوّن الرؤى المركّبة.
المثقف كفاعل نقدي لا دعائي
يرفض البازعي اختزال المثقف في وظيفة تزيينية، ويراه فاعلًا في تشكيل الوعي، خاصة حينما يتعلّق الأمر بمواقف أخلاقية أو سياسية. لذلك فإن خطابه يتقاطع مرارًا مع قضايا مثل الفساد، السلطة، الرقابة، والحريات، دون أن يقع في فخ التبشير أو التنظير المجرد.

١
٢
٣
٤
٥
٦
يُعد كتاب «المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية» الصادر عام ٢٠٠٧ من أكثر الأعمال الفكرية التي أثارت نقاشًا داخل الأوساط الثقافية العربية، لا فقط بسبب جرأة موضوعه، بل لكونه يأتي من مفكر وناقد سعودي، لم يكتب من موقع الدفاع، بل من موقع الفهم والتحليل الحضاري. وقد استعرض الدكتور سعد البازعي محاور هذا الكتاب في عدة لقاءات ومقابلات أهمها حلقة مطولة من بودكاست فنجان، لخص فيها رؤيته حول أثر الجماعات اليهودية في صياغة الغرب، مركزًا على الأبعاد التاريخية والفكرية والاجتماعية، شكّل فيها الدكتور سعد البازعي مقاربة فكرية جريئة لم يسبقه إليها الكثير من المفكرين العرب، إذ لم ينطلق من الموقف السياسي ولا من أسطرة المؤامرة، بل من أسئلة حضارية وفلسفية هي كيف تشكّلت الحضارة الغربية؟ وما دور الجماعات اليهودية في هذا التشكّل؟
اليهود
يرى البازعي أن الجماعات اليهودية كانت، حتى القرن الثامن عشر، محصورة في "الغيتوهات" الأوروبية، محرومة من التعليم والمشاركة العامة. لكن مع مجيء نابليون وتراجع هيمنة الكنيسة في عصر التنوير، بدأ اندماجهم التدريجي. هذه النقلة لم تكن مجرد تحرر اجتماعي، بل إيذانًا بانخراطهم العميق في نسيج الفكر الغربي. وكان باروخ سبينوزا أول هذه العلامات المفصلية. طُرد من طائفته في أمستردام، لكنه دشن فلسفة عقلانية تُعد اليوم من أركان الحداثة الغربية. وقد اعتبره البازعي المؤسس الحقيقي لأول خيط متماسك يمكن تسميته "المكوّن اليهودي". عبر محاضراته العديدة، ومداخلاته النقدية، بلور البازعي سمات فكرية تميز إسهام المفكرين اليهود، أهمها:
- الإحساس العميق بالأقلية والاضطهاد: وهذا الشعور، عوض أن يولّد الانكفاء، دفع باتجاه التجاوز والإبداع.
- النزعة نحو التفوق العقلي أو الرمزي: المستندة إلى الإرث الديني لفكرة "شعب الله المختار"، لكنه تحوّل هنا إلى وعي ثقافي حدّي.
- التطرف الفكري: بمعنى الذهاب إلى أقصى مدى في الطرح، كما فعل سبينوزا حين ساوى بين الله والطبيعة، أو فرويد حين نقّب عن اللاوعي بوصفه حقلًا مهملًا.
البازعي لا ينكر تنوّع خلفيات هؤلاء، لكنه يرى أن ثمة خيطًا ناظمًا مشتركًا، يتجاوز اللغة أو الجنسية، ويُظهر أثر الهوية اليهودية بوصفها قلقًا حضاريًا دائمًا. كما استعرض البازعي عددًا من المفكرين والفنانين الذين يمثلون هذا المكوّن، ومن أبرزهم:
- باروخ سبينوزا: أول من فكك التوراة عقلانيًا، مؤسس النقد الديني، واضع حجر الأساس للفكر الحلولي الحديث.
- سيغموند فرويد: علماني متصالح مع هويته اليهودية، يرى أن اغترابه شكل أساسًا لنظرية التحليل النفسي.
- كارل ماركس: رغم إلحاده، دافع عن اليهود كأقلية، وبلور أطروحات عن حقوق المواطنة والانتماء.
- جاك ديريدا: مفكر التفكيك، ناقش التلمود، ووقّع أحيانًا باسم "حاخام".
- مارك شاغال، هاينريش هاينه، حنّا أرنت: نماذج في الفن والشعر والفكر السياسي، يُظهرون الطيف الواسع للمكوّن اليهودي في الحياة الثقافية الأوروبية.
مع صعود النازية، هاجر عشرات الآلاف من اليهود، خصوصًا النخب الفكرية، إلى الولايات المتحدة. ويصف البازعي هذه اللحظة بـ"هدية هتلر لأمريكا"، حيث تحوّلت الجامعات الأمريكية إلى حاضنة جديدة للمفكرين اليهود، وأسهموا في تشكيل الفلسفة، والنقد، والعلوم الاجتماعية، والإعلام. أسماء مثل أدورنو، فروم، هوركهايمر، وأينشتاين، أصبحت محورية في الجامعات الأمريكية، وارتبط حضورهم بما يُعرف لاحقًا بـ"المدرسة النقدية" و"النظرية الاجتماعية الغربية".
السمات الجوهرية للمكوّن اليهودي
في مقابلة مطوّلة، أشار البازعي إلى أن صورة العرب والمسلمين في الأدب الغربي ظلت مؤدلجة، نمطية، وتخضع لتحكم إعلامي. في المقابل، تمّت تنقية صورة اليهود في الإعلام الغربي، ما ساعد على تبلور وعي غربي أكثر تعاطفًا مع اليهود. وأكّد البازعي أن لحظة "الأندلس الرمزية" كانت أكثر لحظات التعايش الإنساني تعبيرًا عن اندماج اليهود، مقارنة بما واجهوه في الغرب.
في استطراد غني ضمن محاضرة "الإعجاب الملتبس"، استعرض البازعي شخصية إغناطيوس جولدتسيهر، المستشرق المجري اليهودي الذي درس في الأزهر. يمثل جولدتسيهر مثالًا على التقاء "الاضطهاد الأوروبي لليهود" مع "العدالة الرمزية للإسلام"، ما ولّد موقفًا أقرب إلى التعاطف العميق منه إلى التحامل. وحلل البازعي نماذج أخرى ليهود تعاطفوا مع الإسلام أو كتبوا عنه من موقع المقارنة، مثل محمد أسد، ليو شتراوس، وسوزان هشل، معتبرًا ذلك امتدادًا للمكوّن اليهودي في فهم الآخر.
حضور اليهود في المخيلة الغربية… وحضور العرب في غيابهم
بين "القابلية للاستعمار" و"الفاعلية الأقلوية"
رغم تباعد الموضوعين، ربط البازعي أحيانًا بين مفهوم "القابلية للاستعمار" عند مالك بن نبي، وبين قدرة الجماعات اليهودية على تجاوز وضعية الأقلية إلى إنتاج ثقافة سائدة. ففي حين كانت بعض الشعوب العربية تعاني "قابلية للاستعمار"، كانت الجماعات اليهودية تنتج "فاعلية ثقافية" داخل المجتمعات التي نبذتها، وهو ما يستدعي – بحسب البازعي – قراءة فلسفية معمقة لتجربة الاضطهاد باعتبارها محفزًا لا قيدًا.
خاتمة: درس في الفهم، لا في التبرير
لم يكن كتاب المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية ولا بودكاست "فنجان" المحطة الوحيدة التي خاض فيها الدكتور سعد البازعي هذا الملف الشائك. بل امتدت مقاربته للموضوع على امتداد لقاءات متعددة، توزعت بين محاضرات ثقافية وبرامج تلفزيونية، أكدت أن المكوّن اليهودي ظل ثابتًا تحليليًا في خطاب البازعي، ضمن اهتمامه الأوسع بتاريخ الأفكار والنقد الثقافي.كل هذه اللقاءات تؤكد أن اهتمام البازعي بالمكوّن اليهودي ليس مجرد كتاب منفصل، بل تيار تحليلي مستمر في مشروعه الفكري، يتقاطع فيه التاريخ بالفلسفة بالهوية. إن أطروحة دور اليهود في بناء الحضارة الغربية كما قدّمها سعد البازعي لا تنطلق من تطبيع ثقافي أو تمجيد، بل من محاولة تفكيك سردية الآخر وفهم كيف تحوّل شعور الأقلية إلى قوة إنتاج معرفي. ولعل رسالته الأعمق هي دعوته للعرب أن ينظروا إلى هذا المسار الطويل، لا بعين العداء ولا بعين الإعجاب، بل بعين الفهم النقدي الذي يعترف بالأثر، ويستوعب المغاير، ويسعى إلى صياغة فاعلية ثقافية عربية مماثلة، تنطلق من سؤال: "كيف نصنع فكرًا يخرج من القلق إلى التأثير؟"
١٧


لقاء بودكاست فنجان: علاقة اليهود بنشأة الحضارة الغربية، مع د. سعد البازعي.


ترتيب الحلقة من حيث عدد المشاهدات من بين ٢٥٦ حلقة قام بودكاست فنجان بإنتاجها.
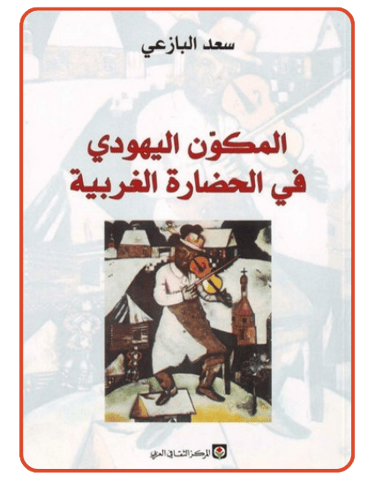
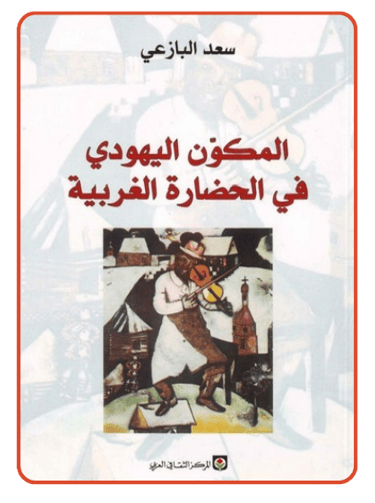
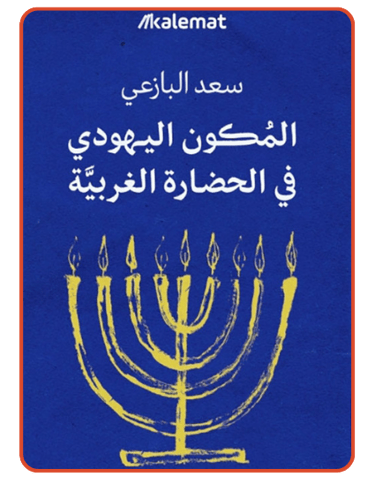
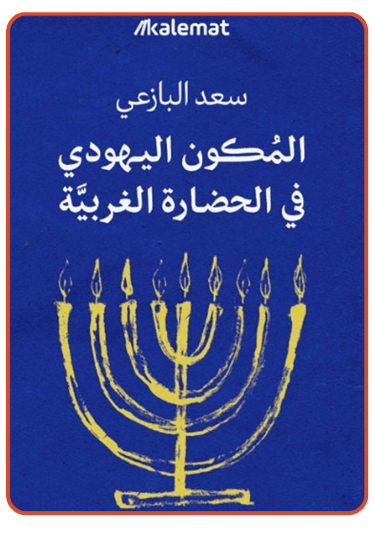
ضمن لقاء في صالون سمو الحرف الثقافي في يناير ٢٠٢٤، أفرد الدكتور سعد البازعي حيزًا خاصًا للحديث عن الطبعة الثانية من كتابه المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية، مبينًا أنها ليست مجرد إعادة طباعة، بل إعادة قراءة وتوسيع لمشروعه الفكري حيث أدرج مفكرين لم يُتطرق لهم في الطبعة الأولى، كما قدّم قراءة أكثر نضجًا لفكرة أن شعور اليهود بالانتماء إلى أقلية مضطهدة كان دافعًا لتفوقهم الفكري والإبداعي. أبرز في هذه الطبعة خلافه مع الدكتور عبدالوهاب المسيري، وناقش الرؤيتين المتباينتين حول العلاقة بين الهوية والإنتاج الفكري.





نحن لا نعرف عنهم شيئًا، بينما هم يعرفون عنا كل شيء
نقطة الخلاف مع عبدالوهاب المسيري
يُعد الخلاف بين الدكتور سعد البازعي والمفكر عبدالوهاب المسيري من أبرز محاور النقاش في سياق الحديث عن أثر اليهود في الحضارة الغربية. فعلى الرغم من تأثر البازعي بأعمال المسيري ومشروعه الموسوعي، إلا أن موقفه النقدي منه كان حاسمًا في مسألة جوهرية: هل يمكن الحديث عن "مكوّن يهودي" في الفكر الغربي؟
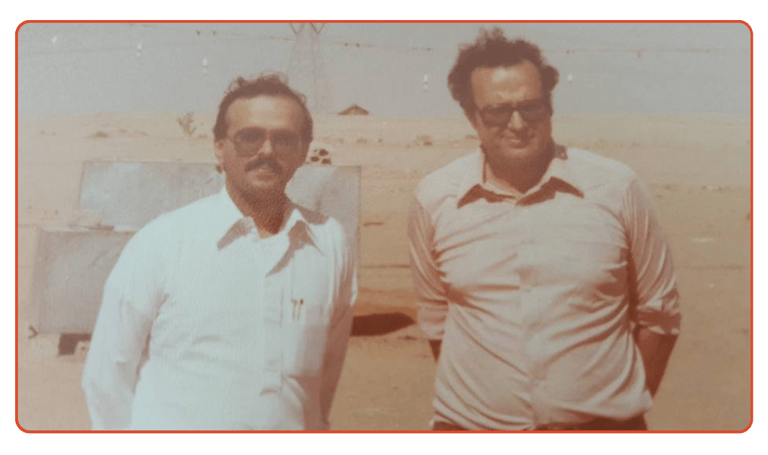
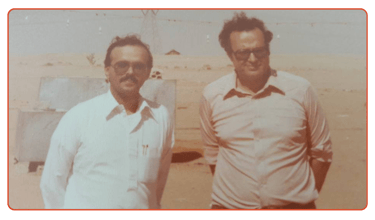
سعد البازعي مع عبدالوهاب المسيري في رحلة برية (الثمامة، الرياض في أواسط الثمانينات)
كافكا بين العرب وثعالب اليهود
ضمن لقاء في "اثنينية البازعي" بتاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢٥، قدّم الدكتور سعد البازعي محاضرة جديدة تمثل إضافة نوعية لأطروحته عن المكوّن اليهودي، من خلال قراءة أدبية معمّقة لقصة "ثعالب وعرب" لفرانز كافكا. افتتح البازعي المحاضرة بالإشارة إلى أنه تعمّد إدراج "اليهود" في عنوان المحاضرة رغم أن القصة لا تذكرهم صراحة، مبرّرًا ذلك بكون التأويلات النقدية الحديثة، ومنها أعمال جوديث بتلر، تقرأ الثعالب كرمز لليهود المحافظين الذين مارسوا ضغوطًا على كافكا في نهاية حياته للالتحاق بالمشروع الصهيوني. استعرض البازعي سرد القصة بدقة، مبيّنًا كيف أن الثعالب تطلب من الراوي الأوروبي القادم من الشمال أن يخلّصها من "العرب"، من خلال مقص صدئ يمثل وسيلة قتل رمزية.
ويُقابل هذا الطلب بتدخّل شخصية "العربي" الذي يحمي الراوي ويمنع الجريمة، فيتحول المشهد إلى صراع رمزي بين اليهود كأقلية متوترة تحمل حقدًا عتيقًا، والعرب كطرف مُدان لكنه أيضًا مُقاوِم. فسّر البازعي الراوي الأوروبي بوصفه إما المخلّص الموعود في اللاهوت اليهودي أو الاستعمار الغربي الذي وظّفه اليهود تاريخيًا لتحقيق أهدافهم القومية. وأشار إلى التوازي التاريخي العجيب بين زمن كتابة القصة (١٩١٧) وصدور وعد بلفور، ما يجعل النص أشبه بـ"نبوءة أدبية" تفضح القلق الصهيوني المبكر ورغبته في استخدام الآخر لتحقيق مشروعه. المحاضرة تمثل إضافة لافتة في مشروع البازعي عن "المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية"، إذ تربط الأدب بالتاريخ، وتوظّف قراءة كافكا بوصفه أعقد الأصوات اليهودية في القرن العشرين، وأكثرها نقدًا للجماعة من الداخل.
يرى المسيري أن المفكرين اليهود مثل فرويد وماركس وديريدا ليسوا يهودًا فكريًا، بل نتاج بيئة أوروبية علمانية، وأن نسب أفكارهم إلى اليهودية يُعد اختزالًا وخطأً منهجيًا. أما البازعي، فيخالف هذا الرأي، ويرى أن ثمة رابطًا هوياتيًا وجماليًا وأخلاقيًا مشتركًا بين هؤلاء، حتى لو لم يكونوا متدينين. فالشعور بالأقلية، والوعي بالاضطهاد، والتوتر بين الانتماء والاندماج، كلها عناصر تُسهم في تكوين ما يسميه "المكوّن اليهودي"، لا بوصفه طابعًا دينيًا، بل كطاقة ثقافية كامنة. ويضيف أن الإسهام اليهودي في الغرب ليس مسألة أصول أو عقائد، بل "موقع حضاري" تحوّل من الهامش إلى التأثير، ويجب فهمه من هذا المنطلق.
٤,٣
مليون مشاهدة حققته حلقة علاقة اليهود بنشأة الحضارة الغربية، حتى تاريخ هذا التقرير.
يتناول سعد البازعي الاستشراق بوصفه مجال معرفي مركّب، أنتج معرفةً كبرى عن العالم الإسلامي، لكنه وقع أيضًا في حبائل السياسة والاستعمار. يرى أن أهم ما يجب فعله اليوم ليس رفض الاستشراق، بل تفكيكه، وتمييز ما هو إنتاج علمي حقيقي، عن ما هو توظيف أيديولوجي واستعماري. وقد لخّص هذا الموقف في ورقته الموسعة بعنوان "غربة الاستشراق" التي ألقاها في المؤتمر الدولي للإستشراق في الدوحة بتاريخ 13 مايو 2025 ، طرح في هذا الورقة فكرة لافتة وهي أن الاستشراق اليوم مهم للعرب أكثر مما هو مهم للغرب. يرى البازعي أن الاستشراق في صورته الكلاسيكية كان جزءًا من إنتاج علمي رفيع، ساهم في حفظ المخطوطات، وترجمة النصوص، وتحقيق كتب التراث الإسلامي. لكنه يشير إلى أن هذا الجهد ظل دائمًا هامشيًا في الوعي الأوروبي، ولم يُدمج فعليًا في السرديات الفلسفية الكبرى. كما يرى أن مفكرون مثل هايدغر وهوسرل، تجاهلوا تمامًا أثر الفلسفة الإسلامية، رغم ما فيها من تجليات عقلانية باكرة. ولذلك يعتبر البازعي أن الاستشراق "مغترب"؛ مهم للعرب والمهتمين بالإسلام، لكنه ليس جزءًا أصيلًا من سردية الغرب عن نفسه.
الاستشراق
برنامج "كتاب ومنعطف": نحو خرائط جديدة لفهم الاستشراق
في سلسلة حلقات ثريّة من برنامجه التلفزيوني "كتاب ومنعطف" في موسمه الثاني الذي بدأ في يناير 2025، أعاد الدكتور سعد البازعي فتح ملف الاستشراق من زوايا متعددة، باحثًا في المدارس المختلفة، وسياقاتها التاريخية، وتمثّلاتها الفكرية. لم يكتف البازعي بإعادة تقديم الأدبيات المعروفة، بل تجاوز ذلك إلى تحليل الأطر المعرفية والسوسيولوجية التي أنتجت الخطاب الاستشراقي، عبر قراءة نقدية وتاريخية متأنية.
في الحلقة الأولى، ناقش حركة الاستشراق من خلال دائرة المعارف الإسلامية، منتقدًا بعض التحيزات البنيوية في هذا المشروع المرجعي، ومُبرزًا التوتر الدائم بين الجهد الأكاديمي والتمثيل الثقافي. أما في الحلقة الثانية، فقد فتح ملف الاستشراق الإسباني، مبيّنًا فرادته الناتجة عن الذاكرة الأندلسية، وكيف أن سقوط الأندلس ظلّ يؤثر في صورة العرب في الثقافة الإسبانية حتى اليوم.
امتدت الحلقات لاحقًا إلى مدارس استشراقية متنوعة: الروسية ذات البعد الاستكشافي والديني، والبريطانية المرتبطة بوضوح بالمشروع الاستعماري، والفرنسية التي تميّزت بالتأسيس المؤسسي واللغوي، ثم الإيطالية التي شكّلت جسرًا جغرافيًا وثقافيًا بين الشرق والغرب. كما تناول البازعي الاستشراق الألماني، مشيرًا إلى افتتان الألمان بالأدب والفكر العربي، قبل أن يختم بسبر خصوصية الاستشراق الأمريكي، الذي لم يُبنَ فقط على خلفية استعمارية، بل انطلق من محاولات "فهم الذات" الأمريكية من خلال الآخر العربي والمسلم، كما تجلّى في تجربة جيفرسون ورفاقه.
قدّم البازعي في هذا البرنامج خريطة بانورامية للاستشراق، قاربت بين البعد المعرفي والتاريخي والسياسي، وأعادت طرح السؤال المركزي: هل كان الاستشراق حقًا علمًا عن الآخر؟ أم خطابًا لتثبيت الهيمنة؟ الإجابة لدى البازعي ليست أحادية، بل متعددة، تُحتّم علينا اليوم إعادة قراءة الاستشراق كمرآة معقدة للعلاقة بين الشرق والغرب، لا تزال مكسورة… لكنها قابلة للتأمل.
يُعدّ البازعي من أوائل من استخدموا مصطلح "الاستشراق الأدبي"، في أطروحة الدكتوراه التي تناولت تمثلات العرب والمسلمين في الأدب الغربي. يشير إلى أن كتبًا مثل ألف ليلة وليلة، تحوّلت في المخيلة الأوروبية إلى أدب "غرائبي"، بعيد عن قيمته الفعلية. ويرى أن الغرب صنع من "ألف ليلة" أدبًا كبيرًا، بينما احتقره النقد العربي الكلاسيكي بوصفه أدبًا وضيعًا. وهذا يكشف التباين في التلقي، وكيف تُصنع القيمة الأدبية أحيانًا من خلال عدسة الآخر.
يرصد البازعي في محاضرته عن الجزيرة العربية في المخيلة الغربية، نماذج شعرية وأدبية تصوّر العربي أو البدوي بطريقة رومانسية أو رمزية مثل جون ميلتون الذي شبّه عبير الجنة بعطر اليمن. كذلك وردزورث الذي رسم بدويًا يحمل حجرًا وصدفة، يتحدث العربية في حلم شعري غامض. أما جيمس جويس فقد دمّر الصورة الرومانسية عن الشرق من خلال مشهد مخيب في قصته القصيرة "Araby". ويؤكد البازعي أن هذه الصور هي تذبذب بين السحر والخيبة، بين التقديس والتشويه، وهو ما يجعل الاستشراق الأدبي مرآةً معقّدة للذات الغربية.
يميّز الدكتور البازعي بشكل دقيق بين تيارين في الاستشراق، الأول هو الاستشراق العلمي الذي قدم دراسات صادقة عن الإسلام، اللغة، الفقه، التاريخ عبر مستشرقين مثل جولدتسيهر، نولدكه، سلفستر دو ساسي. والتيار الثاني هو الاستشراق السياسي الذي أتى بأدوات للهيمنة والتحكم في الآخر الشرقي عبر تقارير استخباراتية، وخطاب استعماري. وهذا التمييز يظهر جليًا في محاضرته عن "الإعجاب الملتبس"، حين تناول نموذج المستشرق المجري إغناطيوس جولدتسيهر، الذي درس في الأزهر وأبدى إعجابًا حقيقيًا بالإسلام العقلي، رغم تعرّضه للرفض في بلده بسبب يهوديته. أطروحة "الإعجاب الملتبس" من أكثر محاور البازعي عمقًا، وتتلخص في أن بعض المستشرقين أحبّوا الإسلام بصدق، لكن ضمن حدود عقلانية لا إيمانية. ضرب مثالاً لجولدتسيهر، الذي رأى في الإسلام صورةً عن معاناة اليهود أنفسهم كأقلية دينية. وأيضاً مثل هاينريش هاينه الذي كتب شعرًا عن الأندلس الإسلامية، ليمرّر من خلاله قلقه اليهودي في أوروبا المسيحية. هذا "الإعجاب" إذًا لم يكن بالضرورة مدحًا، بل نوع من الإسقاط العاطفي والتماهي مع دينٍ عانى من الإقصاء مثلهم.
في إحدى حلقات برنامجه "كتاب ومنعطف"، خصص الدكتور سعد البازعي نقاشًا معمقًا لمشروع "علم الاستغراب" الذي أطلقه المفكر المصري حسن حنفي في كتابه الشهير الصادر عام 1991، مستضيفًا الباحث البحريني الدكتور حسن مدن. يضع البازعي هذا المشروع في سياق محاولات المفكرين العرب لاستعادة زمام المعرفة من قبضة الاستشراق، لا عبر ردود فعل انفعالية، بل بتأسيس علم موازٍ يدرس الغرب من منظور شرقي، ليكون "الاستغراب" مقابلاً معرفيًا لـ"الاستشراق".
يُقدّم البازعي المشروع بوصفه طموحًا فكريًا جادًا لتحويل العرب من موقع "المدروس" إلى موقع "الدارس"، لكنه لا يغفل التحديات المفاهيمية والمنهجية التي تعترض هذا التأسيس. فبالرغم من أن حنفي أراد علماً، إلا أن البازعي وضيفه يلفتان إلى أن المشروع ما يزال في طور "المقدمة"، بل قد يظل كذلك لأجيال قادمة كما أقرّ حنفي نفسه. ويؤكدان أن الطابع الإيديولوجي الغالب عليه، والرغبة في "شيطنة" الغرب أحيانًا، قد تعيق تحوله إلى علم صارم، تمامًا كما أُخذ على إدوارد سعيد في تعميمه النقدي للاستشراق.
وفي نقد أكثر عمقًا، يشير البازعي إلى الغياب شبه التام للمؤسسات الأكاديمية في العالم العربي التي تدرس الغرب كمجال معرفي مستقل، مقارنةً بالتراكم المؤسساتي الاستشراقي في الغرب. فحتى المبتعثون العرب – كما يلاحظ – لا يسهمون في بناء معرفة بالغرب، بل يعززون معرفة الغرب بالعرب، في مفارقة تكشف عن خلل بنيوي في الأولويات الأكاديمية العربية. غير أن قراءة البازعي لا تقف عند حدود التقييم النقدي لمشروع حنفي، بل تتجاوزها إلى إعادة تموضعه ضمن خريطة معرفية أوسع. ففي دعوة مبكرة إلى ما يمكن تسميته "الاستغراب المقارن"، يتساءل عن غياب دراسات عربية منهجية للثقافات الشرقية غير الغربية، كالصين والهند واليابان، مقترحًا أن الانفتاح شرقًا لا يقل ضرورة عن الخروج من المركزية الغربية. ويعزز رؤيته بالإشارة إلى نماذج تاريخية مثل البيروني، الذي درس الديانة والثقافة الهندية بعمق واحترام.
كما يثمّن البازعي لحنفي نقده للسردية التاريخية الأوروبية التي تم إسقاطها على التاريخ العربي، خصوصًا من خلال تصنيفه "الوسطوي" الذي أفقد الحضارة الإسلامية مكانتها بوصفها مركزًا حضاريًا مهيمنًا في زمنها. ويرى في مشروع حنفي – رغم ما قد يُؤخذ عليه – محاولة تأسيسية لوعي عربي نقدي مستقل، يقرأ الغرب بوصفه بنية متناقضة، لا كقدوة أو أيقونة فكرية، بل كمجال معرفي ينبغي تفكيكه بمفاهيم نابعة من الداخل العربي. وفي ختام الحلقة، يؤكد البازعي أن تجاوز المركزية الغربية لا يعني القطيعة مع الغرب، بل فهمه من الداخل، شأنه شأن أي ثقافة كونية، ضمن رؤية أكثر شمولًا للثقافة الإنسانية. وهي مقاربة تجمع بين النزعة النقدية والوعي التاريخي، وتعيد طرح سؤال العلاقة مع الغرب لا كقدرٍ مفروض، بل كموضوع للمعرفة والتحليل والتفكيك.





الاستشراق العلمي والاستشراق السياسي
الاستشراق الأدبي
علم الاستغراب: قراءة البازعي لمشروع حسن حنفي
خاتمة: الاستشراق كمرآة مزدوجة
ينتقد البازعي الموقف العربي الذي تعامل مع الاستشراق إما بعين العداء الكامل أو الإعجاب الساذج. ويطالب بمقاربة ثالثة تقرّ بجهود المستشرقين العلمية، وتنتقد تحاملاتهم وتحزّبهم الإمبريالي، وتؤسس لرؤية "ما بعد استشراقية" تكتب الذات من الداخل. ويشبّه هذه الرؤية بما فعله مالك بن نبي في نقده لـ "القابلية للاستعمار"، أو إدوارد سعيد في كتابه التأسيسي "الاستشراق"، بل يضيف أن سعيد نفسه لم يتعامل كثيرًا مع الاستشراق الألماني أو المجري، ما يُبقي الباب مفتوحًا لتوسيع الدرس.
في فكر سعد البازعي، لا يعود الاستشراق مجرد حقل دراسي، بل مرآة عاكسة لتطوّر الغرب في نظرته إلى الآخر. وهو في جوهره درس في السلطة والمعرفة، وفي هشاشة المركز حين يتأمل الهامش. أما العرب، فإنهم أمام فرصة حقيقية: لا فقط لفهم الاستشراق، بل لتفكيك منطلقاته، وتحرير أنفسهم من صور نمطية ظلوا أسرى لها، سواء كانت مُنتَجة في الغرب أو منسوخة في الشرق.




الاستشراق، كما أراه، لم يعد مشروعًا غربيًا فقط… بل هو مهمة نقدية عربية لم تكتمل بعد
في تقاطعاته المستمرة بين قضايا الاستشراق والترجمة، يفتح الدكتور سعد البازعي نافذةً تأملية لقراءة الدور التاريخي الذي لعبته الترجمة بوصفها الأداة الأولى التي مكّنت الغرب من دراسة الشرق، ثم تمثيله. من خلال قراءته لترجمات المستشرقين للنصوص الإسلامية، خاصة القرآن الكريم منذ القرن الثاني عشر، يكشف البازعي كيف تجاوزت الترجمة حدود النقل، لتتحول إلى وسيلة قولبة وتشويه، غالبًا ما كانت تكتب "الآخر الإسلامي" انطلاقًا من تصورات استعمارية. وفي هذا السياق، يبرز مشروعه الشخصي في مقاومة هذا الإرث عبر ما يسميه: "مقاومة الترجمة بالترجمة".
الترجمة
في حلقة بودكاست شمس بتاريخ 06 ديسمبر 2024، نكتشف سعد البازعي لا كمثقفٍ ناقد فحسب، بل كمشروع ترجمي متكامل. يبدأ رحلته باكرًا بدراسة الأدب الإنجليزي، لا نفورًا من الأدب العربي، بل طموحًا إلى خدمته من منظور مغاير. الترجمة هنا ليست مجرّد تقنية لغوية، بل فعل حضاري، وجسر متوتر بين الذات والآخر.
يروي البازعي كيف تحوّلت الترجمة لديه من وسيلة للتعلّم إلى أداة للمساءلة، ومن قناة للاقتباس إلى منصة للنقد. يشير إلى قراءاته الأولى لشيكسبير، وكيف عاد منها إلى طه حسين والعقاد، هذه المرة كمثقف مسلح بالنظريات الحديثة، لا كطالب ينشد الشرح. بهذا تتشكل المثاقفة كحوار دائم، لا يخلو من الإعجاب ولا من الارتياب.
في قلب هذا الخطاب، يقدّم البازعي رؤية مزدوجة للترجمة: فهي إن أُهملت صارت بابًا للاستلاب، وإن أُتقِنت أصبحت سبيلًا للتحرر. ولهذا لا يرى الترجمة فعلاً محايدًا، بل مشبعًا بالسياسة والاقتصاد، بالسلطة والرمزية.
في محاضرته الموسومة بـ "قلق الترجمة" بتاريخ 22 يناير 2025 يعيد البازعي تعريف الترجمة بوصفها فعلًا قلقًا، محاطًا بالتردد، مليئًا بالمفارقات. يسأل: "كيف نترجم مفهومًا لا وجود له في لغتنا؟ كيف ننقل دلالة ثقافية لا مقابل لها في بيئتنا؟"
يشير إلى معجم وثّق أكثر من 400 مفهوم أوروبي يصعب ترجمتها حرفيًا. يضرب أمثلة حساسة مثل ترجمة "القرآن"، و"Bible"، بل حتى مفاهيم بسيطة مثل "الصيف" تتغير إيحاءاتها من ثقافة لأخرى، كما في سونيت شكسبير.
يقدّم حالات متعددة توضح كيف استُخدمت الترجمة كأداة سياسية؛ من التلاعب باتفاقيات استعمارية في نيوزيلندا، إلى تحوير توماس هوبز لترجمة يونانية تخدم أطروحته السياسية. ويؤكد أن الترجمة الحرفية خيانة للمعنى، والخيال وحده لا يكفي. “الخيانة النبيلة” هي الحل: ترجمة تُصرّح بانحرافها، وتبرره هوامشيًا.
كما يبدي حذرًا من المبالغة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الترجمة، إذ يفتقر للفهم السياقي والثقافي، ويعجز عن التقاط الرموز الشعرية والمعاني الضمنية.
في مشروعه الترجمي المتميّز، قدّم الدكتور سعد البازعي للقارئ العربي عددًا من الأعمال العالمية التي تتقاطع مع اهتماماته النقدية والفكرية، مستندًا إلى رؤية ثقافية موسّعة، جعلت من كل ترجمة فعلاً تواصليًا بين الحضارات، لا مجرد نقل لغوي. فيما يلي أبرز الكتب التي ترجمها، ونبذة عن كل منها، ودوره كمترجم:
في محاضرته "معابر القراءة بين النقد والترجمة"، يذهب البازعي إلى الجذر النظري: الترجمة ليست لاحقة على النقد، بل هي شكل من أشكاله. "كل ترجمة هي قراءة نقدية"، يقول، "وكل قراءة هي عبور إلى نص آخر بلغة أخرى."
يُحلّل قصيدة شكسبير الشهيرة كمثال على ضرورة الوعي الثقافي، ويقارن بين ترجمات رباعيات الخيّام، مبرزًا الفرق بين "الذوق الغنائي" و"الوفاء للنص". يتعمق في قضية "اختفاء المترجم"، ويطالب برد الاعتبار له كمؤلف مشارك، لا مجرد وسيط.
كما يناقش دور الترجمة في الرواية، عبر تحليل ترجمات "الشيخ والبحر"، و"سيدات القمر"، و"الحرب والسلام"، مبرزًا كيف أن الخيارات الترجمية هي قرارات نقدية بالأساس. بل يذهب إلى أن الترجمة تحدث حتى داخل اللغة الواحدة، كما في حالة الشعر الشعبي، الذي يحتاج إلى "تعريب داخلي" قبل نقله للعالم.



يركز الكتاب على الحقبة الذهبية لآسيا الوسطى من خلال سيرة اثنين من أعظم المفكرين المسلمين: ابن سينا والبيروني. ترجمة البازعي هنا تحفر في جدل الحضارة، حيث يعيد تقديم إسهامات المسلمين في الطب والفلسفة والعلوم، بوصفها لحظة تنوير منسية في السرد الغربي. وقد عالج الترجمة بأسلوب يراعي الحس التاريخي والبعد الفلسفي.


قلق الترجمة
الترجمة المقارنة: مدخل إلى النص
في محاضرته الختامية للموسم السادس من الملتقى الثقافي في مايو ٢٠١٩، قدّم الدكتور سعد البازعي ورقة فكرية بعنوان "الترجمة المقارنة: مدخل إلى النص"، مثّلت خلاصة تأملاته حول العلاقة المركّبة بين الترجمة والأدب المقارن، انطلاقًا من إيمانه بأن الترجمة ليست فعلًا تقنيًا أو لغويًا فحسب، بل نشاطًا نقديًا وتحليليًا يتقاطع مع بنى الثقافة، والتلقي، والهوية.
يطرح البازعي أن مقارنة الترجمات المتعددة للنص الواحد تمثل أداة فعالة لفهم أعمق للنصوص، ليس بهدف التحقق من الدقة فقط، بل لاستكشاف أبعاد نصية وجمالية قد لا تنكشف إلا من خلال هذا الاشتباك المقارِن. يشير إلى أن الترجمة نفسها هي عمل مقارني بامتياز، إذ يقارن المترجم بين لغتين، وثقافتين، وغالبًا بين ترجمات سابقة ونصه الجديد. لكن المقاربة التي يدعو إليها البازعي تتجاوز هذا البعد الفني نحو تذوق نقدي متجدد للنصوص، يبرز الفروقات الأسلوبية والثقافية الكامنة في كل محاولة ترجمة.
استعرض البازعي نماذج تطبيقية متنوّعة. بدأ برواية "الشيخ والبحر" لهمنغواي، مقارنًا بين ترجمة منير البعلبكي وترجمة أخرى معاصرة، مبرزًا الفروق الدلالية والإيحائية، خصوصًا في اختيارات لغوية مثل "أبويّ الغلام" ذات الحمولة القرآنية. كما تناول مثالًا فنيًا من قصيدة "سونيت 18" لشكسبير، متتبعًا ثلاث ترجمات عربية لها: ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، محمد عناني، ومترجمة عربية أخرى، كاشفًا عن الاختلافات في الضمائر، والإيقاع، والرمزية، خاصةً في ظل الجدل المعروف حول جنس المخاطَب في القصيدة الأصلية.
ومن الشعر الإنجليزي إلى الشعر العربي، حلّل البازعي الترجمة الإنجليزية لقصيدة "يطير الحمام" لمحمود درويش، منتقدًا بشكل واضح الترجمة التي قلبت خاتمة القصيدة من "يطير الحمام" إلى "يحطّ الحمام"، ما شوّه الثيمة الإيقاعية والدلالية الأصلية، وحرَف البناء الرمزي للنص.
كما أشار إلى تجربة الشاعر الفرنسي إيف بونفوا، الذي رأى استحالة ترجمة الشعر حرفيًا، ودعا إلى كتابة نص جديد على النص الأصلي، وهو ما جسّده في ترجمته لقصيدة "الإبحار إلى بيزنطة" لييتس، حين ترجم العنوان إلى "بيزنطة، الحلم الآخر" بدلًا من الصيغة المباشرة، ما مثّل "إعادة تأويل إبداعي" لا ترجمة حرفية.
في ختام المحاضرة، ناقش البازعي تحديات ترجمة المصطلحات العلمية والثقافية، مستشهدًا بتجربته مع ميجان الرويلي في "دليل الناقد الأدبي". وأكّد أن الترجمة المقارنة لا تقتصر على الشعر أو الأدب، بل تمتد إلى النصوص الدينية والفلسفية، حيث يصبح المترجم في موقع تأويلي حساس، يحتاج فيه إلى وعي ثقافي عميق وتقدير للمسافة بين المرجعيات الحضارية.
رفض البازعي تصنيف الترجمة على أنها "خيانة"، مفضلًا وصفها بأنها "نصٌ جديد على نص"، مقاربة نسبية لما لا يمكن استنساخه. ودعا إلى تعليم الطلاب والطالبات الترجمة عبر ورش تطبيقية، تتجاوز التلقين الأكاديمي نحو النقد والمقارنة، لأن الترجمة، كما يرى، ليست نشاطًا لغويًا فحسب، بل هوية ثقافية واستراتيجية تأويل.
المترجم ناقد بالضرورة
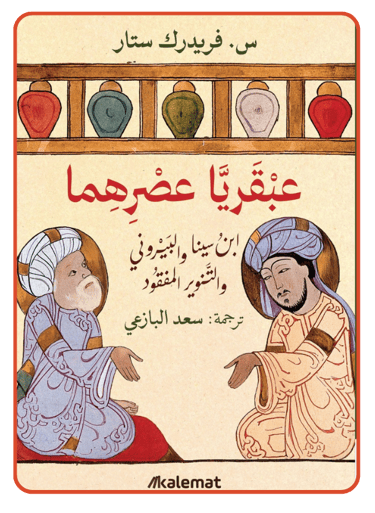
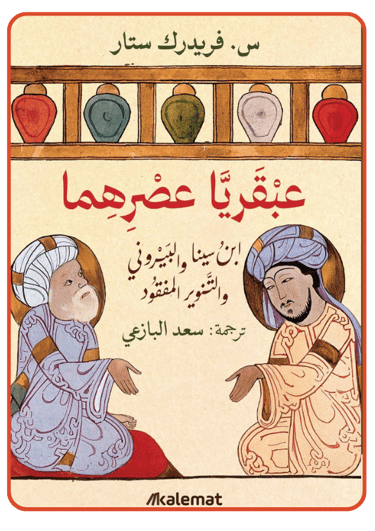
ترجمات الدكتور سعد البازعي
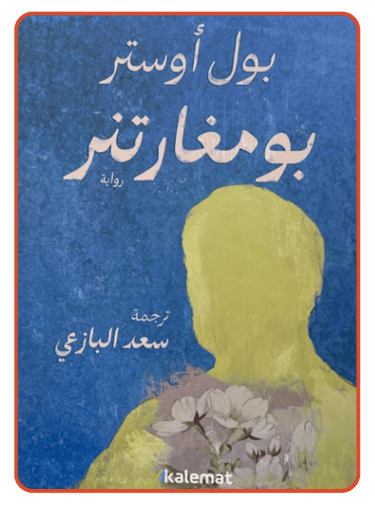
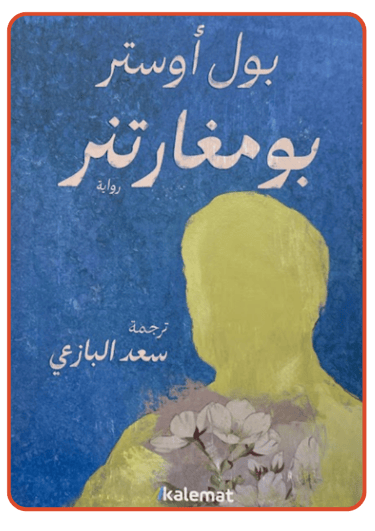
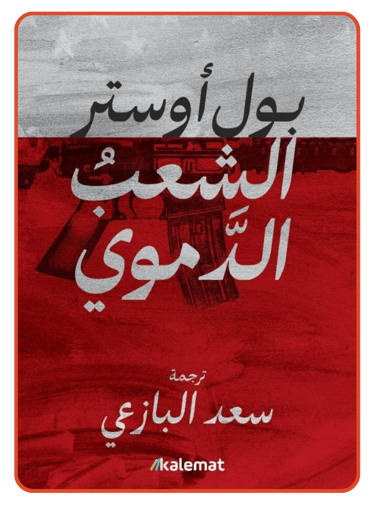
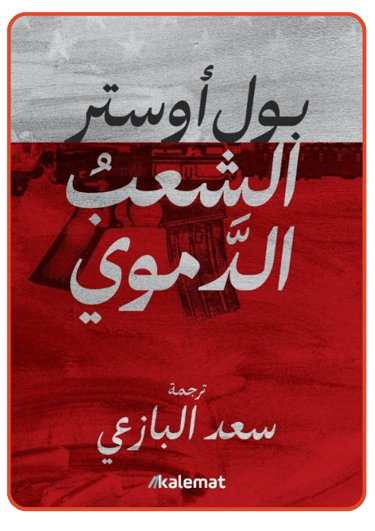
في هذا العمل، يسلّط بول أوستر الضوء على ظاهرة العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في المجتمع الأمريكي، كاشفًا عن الجذور التاريخية والنفسية والسياسية لهذه الأزمة. ترجم سعد البازعي الكتاب بلغة نقدية واضحة، تنقل قلق المؤلف وخوفه على مستقبل بلد يتعايش فيه التنوع العرقي مع موروث دموي من الحروب والتمييز. تميزت الترجمة بدقّتها وحرصها على الحفاظ على نبرة التأمل والاحتجاج الأخلاقي التي تميّز بها نص أوستر، مما جعل النسخة العربية وثيقة ثقافية في فهم البنية العنيفة للمجتمع الأمريكي المعاصر.
عمل سردي معقّد يجمع بين الفلسفة والأدب، ترجم البازعي رواية بومغارتنر بروح الناقد الذي يدرك أهمية كل تفصيلة لغوية وثقافية. في مقدمة الترجمة، يكشف عن التحديات العميقة التي واجهها، من الأسماء ذات الحمولات الثقافية، إلى بنية السرد الشعري. يُبرز البازعي الرواية كعمل مليء بالأسى والبحث عن المعنى، ويقدّمه للقارئ العربي مع شروح وهوامش تدعم استيعاب الخلفيات الثقافية للشخصيات والمواقف.
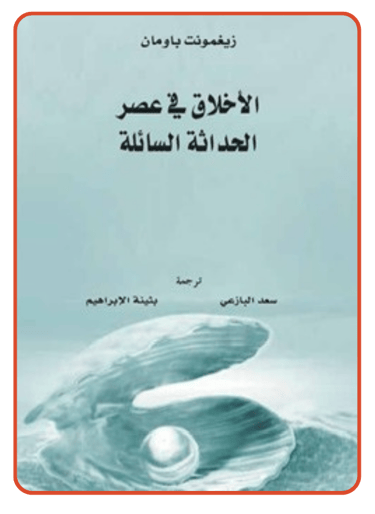
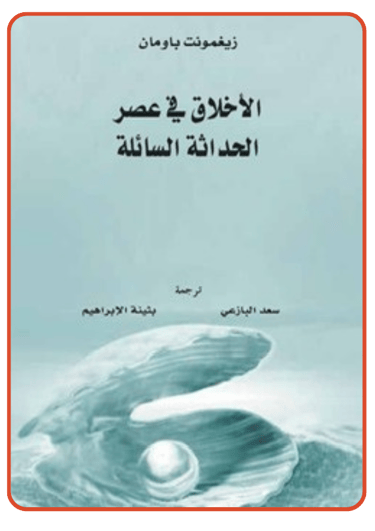
في هذا الكتاب، ينقل البازعي بالاشتراك مع بثينة الابراهيم أطروحة عالم الاجتماع زيغمونت باومان حول ما يسميه بـ"الحداثة السائلة"، حيث تتآكل الثوابت الأخلاقية تحت وطأة النزعة الاستهلاكية المعولمة. الترجمة هنا ليست فقط نقلًا لخطاب نظري معقّد، بل محاولة لإعادة بناء مفاهيمه في سياق عربي معاصر، وقد ساهم البازعي في توطين المصطلحات السوسيولوجية وتحويلها إلى أدوات تحليلية مفهومة للقارئ العربي.
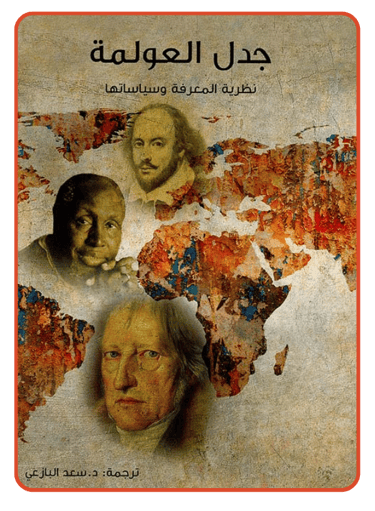

يتناول هذا الكتاب إشكالية العولمة الثقافية ومقاومتها من داخل الثقافات الإفريقية. تعامل البازعي مع هذا النص المليء بالشحنات الأيديولوجية بلغة دقيقة، حافظ فيها على نبض الكاتب ومواقفه الراديكالية ضد الإمبريالية الثقافية، مؤكدًا على فكرة “الجدل الحضاري” كبديل للهيمنة الغربية.
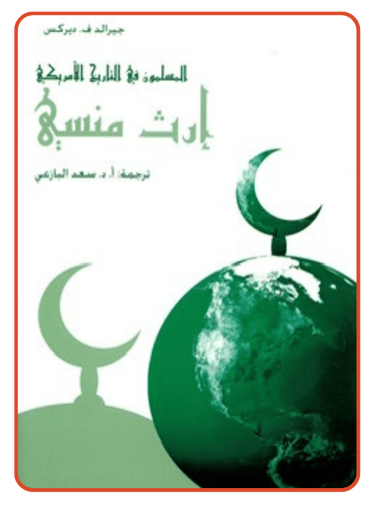
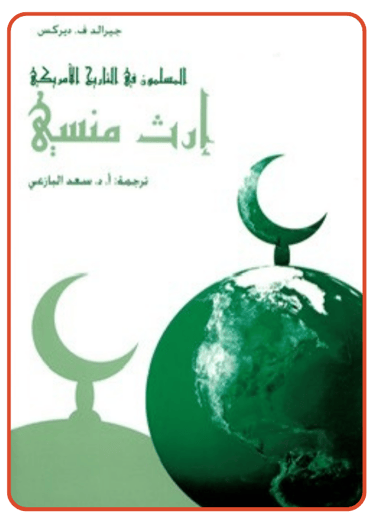
عمل توثيقي مهم يستعرض الحضور الإسلامي في الأمريكيتين منذ ما قبل كولومبوس. الترجمة هنا تتسم بروح استقصائية، حيث لم يكتفِ البازعي بالنقل، بل أرفق الترجمة برؤية شارحة لدوافع المؤلف وتحوّله الديني، وسياق النص داخل التاريخ الأمريكي. يُعدّ هذا الكتاب مساهمة في كشف التاريخ المهمّش وتفكيك الروايات السائدة عن الهوية الأمريكية.
في ضوء هذا الامتداد الفكري المتشعب، تتجاوز الترجمة عند سعد البازعي كونها أداة تواصل بين اللغات، لتغدو أفقًا فلسفيًا ونقديًا يُعيد طرح الأسئلة الكبرى: من يترجم من؟ بأي منظور؟ وبأي سلطة؟ لقد نجح البازعي في تحويل الترجمة إلى فعل مقاومة واعٍ، ورافعة للمساءلة الثقافية، لا مجرد جسر للعبور. تنبع أهمية مشروعه في أنه لا يتعامل مع الترجمة كحقل منفصل، بل يدمجها ضمن بنية نقدية أوسع، تستدعي الاستشراق، وتفكك التمثيلات، وتُعيد النظر في حدود الذات والآخر.
ترجمة البازعي ليست تقنية بل رؤية، وليست حيادية بل متوترة ومشبعة بالسؤال. وهي، في هذا السياق، دعوة مفتوحة للانتباه: أن كل ترجمة تنطوي على تأويل، وكل تأويل هو فعل موقف، وأن الترجمة الجيدة لا تنقل النص فحسب، بل تحرّره من عزلة اللغة، وتعيد كتابته في ضوء ما نحتاجه نحن لا ما أراده الآخر فقط. من خلال هذا التصور، يمكن فهم الترجمة كما يراها البازعي: ليست نشاطًا تابعًا، بل صانعًا للمعنى والهوية. إنها مساحة اختبار مستمرة بين الأمانة والخيال، بين الحرفية والحرية، بين القول والمعنى. وهي، في النهاية، فعل ثقافي بامتياز، لا يكتمل إلا حين يقف المترجم ناقدًا ومبدعًا في آنٍ معًا.
خاتمة الفصل: الترجمة كفعل تأويلي ومقاومة ثقافية
رغم أن الترجمة كانت – ولا تزال – القناة الأبرز التي تمر عبرها المثاقفة، إلا أن المثاقفة عند سعد البازعي تتجاوز كونها مجرد فعل لغوي أو ممارسة نقل، لتصبح منظورًا ثقافيًا شاملًا يتقاطع مع مفاهيم الهوية، والسلطة، والهيمنة، والانفتاح، واللغة، وتشكيل الذات. ولهذا قررنا في هذا التقرير فصل المثاقفة عن الترجمة، لا بوصفها قطيعة، بل باعتبارها توسعة وإضاءة أعمق على أفقٍ متشعّب ومركّب في مشروع البازعي. المثاقفة عنده ليست مجرد نتاج للترجمة، بل هي مساحة فكرية مستقلة، تتداخل مع الترجمة، لكنها تتجاوزها إلى مساءلة البنى الثقافية الكبرى التي تشكّل وعي الأنا وصورة الآخر.
المثاقفة
في لقاء بودكاست "تناص" بتاريخ 31 يناير 2022، تناول الدكتور سعد البازعي مفهوم هجرة المفاهيم بوصفه أحد المحاور الجوهرية في مشروعه النقدي والفكري، موضحًا أن المفاهيم لا تنتقل بين الثقافات كمجرد كلمات أو مصطلحات جامدة، بل بوصفها "كبسولات معرفية" غنية بالمعاني والدلالات والسياقات التاريخية والفلسفية والسياسية، وأن هذه الكبسولات حين تُستورد إلى الثقافة العربية تُستهلك غالبًا بطريقة غير واعية، فتُستخدم دون إدراك لجذورها أو تحولاتها أو ملاءمتها للسياق المحلي.
يضرب البازعي مثالًا على ذلك بمفهوم "الديمقراطية" الذي نشأ في أثينا القديمة، وتطوّر لاحقًا في أوروبا عبر مراحل متعددة، ما جعله يحمل دلالات مركبة تختلف عن معانيه الأولى، ويستحيل نقله إلى ثقافات أخرى دون تفكيكٍ واعٍ لتاريخه ومعانيه. وينبّه إلى أن ما يحدث في السياق العربي غالبًا هو استهلاك لمفاهيم قادمة من الغرب كما تُستهلك البضائع المعلّبة في الأسواق، دون النظر في حاجتنا الحقيقية لها، أو فهم آثارها البنيوية على الوعي والسلوك.
ومن هذا المنطلق، يرى البازعي أن الانشغال بالمفاهيم جزء من مشروع ثقافي يتطلب تفكيك آليات انتقالها واستعمالها، وهو ما سعى إلى تحقيقه في كتابه "هجرة المفاهيم". ويعترف أن اهتمامه بهذا الحقل تأثر بمقالة إدوارد سعيد "انتقال النظرية"، والتي ناقشت الكيفية التي تنتقل بها النظريات النقدية الغربية إلى العالم العربي، مشبّهًا ذلك بحركة مرورية من طرف واحد لا تسير في الاتجاهين. كما أشار إلى كتب أثّرت في تشكّل هذا الوعي، مثل "في العنف" لهانا أرندت، و"مفهوم الأزمة" لإدغار موران، و"الكلمات والأشياء" لميشيل فوكو الذي أعلن صراحة تبرّؤه من حقل "تاريخ الأفكار"، مطالبًا بتجاوزه إلى تحليل أبستيمولوجي يُعنى بالبنى المعرفية العميقة.
يضيف البازعي أن المفاهيم لا تأتي منفصلة عن اللغة، بل أن حضور المفردات الأجنبية في اللغة اليومية — كما في كلمة "أوكي" أو "بوليفارد" — قد يُفضي إلى تآكل اللغة الأم، وإضعاف الهُوية الثقافية، إذا لم يكن استعمالها نابعًا من حاجة معرفية حقيقية. ويشدّد على ضرورة التفريق بين المفاهيم التي لا مقابل لها في العربية فيُستحسن تعريبها، وتلك التي لها بدائل راسخة في اللغة والثقافة، محذرًا من الاستسلام للنماذج الأجنبية بوصفها مقياسًا للتطور أو الحداثة.
كما ناقش مفهوم "النسوية" بوصفه نموذجًا حيًّا لهجرة المفاهيم، مشيرًا إلى أن استقباله في العالم العربي كان انتقائيًا؛ إذ استُقبلت منه الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة باعتبارها احتياجات محلية ملحّة، بينما رُفضت أو أُغفلت الجوانب الأيديولوجية المتطرفة كالتمركز الأنثوي والمجتمع الأمومي. كل هذه الرؤى تصبّ، بحسب البازعي، في دعوة إلى بناء وعي نقدي متزن إزاء حركة المفاهيم العابرة للثقافات، يُمكّن المثقف العربي من التفاعل معها دون انبهار أو قطيعة، بل بفهم واعٍ ومسؤول يعيد توطينها بما يخدم أسئلتنا وسياقاتنا واحتياجاتنا المعرفية.
في محاضرته "أحادية وجهة المثاقفة العربية"، بتاريخ 30 ديسمبر 2020، يستعرض البازعي جذور المثاقفة كفعل إنساني تفاعلي، ويُبيّن كيف تحوّلت في السياق العربي الحديث إلى حالة أحادية المنفذ، مقتصرة على العلاقة بالغرب، مع تغييب شبه تام لبقية الثقافات الكبرى كالهند، الصين، اليابان، وأفريقيا.
هذا الاختزال في التفاعل يؤدي – بحسب البازعي – إلى خلل في الوعي الثقافي، حيث تُستقبل المفاهيم والنظريات الجاهزة من الغرب بوصفها النموذج الوحيد، دون مساءلة أو ملاءمة. وتظهر الآثار المباشرة لذلك في ميادين الأدب والنقد، حين تُفرَض مفاهيم مثل "الرواية" أو "الملحمة" أو "الحداثة" على السياق العربي كما هي، دون تفكير في الخصوصية.
ويرى البازعي أن هذا الانغلاق الاختياري ناتج عن أزمة في تصور الذات، وخوف مَرَضي من الانفتاح المتعدد، إذ يتم الترحيب بالتقنيات الغربية ورفض التأثيرات اللغوية أو الفكرية. ولهذا يدعو إلى إستراتيجية ثقافية تقوم على الانفتاح النقدي الواعي، لا على الانبهار ولا على التحصّن.
تُظهر العلاقة بين كتاب "هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة" للدكتور سعد البازعي، وبين حديثه عنه في بودكاست "تناص"، تكاملاً غنيًا بين النص المكتوب والصوت الشفهي، حيث لا تكتفي المقابلة بشرح ما ورد في الكتاب، بل تكشف البُعد الشخصي والذهني العميق الذي سبق الكتابة وصاحبها وتجاوزها. ففي حين يُقدّم الكتاب مشروعًا نقديًا منهجيًا يرصد حركة المفاهيم بين اللغات والثقافات، ويحلل حضورها في الفكر العربي ضمن فصول دقيقة ومنظمة، جاءت المقابلة لتعيد إنتاج هذا المشروع بصوت المؤلف ذاته، موضحًا السياقات النفسية والثقافية التي دفعته إلى التأليف، ومستعرضًا الدوافع، والمرجعيات، والتحديات التي رافقت صياغة الكتاب.
يعتبر البازعي الترجمة القناة الرئيسية للمثاقفة، لكنها – كما يوضح – ليست قناة محايدة. ففي كل عملية ترجمة يكمن مشروع ثقافي: إما للهيمنة، كما في ترجمات المستشرقين، أو للتحرير، كما في مشروعه هو، الذي يسعى إلى بناء ذائقة عربية معاصرة تتفاعل بندّية مع الآخر.
في بودكاست شمس، وصف المثاقفة بأنها "خط توتر" بين الذات والآخر، لا يمكن حسمه بسهولة. ولهذا يرفض المثاقفة السطحية التي تستهلك المعرفة الغربية كما تُستهلك البضائع، ويسعى إلى تأسيس مثاقفة تُبنى على وعي مزدوج: فهم الذات وفهم الآخر.
ويرى أن المترجم ليس ناقلًا، بل مفكّرًا، وعليه أن يختار، ويُعلّق، ويوجّه، ويقدّم النص بطريقة تخدم الوعي لا تعزز التبعية. من هنا تأتي أهمية الهوامش والمقدمات التي يُصرّ عليها البازعي، والتي تُعيد توطين النص الأجنبي في سياقه العربي دون أن تنفي جذوره.





أحادية وجهة المثاقفة: أزمة الانفتاح الأحادي
المثاقفة والترجمة: خط التوتر
هجرة المفاهيم
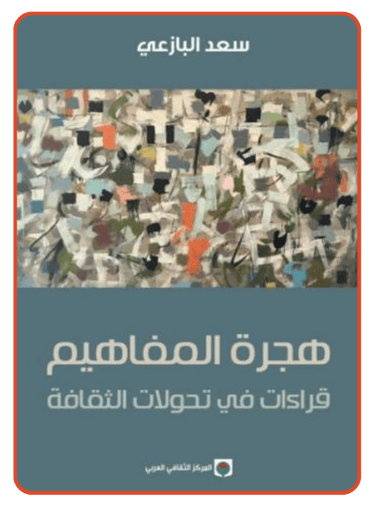
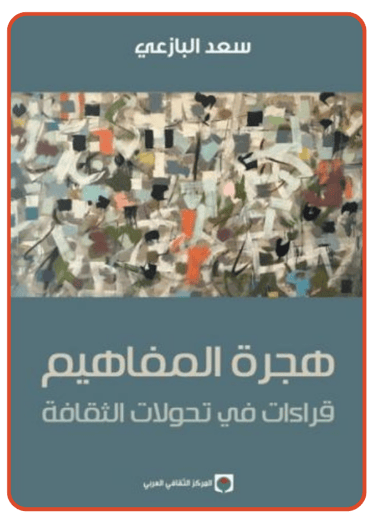
في فكر سعد البازعي، المثاقفة ليست فعل ترف ثقافي، ولا انفتاحًا عشوائيًا، بل مشروع وعي شامل. وعي يُنتج الذات في ضوء الآخر، ويقرأ الآخر من موقع الذات. ولهذا فهو يرفض المركزية الغربية، دون أن يقع في مركزية معاكسة. يدعو إلى الاعتزاز بالثقافة العربية، دون انغلاق، وإلى الانفتاح، دون ذوبان. المثاقفة بهذا المعنى هي جسر نقدي، لا طريقًا باتجاه واحد، وهي مشروع لم يُنجز بعد، لكنه يظل ضروريًا، إذا أردنا أن نكون طرفًا فاعلًا في هذا العالم لا مجرد مستقبل دائم.
جدل العولمة: وجهة نظر أفريقية
في محاضرة مطوّلة بعنوان "جدل العولمة: وجهة نظر أفريقية" بتاريخ 29 نوفمبر 2014، استعرض الدكتور سعد البازعي أطروحاته حول العولمة والمثاقفة من خلال تقديمه لترجمته لكتاب المفكر الكيني نغوغي واثيونغو الصادر ضمن مشروع "كلمة". يبرز البازعي هذا الكتاب بوصفه نموذجًا أفريقيًا ناقدًا للعولمة، مؤسسًا لرؤية مغايرة تنطلق من الهامش لا المركز، ومن ثقافات العالم الثالث لا من مركزية الغرب.
ناقش البازعي مفهوم "العولمة الجدلية" (Globalectics) الذي صاغه واثيونغو بدمج كلمتي global وdialectics، والمستوحى من الجدلية الهيغلية، ليعبّر عن تناقضات العولمة وعلاقاتها المركبة بالثقافات المقهورة. ركّز في حديثه على قضايا المثاقفة المفروضة بالقوة، وعلى مركزية اللغة في مشروع الهيمنة، مستعرضًا تجربة واثيونغو في الدعوة لإلغاء قسم اللغة الإنجليزية لصالح الأدب المحلي، وانتقاده العنيف لاستمرار الثقافة الاستعمارية بعد رحيل الاستعمار السياسي.
وتوقّف البازعي مطولًا عند الصراع بين الثقافة الشفاهية والكتابية، بوصفه صراعًا مثاقفيًا بامتياز، مشيرًا إلى تهميش الغرب للثقافات الشفاهية، مع أن الفلسفة اليونانية – التي يتغنّى بها الغرب – بدأت شفاهية وكانت تنظر للكتابة نظرة دونية. كما استعرض تجربة "المسرح الفقير" لدى واثيونغو بوصفه نموذجًا لإبداع الهامش من رحم الفقر والافتقار، موضحًا أن هذه النظرية ليست فقط مسرحية، بل تمثّل حالة مثاقفة مقاومة في بيئة مستضعفة.
وانتقد البازعي استعلاء هيجل وماركس على الثقافات الأفريقية، مؤكدًا أن نقد ما بعد الاستعمار كما مارسه واثيونغو وفانون وإدوارد سعيد وهومي بابا، يمثل فعل مثاقفة مضادًّا، ويكشف تواطؤ العولمة مع قوى الاستعمار الرمزي والثقافي. ختم البازعي المحاضرة بدعوة صريحة لتعزيز جسور المثاقفة بين العرب وأفريقيا، منتقدًا ضعف الترجمة والتواصل الحضاري بين الثقافتين، ومعتبرًا أن الوعي النقدي بالعولمة لا يكتمل إلا بانفتاح العرب على الثقافات غير الغربية، لا سيما تلك التي تشاركهم الهموم نفسها.
خاتمة: المثاقفة بوصفها مشروع وعي
في واحدة من أكثر حواراته صفاءً وهدوءًا، قدّم الدكتور سعد البازعي في برنامج حديث الثقافة بتاريخ 21 ديسمبر 2023 رؤيته للثقافة بوصفها مجالًا للتفاعل الواعي، لا للتلقّي العفوي، وللتمييز النقدي لا للانبهار. فالثقافة في نظره ليست مجرد تكديس للمعارف أو استهلاك للمفاهيم الجاهزة، بل هي موقف معرفي يتطلّب وعيًا بالسياقات، وحرصًا على ألا تتحوّل أدوات التفكير إلى عبء على التفكير ذاته. يتعامل البازعي مع العلاقة بالثقافات الأخرى بوصفها واقعًا لا يمكن تجاهله، لكنه واقع يتطلّب إدراكًا عميقًا لفروق البيئات واللغات والتجارب. ولذلك، فهو لا يرفض التأثر، بل يرفض التماهي. ولا يعارض الترجمة، بل ينبّه إلى أثمانها المعرفية وتحولاتها الدلالية. الثقافة في مشروعه لا تنفصل عن اللغة، ولا تنفك عن الجغرافيا والعقيدة والتاريخ، لكنها أيضًا ليست أسيرة لها. إنها في منطقة بين، منطقة الوعي بالتشابه دون إنكار الاختلاف، والسعي للفهم دون الوقوع في محو الذات.
الثقافة
يشكّل المشروع الثقافي للدكتور سعد البازعي أحد أبرز المسارات الفكرية التي سعت إلى تفكيك علاقة العرب بالآخر، وتحديد موقع الثقافة العربية في زمن العولمة والتحوّلات المتسارعة. فقد جاءت كتبه امتدادًا لحوار طويل مع قضايا الهوية، المثاقفة، الترجمة، السلطة، والوعي النقدي، وهي حوارات لا تنفصل عن سياق عالمي شديد التعقيد. يضع البازعي لبنات مشروعه في كتاب "شرفات للرؤية: العولمة والهوية والتفاعل الثقافي" (٢٠٠٥)، منبهًا إلى ضرورة التخلص من أوهام الهوية النقية، ومقترحًا رؤية واقعية لمفهوم العالمية تنأى عن الاستلاب دون أن تنغلق. يناقش أثر الغرب في تشكيل الوعي الثقافي العربي، ويواجه التصورات المثالية حول النقاء الثقافي بخطاب يعترف بتشابك الهويات وعبور الثقافات.
تبرز ندوة "اللغة والهوية الثقافية" التي نظمها مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بتاريخ 12 مايو 2025 بالتعاون مع جمعية الأدب المهنية، واستضافت الدكتور سعد البازعي، بوصفها لحظة تأمل معمقة في مفهوم الهوية من منظور لغوي وثقافي. في هذه الندوة، يوضح البازعي أن الهوية الثقافية ليست معطًى بسيطًا يمكن اختزاله، بل هي تركيب معقّد من اللغة، والعادات، والمأكل، والملبس، والموروث الشعبي، والتاريخ، والجغرافيا، وهي تخص الجميع لا النخب وحدها. وتأتي اللغة، بحسبه، بوصفها المكوّن الأهم للهوية: ليست فقط وسيلة تواصل بل مستودعًا للذاكرة ومفتاحًا لفهم الذات والبيئة والماضي. يحذّر البازعي من أن أخطر التهديدات التي تواجه الهويات تبدأ بتفتت اللغة أو تآكلها، مستعرضًا تجارب لغات انقرضت أو همشت، ويشير إلى أن حتى اللغات الكبرى، كالإنجليزية، ليست بمنأى عن التحدي. في المقابل، يرى أن الترجمة يمكن أن تكون جسرًا للتواصل لا وسيلة طمس، بشرط ألا تحل محل اللغة الأم. كما يناقش أثر التعدد العرقي والثقافي داخل المجتمعات، معتبرًا أنه حين تكون الهوية المركزية قوية، فإن التعدد يثريها بدل أن يهددها، مستشهدًا بتجربة الحضارة الإسلامية في تعريب غير العرب ودمجهم ثقافيًا. ويتناول البازعي أثر العولمة و"سيولة الحداثة"، مستعرضًا كيف تقاوم المجتمعات الذوبان الثقافي من خلال اللغة والسياسات الثقافية، وينبّه إلى خطورة التراجع الأكاديمي لأقسام اللغة العربية في الجامعات، والتوسع في التدريس بالإنجليزية، وهو ما يراه انقطاعًا خطيرًا عن الموروث الثقافي. ويختم برؤية متزنة حول الحداثة، معتبرًا أنها ضرورية، لكن بشرط ألّا تُشوّه الهوية أو تقطع الصلة بالتراث، فالتحديث الحقيقي، في رأيه، هو ذاك الذي يُبقي اللغة حيّة ومتطورة، دون أن يُفقدها جذورها.
ثم يوسّع هذا الطرح في "الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف" (٢٠٠٨)، حيث يتعمق في مشكلة الترجمة، وهجرة المفاهيم، وتمثيلات الآخر، كاشفًا عن المأزق البنيوي الذي يجعل المثقف العربي أقرب إلى "الشارح" منه إلى المنتج. يناقش إشكالية استيراد النظريات النقدية دون مراعاة لشروطها الثقافية، ويضرب أمثلة على تعثّر "النقد المترجم" في الوصول إلى العمق بسبب غياب السياق الأصلي للنصوص.
لا تُقاس حيوية الثقافة عند الدكتور سعد البازعي بما تُنتجه فقط، بل بما تكشفه من توتراتها الداخلية، من اختناقاتها، ومن قدرتها على مساءلة نفسها. في محاضرته "التأزم الحضاري: نحو علم الأزمة"، التي ألقاها في المنتدى الثقافي الجزائري، ينقل البازعي الحديث عن الثقافة من فضاء الإنجاز إلى فضاء الوعي، ويعيد تعريف "الأزمة" بوصفها لحظة ثقافية بامتياز، لا مجرد عرضٍ طارئ في جسد المجتمع. يذهب البازعي إلى أن الأزمات، كما عرفتها الحضارات المتعاقبة، ليست محض إخفاقات أو انتكاسات، بل لحظات تعرية، يُجبر فيها الفكر على إعادة النظر في مسلّماته. ومن هنا، يقترح تأسيس مبحث جديد يسميه "علم الأزمة"، مستندًا إلى أعمال إدغار موران، زيجمونت باومان، هوسرل، شپنغلر، بول فاليري، وعبدالوهاب المسيري. وهو مبحث لا يقتصر على إدارة الأزمات، كما هو شائع في الخطاب السياسي أو الأمني، بل يُعنى بتفكيك المفهوم ذاته، وبناء معرفة نظرية حول ماهية التأزم، كيف يحدث؟ وما الذي يكشفه عن الإنسان والثقافة؟ إن الأزمة عند البازعي ليست فقط لحظة غموض، بل لحظة إمكان. فهي لا تعني دائمًا الكارثة، بل قد تكون - كما في الفهم اليوناني القديم - لحظة تشخيص، لحظة تقاطع بين الاحتمالات، لحظة انفتاح. ومن هنا تصبح "الأزمة" في ذاتها ظاهرة ثقافية تستحق الدراسة، لا بوصفها مشكلة تبحث عن حل، بل كمجال لإنتاج معرفة، وتفكير جديد. هذا التصور يجد صداه في مقولة موران الشهيرة التي استشهد بها البازعي: "ينبغي مواصلة عملية التأزيم ووضع مفهوم الأزمة نفسه في أزمة." وهو قول يلخص كيف أن الفكر حين يواجه أزمته، لا ينهار، بل يتجدد. في رؤيته هذه، لا يفصل البازعي بين تأزم الحضارة الغربية وتأزمنا نحن، بل يرى في كثير من أزماتنا انعكاسًا لأزماتها، بحكم التأثر العميق والمتبادل بين الثقافات. فالثقافة ليست جزيرة معزولة، بل هي في صميمها شبكة تفاعلات تتقاطع فيها التجربة المحلية مع الكونية، ويظهر فيها التأزم كعرض إنساني مشترك، لا كعارض محلي طارئ. بهذا الطرح، ينقل البازعي النقاش حول الثقافة من مستوى التوصيف إلى مستوى التحليل المفهومي، مؤسسًا لفهم أكثر عمقًا لعلاقتنا بما نمر به، وما نعيشه من تحولات. فالثقافة، حين تكون صادقة، لا تهرب من أزماتها، بل تسميها، وتضعها موضع التفكير.



اللغة والهوية الثقافية: بين الذاكرة والتحدي
التأزم بوصفه لحظة ثقافية
مشروع البازعي الثقافي
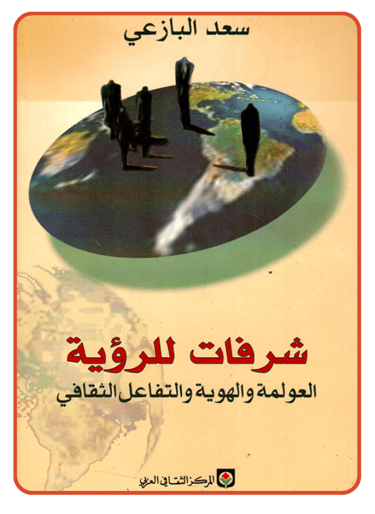
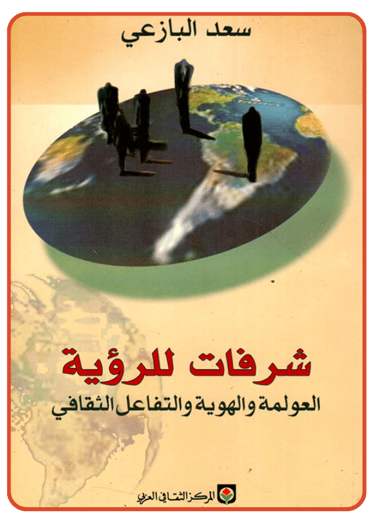
في رؤيته للعلاقة بين المثقف والسلطة، لا يذهب الدكتور سعد البازعي إلى التقسيم التقليدي الذي يحصر المثقف بين خانتين: مع السلطة أو ضدها. بل يفتح المجال لتصوّر ثالث أكثر تعقيدًا، هو "منطقة المابين" التي يرى أنها المساحة الحقيقية التي يتحرك فيها أغلب المثقفين، حيث تتقاطع الاستقلالية الفكرية مع ضغوط الانتماء للمؤسسة الأكاديمية أو الاجتماعية أو السياسية. في محاضراته تطرق كثيراً لمفهوم "المفكر والرقيب، المثقف والرقيب" سواء في المتلقى الثقافي أو منتدى الثلاثاء في القطيف أو حتى في مقابلاته التلفزيونية. يوضح البازعي أن المثقف ليس كائنًا حرًا طليقًا بالكامل، فحتى أكثر المفكرين "المتمردين" محكومون بمنظومات معرفية، وبشروط الاعتراف الاجتماعي، وبسياقات مؤسساتية تموّل وجودهم أو تحاصرهم. الرقابة ليست فقط قرارًا فوقيًا، بل سلطة متجذّرة في أعماق الثقافة ذاتها. ومن خلال استدعاء أمثلة من ابن المقفع إلى ابن رشد، ومن الفارابي إلى فرح أنطون، يبيّن البازعي كيف مارس المثقف لعبة مراوغة مع السلطة، قائلًا ما لا يمكن قوله من خلال الأقنعة: الحيوان، المجنون، الفيلسوف الإغريقي، أو المفردة الرمزية. وفي زمن الرقابة الرقمية، لم تنتهِ تلك المواربات، بل تحوّلت إلى "رقابة الجماهير" و"أرشفة التغريدات" و"النبذ الاجتماعي"، مما يجعل المثقف أكثر حاجةً اليوم إلى وعي مضاعف، لا بالسلطة السياسية وحدها، بل بالسلطات الثقافية التي تسكن داخل النصوص وخارجها. المثقف إذًا، عند البازعي، ليس حاملًا للحقيقة المجردة، بل فاعل ضمن شبكة علاقات وشروط وتوترات، يحاول عبرها قول "بعض" الحقيقة، لا كلها، وبالطريقة التي تسمح له بالبقاء حيًا، ومؤثرًا. هذه المراوغة ليست جبنًا، بل ضرورة معرفية وأخلاقية للبقاء والتأثير. فالمثقف الحقيقي لا يصرخ دائمًا، بل أحيانًا يهمس، أو يلتف، أو يوهم، لكنه لا يتوقف عن المحاولة.
تكوين المثقف الخليجي: من خالد الفرج إلى المثقف المعاصر
في محاضرته بعنوان "تكوين المثقف الخليجي"، التي ألقاها بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٣ في وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية بالمركز العربي للبحوث ودراسة السياسات، تناول الدكتور سعد البازعي سيرة الشاعر والمثقف الخليجي الراحل خالد الفرج كنموذج للمثقف الخليجي. لقد عكس الفرج في مسيرته الثقافية والإبداعية التزامًا وطنيًا وقوميًا، حيث تنقل بين مختلف دول الخليج، وأدى دورًا محوريًا في نشر الثقافة والوعي الاجتماعي والسياسي في المنطقة. فُتحت أمامه مجالات متعددة للتأثير، بدءًا من تأسيسه للمطبعة العربية في مومباي، وصولًا إلى حمل هموم المنطقة ضد الاستعمار البريطاني، ودفاعه عن قضايا الأمة العربية، مثل فلسطين. كما كان الفرج رائدًا في الأدب الخليجي، محاولًا كتابة القصص القصيرة، ودمج الشعر والنثر في أعماله الأدبية. وقد جسد الفرج في شخصيته المثقف الخليجي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، معبرًا عن الوحدة الثقافية والاجتماعية والسياسية للمنطقة الخليجية. في المقابل، قدم الدكتور البازعي مقارنة بين المثقف الخليجي في فترة الفرج والمثقف الخليجي في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن اليوم، ومع وجود دول ذات سيادة ومؤسسات ثقافية راسخة، أصبحت الهويات الوطنية والإقليمية الخليجية أكثر تشابكًا، مما يخلق تحديات جديدة للمثقف الخليجي المعاصر.
المثقف والرقيب
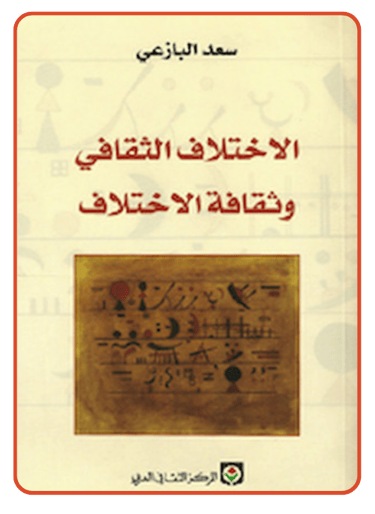
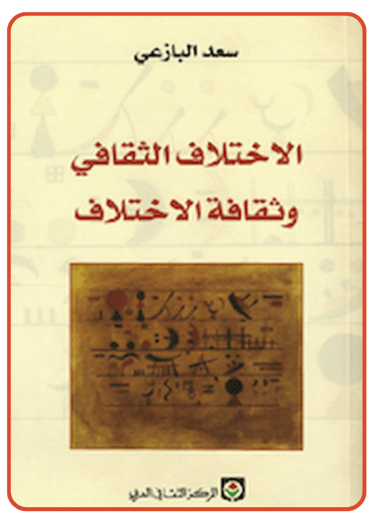
في "مواجهات ثقافية: مقالات في الثقافة والأدب" (٢٠١٤)، يبتعد البازعي عن الأسلوب التنظيري ليدخل عبر مقالاته إلى حالات واقعية من التفاعل الثقافي. يختار عن عمد مفردة "المواجهات" لا "المقارنات"، مشددًا على أن التلاقح الثقافي لا يخلو من توترات وصدامات. يناقش من خلال المقالات قضايا مثل صورة الشرق في الأدب الغربي، وقلق الهوية، وهموم الترجمة، وتقاطعات التنوير العربي مع التجربة اليهودية.
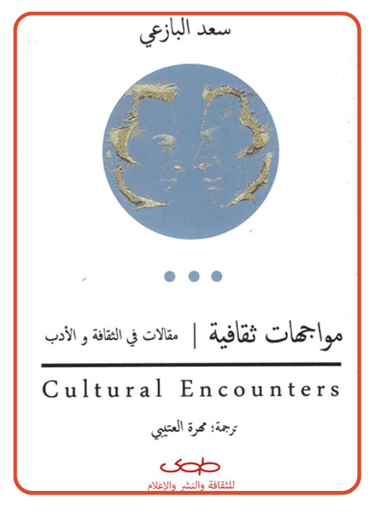
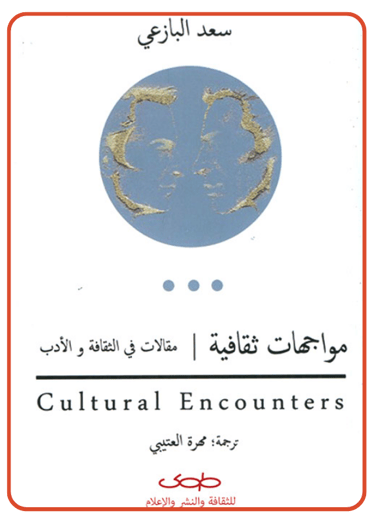
أما في "مواجهات السلطة: قلق الهيمنة عبر الثقافات" (٢٠١٨ - ٢٠٢٣)، فيعيد قراءة العلاقة بين النص والسلطة في ضوء تجارب متعددة من الشرق والغرب، متتبعًا استراتيجيات الكتّاب في مقاومة الهيمنة، عبر المواربة، والمجاز، والتورية. يرى أن الثقافة ليست معزولة عن السلطة، بل إنها غالبًا ما تُنتج في ظلها، وأن فهم المثقف يبدأ من تحليل هذا التوتر الخفي بين الرغبة في الحرية والخوف من الردع.
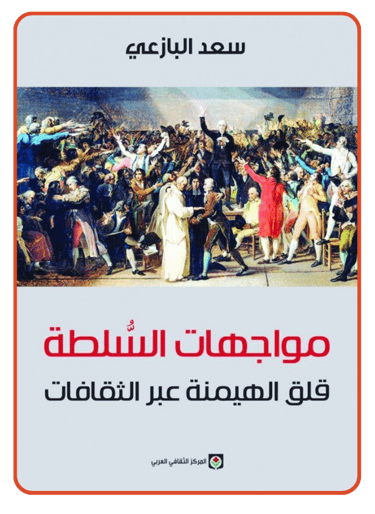
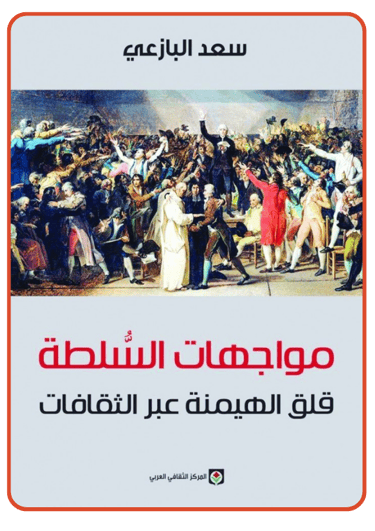
ينتقل البازعي بعد ذلك إلى فضاء أكثر تأملًا في "سؤال المعنى في الأماكن والفنون" (٢٠٢١)، حيث تتداخل اليوميات الجمالية مع النظرة الفلسفية إلى الفن والسفر. يكتب عن المدن بوصفها نصوصًا، وعن الموسيقى والفنون التشكيلية والسينما كمفاتيح لفهم الذات والعالم. هذا الكتاب أقرب إلى "تجربة قارئ رحّالة" منه إلى التنظير، لكنه لا يخلو من بصماته النقدية المتأنية.
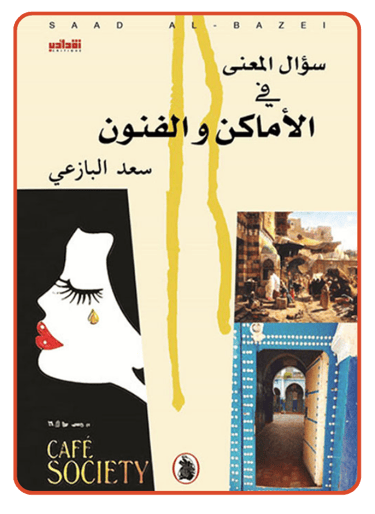
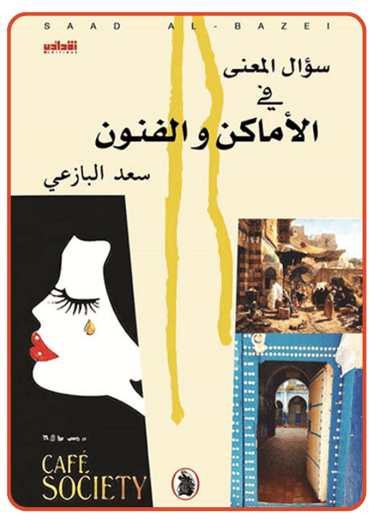
في خضم الجائحة العالمية، أصدر "الثقافة في زمن الجائحة" (٢٠٢٢)، وهو كتاب يترجم فيه مجموعة من المقالات العالمية التي تناولت تأثير الجائحة على الثقافة والفنون. يتيح هذا الكتاب للقارئ العربي نافذة نادرة على مشهد عالمي حيّ من التفكير، بعيدًا عن التنميط الأكاديمي، موثقًا كيف قاومت الثقافة العزلة، وكيف أعادت الجائحة ترتيب أولويات الإنسان المعاصر.
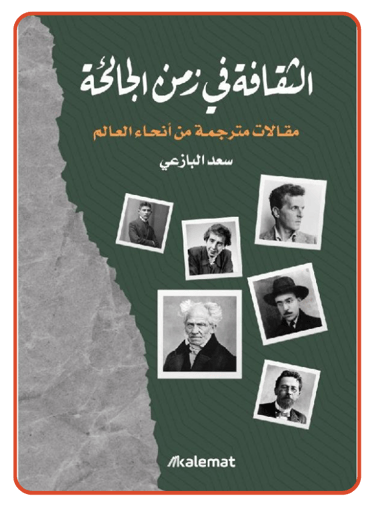
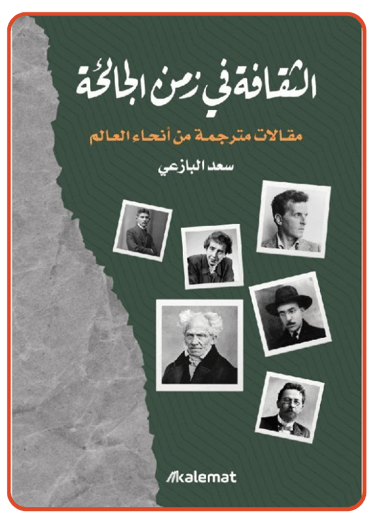
وأخيرًا، في "أزمات الثقافة" (٢٠٢٤)، يواصل البازعي تقليب الأسئلة الجوهرية التي لطالما شغلته: من نحن؟ وما حدود ثقافتنا؟ وما جدوى المثقف في عصر التشتت الرقمي؟ يناقش تحولات المثقف العربي، إشكالات التعليم، علاقة الفكر بالسلطة، وسؤال القارئ الغائب. في هذا الكتاب، تتكثف خلاصات مشروعه الثقافي بأسره، كأنما هو إعادة تأمل لما سبق، ولكن من شرفة أكثر اتساعًا وتأملًا.


الثقافة بين الفرد والمؤسسة
طرح الدكتور سعد البازعي في لقاءات مختلفة سواء في برنامج روافد أو سؤال مباشر رؤية متوازنة لدور الفرد والمؤسسة في الحياة الثقافية، فيؤكد أن الفعل الثقافي لا يُختزل في اجتهادات الأفراد ولا في سياسات المؤسسات وحدها، بل في التفاعل الحيوي بينهما. فالفرد ـ بمبادرته ووعيه ـ هو الشرارة التي تحرّك المياه الراكدة، لكنه لا يستطيع وحده أن يؤسس لحراك مستدام دون احتضان مؤسساتي. في المقابل، لا يمكن للمؤسسة أن تنجح إن اعتمدت على الآليات فقط وأغفلت الدور الخلّاق للمثقفين. ويرى البازعي أن أحد أسباب تعثّر العمل الثقافي في مراحل سابقة يعود إلى هذه الثنائية المختلّة؛ حين كانت المؤسسات تعتمد كليًا على كفاءة فرد أو اثنين، فتنشط حين يزدهرون، وتخبو حين يغيبون. أما اليوم، فالمطلوب هو بنية تحتية تستوعب الطاقات الفردية، وتعيد توجيهها ضمن برامج واضحة ورؤى ممتدة. هكذا يتحول الإبداع من مبادرة معزولة إلى مشروع يتكامل فيه الجهد الشخصي مع التوجه المؤسسي، ويتحوّل المثقف من "صوت حر" فقط إلى "فاعل مؤثر" داخل منظومة أوسع.
خاتمة: الثقافة كأفق مفتوح للتفكير
في ختام هذا الفصل، يتجلّى أمامنا مشروع ثقافي بالغ التركيب، يقوده الدكتور سعد البازعي برؤية عقلانية عميقة، ترفض التصنيفات القاطعة والشعارات الجاهزة، وتعمل على تفكيك العلاقات المتشابكة بين الثقافة والهوية، بين الفرد والمؤسسة، وبين المثقف والسلطة. لا يطرح البازعي الثقافة بوصفها إنتاجًا معرفيًا فقط، بل بوصفها ممارسة أخلاقية ووعيًا نقديًا واشتباكًا دائمًا مع الأسئلة الكبرى: من نحن؟ كيف نكون؟ وبأي لغة نتحدث عن أنفسنا؟ تتسع الثقافة في خطاب البازعي لتشمل اللغة، والسياسة، والهوية، والمكان، والآخر، والتاريخ، دون أن تذوب في أيٍ منها. فهي فعل توازن دائم، يقاوم الاستلاب دون أن ينغلق، ويسعى للفهم دون أن يُفقد الذات حضورها. وهو ما يظهر جليًا في تأملاته حول الترجمة والمثاقفة، وفي تحليلاته العميقة لمسألة التأزم الحضاري، إذ لا يرضى بالبقاء في حدود التوصيف، بل يطمح لتأسيس "علم الأزمة" بوصفه مجالًا ثقافيًا جديدًا يعيد التفكير في منابت التحول، لا في أعراضه فقط. وفي كتاباته المتنوعة من شرفات للرؤية إلى أزمات الثقافة، نقرأ تطور هذه الرؤية المتأنية، التي تتخذ من "الاختلاف" لا "التماثل" نقطة انطلاق، ومن التفاعل لا الاستقطاب طريقًا للفهم. في كل مرحلة، يعود البازعي إلى أسئلة الثقافة من زاوية جديدة، مرة عبر اللغة، ومرة عبر المكان، ومرة عبر أزمة المثقف، لكنه لا يفقد البوصلة أبدًا: الثقافة يجب أن تُفكّر بنفسها، وأن تُعرّف نفسها، لا بما يقوله الآخرون، بل بما تكشفه من إمكانات، وتتحمّله من أعباء. وفي النهاية، فإن مشروع سعد البازعي الثقافي لا يمكن اختزاله في مقالات أو كتب أو محاضرات، لأنه مشروع مفتوح، متحوّل، يتجدّد مع كل أزمة، ويعيد طرح الأسئلة بدل أن يكتفي بالأجوبة. مشروع يرى في الثقافة أداة للتحرر، لا للزينة، وساحة للنقد، لا للمباهاة. مشروع يطلب من القارئ أن يكون شريكًا في التفكير، لا مستهلكًا للمعرفة. ولهذا، تظل الثقافة ـ عند البازعي ـ شرفًا للرؤية، لا جدارًا للهوية.
تحتل الفلسفة موقعًا مركزيًا في خطاب الدكتور سعد البازعي، لا باعتبارها تخصصًا أكاديميًا مجردًا، بل بوصفها ممارسة عقلية مستمرة لفهم الذات والعالم، وتفكيك المسلّمات، وتوسيع أفق التفكير. الفلسفة عند البازعي ليست ترفًا ذهنيًا بل شرطًا حضاريًا، إنها الأداة التي يتوسل بها الإنسان للقبض على المعنى وسط ضجيج العالم، ومقاومة الانغلاق والدوغمائية. من هنا، فإن اهتمامه بالفلسفة ليس طارئًا أو ثانويًا، بل متجذر في مشروعه الفكري والنقدي، كما يظهر في مؤلفاته، ومحاضراته، ولقاءاته، وتفاعلاته التعليمية.
الفلسفة
يُعد كتاب قلق المعرفة (2010) للدكتور سعد البازعي رحلة تأملية عميقة في جدلية القلق والإبداع، حيث ينطلق المؤلف من القلق بوصفه قوة دافعة لاختبار المعرفة، لا باعتباره اضطرابًا نفسيًا، بل محركًا وجوديًا للتفكير الحر والانفتاح الثقافي. يجمع الكتاب بين دراسات ومقالات كتبها البازعي في فترات متفرقة، ثم أعاد تأملها وتوليفها ضمن رؤية واحدة تنسج بينها خيطًا ناظمًا هو "القلق" بمعناه المعرفي والثقافي.
يرى البازعي أن المعرفة الحقيقية لا تولد من الاطمئنان، بل من التوتر مع الموروث، ومن التفاعل النقدي مع الأسئلة الكبرى في الهوية، والدين، والأدب، والفن، والانتماء، والتاريخ، والمثاقفة. ولهذا يقدّم القلق بوصفه شرطًا معرفيًا لا يمكن تجاوزه، ويستعرض تمثلاته عبر قراءات لمفكرين مثل عبدالوهاب المسيري، محمد عابد الجابري، إدوارد سعيد، إضافة إلى مفاهيم مثل قلق التنوير، وقلق الغياب، والقلق اليهودي.
الكتاب لا يطمح إلى تقديم إجابات، بل إلى إثارة الأسئلة، وهو بذلك يتناغم مع طبيعته المفتوحة ككتاب يتجاوز التصنيف بين النقد والفكر، بين المقالة والدراسة، ليكون في نهاية المطاف نصًا تأمليًا عالي الحساسية تجاه معضلات الثقافة المعاصرة.
في حواره مع شايع الوقيان في برنامج "الفيلسوف" (21 نوفمبر 2024)، قدّم الدكتور سعد البازعي رؤية متماسكة حول سؤال الفلسفة في السياق العربي، مستهلًا الحوار بتفنيد المزاعم الاستشراقية التي ادعت غياب العقل الفلسفي العربي، مستشهدًا بأقوال أرنست رينان التي رأى فيها تجنّيًا أيديولوجيًا سقط علميًا وأخلاقيًا. أكد البازعي أن العرب، قديمًا وحديثًا، أنجزوا أعمالًا فلسفية لا تقل عمقًا عن مثيلاتها الغربية، ضاربًا أمثلة بعبد الرحمن بدوي، وزكي نجيب محمود، وطه عبد الرحمن.
لكن الأهم من ذلك، هو ربط البازعي بين الفلسفة وسؤال الهوية، حيث استعاد لحظة دخوله قسم اللغة الإنجليزية، وتساؤله: لماذا أدرس أدبًا أجنبيًا؟ ومن أنا إزاءه؟ هذا السؤال، كما أوضح، تطور لاحقًا في دراسته للدكتوراه حول "تصورات الغرب للعرب والمسلمين"، ثم نضج تحت تأثير كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد، الذي منحه الإطار المفاهيمي للتفكير بهذه الإشكالية. ينتقل الحوار ليبيّن أن البازعي يرى في قلق الهوية محفّزًا على التفلسف، لا عائقًا له، معتبرًا أن الفلسفة لا تنبت إلا في التوتر بين الأنا والآخر، بين الموروث والتجديد. كما ناقش العلاقة بين الأدب والفلسفة، مؤكدًا على أن تطور العلوم الإنسانية أزال الحدود التقليدية، وأن الناقد لا يمكنه أن يمارس النقد دون أدوات فلسفية.
وتجلّت رؤية البازعي الفلسفية أيضًا في قراءته لكتاب "الجبر الذاتي" لزكي نجيب محمود، والذي رأى فيه دفاعًا أنيقًا عن حرية الإرادة، من خلال مفهوم "الانتباه القصدي"، وهو مفهوم يقطع علاقة الحتمية بين الدوافع والسلوك، ويجعل من الإنسان فاعلًا حرًّا لا آلة بيولوجية. وفي حديثه عن كتابه "قلق المعرفة"، أقرّ البازعي بتماهيه مع القلق كحالة وجودية، موضحًا أن هذا القلق ليس مرضًا، بل حافزًا على الفهم والبحث والتجديد، ووسيلة لمقاومة الاستقرار الزائف. واختتم اللقاء بتأكيده على أن تعدد المناهج والاتجاهات في قراءته النقدية هو نتاج لهذا القلق البنّاء، لا تذبذب أو انتقائية.
يُعد كتاب هموم العقل (2016) خلاصة فكرية تأملية للدكتور سعد البازعي، يجمع فيه مجموعة من مقالاته ومحاضراته التي تتقاطع حول أسئلة العقل النقدي والهموم الفكرية المعاصرة، في بوتقة واحدة متجانسة. يتوزع الكتاب على ثمانية محاور، تتناول قضايا متعددة مثل تراجع الإنسانيات في الجامعات، تحديات الدراسات البينية، نقد الحضارة الغربية من خلال فكر إدغار موران، تحديد من يستحق صفة "المفكر"، وتحليل حوارات فلسفية بين أسماء كبرى كجيجيك وباديو.
كما يتطرق البازعي إلى قضايا إثنية وثقافية شائكة، مثل اختراع العدو، والعدالة في الديمقراطية، والعنصرية، ماركس واليهود، ويختم بقسمين حول الترجمة والحرية في الأدب ما بعد الكولونيالي. يكشف الكتاب عن عقل ناقد يرفض التسليم بالجاهز، ويدعو باستمرار إلى مساءلة المفاهيم، وفهم الغرب من الداخل لا من سطح الصور النمطية.
في محاضرة ألقاها عام 2021 ضمن سلسلة ثقافية، طرح الدكتور سعد البازعي سؤالًا مركزيًا: "هل يمكن تعليم الفلسفة؟"، وهو سؤال يستبطن توترًا قديمًا بين الفلسفة كتجربة ذاتية والتفلسف كمهارة قابلة للتدريس. أجاب البازعي بأن تعليم الفلسفة ممكن إذا ما فهمنا الفلسفة لا كخزانة مفاهيم بل كطريقة في التفكير، وأن الهدف ليس إنتاج فلاسفة، بل مواطنين قادرين على النقد، والتفكير الحر، واستيعاب الاختلاف. استعرض البازعي المجالات الأساسية للفلسفة (الأنطولوجيا، الإبستمولوجيا، الأخلاق)، وركّز على أن تدريس الفلسفة لا يجب أن يكون تقليديًا أو تجريديًا، بل تفاعليًا وسياقيًا. وأشاد بمبادرة وزارة التعليم السعودية لإدخال "التفكير الناقد" في المناهج، معتبرًا إياها خطوة أولى نحو تعليم الفلسفة بشكل عملي، لكنها ما زالت في طورها التجريبي.
كما تطرق إلى إشكاليات المجتمع العربي مع الفلسفة، مشيرًا إلى الخلط الشائع بين الفلسفة والإلحاد، واعتبر أن مقاومة الفلسفة في العالم العربي ليست دينية بقدر ما هي ثقافية وناتجة عن هيمنة الرؤية الأداتية للتعليم. وقدم مقترحات لمحتويات يمكن تدريسها في مادة الفلسفة تتدرج من الحكايات والأسئلة في المراحل المبكرة إلى المفاهيم والنصوص في المرحلة الجامعية. واختتم محاضرته بجملة مكثفة: "تعليم الفلسفة ليس ترفًا، بل ضرورة حضارية"، مؤكدًا أن المجتمعات التي تريد أن تربي إنسانًا حرًّا ومسؤولًا لا يمكن أن تغفل عن الفلسفة.
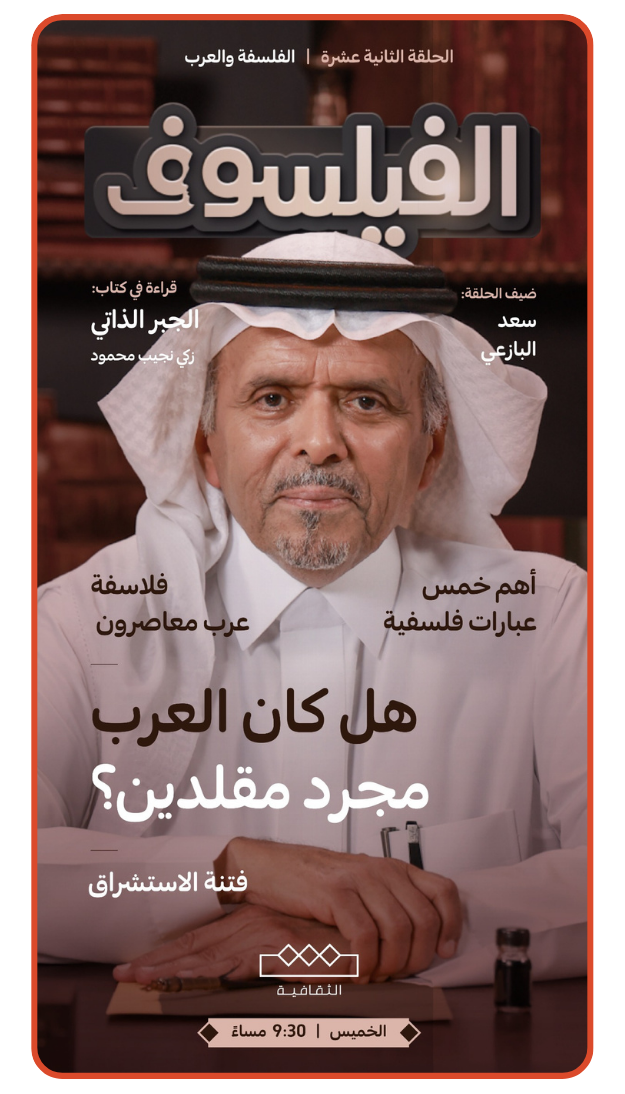
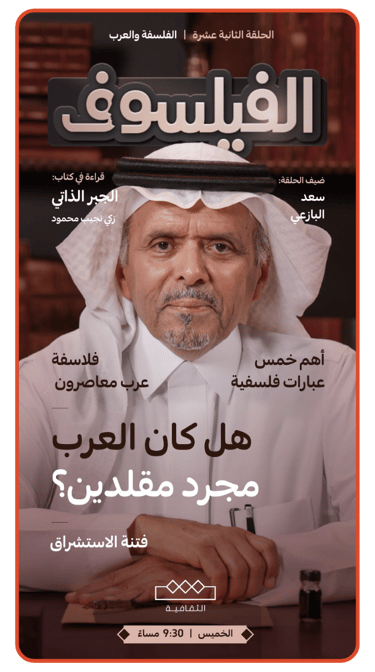



هل العرب قادرين على التفلسف؟
هل يمكن تعليم الفلسفة؟
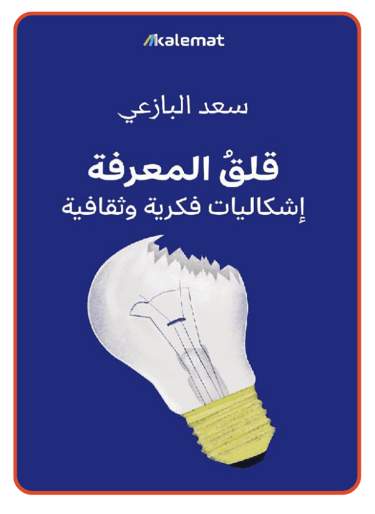
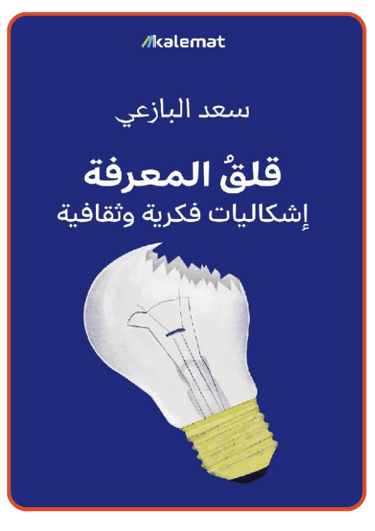
في محاضرته التي ألقاها بتاريخ 24 سبتمبر 2019 بعنوان "الرواية والفلسفة"، قدّم الدكتور البازعي قراءة معمقة للتداخل بين الرواية بوصفها سردًا فنيًا، والفلسفة بوصفها تأملًا نقديًا. بدأ من تأكيد أن العلاقة بينهما قديمة، تعود إلى محاورات أفلاطون، وحكايات نيتشه، وتأملات كيركجارد. فالفلسفة لم تكن يومًا حكرًا على الجملة المجردة، بل استخدمت الحكاية للتعبير عن أفكارها، والعكس صحيح.
عرض البازعي نماذج من الرواية العالمية والعربية التي تتجلى فيها الفلسفة، محذرًا من أن حضور الفكر في الرواية يجب ألا يتحول إلى وعظ خطابي. وميّز بين الحضور المباشر للفلسفة عبر الشخصيات، والحضور الضمني المتجسد في البنية والرمز.
سلط الضوء على أعمال مثل "موت صغير" لمحمد حسن علوان، التي يرى فيها صدامًا بين العقل الصارم لابن رشد والكشف الصوفي لابن عربي، و"مسرى الغرانيق" لأميمة الخميس، حيث تمثّل شخصية مزيد الحنفي المفكر المضطهد. كما استعرض تجربة محمد الأشعري، وانتقد ميلان كونديرا للفلسفة كخطاب، مفضلًا الرواية بوصفها تجربة للأسئلة.
يختتم البازعي المحاضرة بجملة استعاريّة مأخوذة من إحدى الروايات: "الفلسفة طائر خجول..."، ليؤكد أن السرد يمنح الفكر أجنحة للتعبير دون أن يقيده.
المنهج والنظرية: جدل المفاهيم وتاريخ العقل
في محاضرة موسعة بعنوان "المنهج والنظرية بين الفلسفة والنقد" (يونيو 2024)، تناول الدكتور البازعي العلاقة المعقدة بين مفهومي "النظرية" و"المنهج"، معتبرًا أن الخلط بينهما من أبرز إشكالات البحث في العلوم الإنسانية. بدأ المحاضرة بتأكيد أن المصطلحات ليست محايدة، وأن فهمنا لها متحيز ثقافيًا وتاريخيًا.
استعرض البازعي الجذور الفلسفية لفكرة المنهج، بدءًا من أرسطو ومرورًا بابن سينا، الذي اقترح لاحقًا في "منطق المشرقيين" تصورًا مختلفًا عن المنطق الأرسطي. كما توقف عند ديكارت، مؤسس المنهج الحديث، الذي سعى إلى تأسيس المعرفة على الشك والوضوح والصرامة، لكنه تجاهل – كما يرى البازعي – تعقيد الظواهر الإنسانية.
ثم انتقل إلى الطفرات المعرفية الكبرى مع توماس كون وميشيل فوكو، اللذين بيّنا أن المعرفة ليست كونية أو حيادية، بل بنت سياقاتها الثقافية والتاريخية. وتحت هذا الضوء، رأى البازعي أن المنهج ليس أداة صماء بل رؤية للعالم، وأن النظرية ليست بناء مغلقًا بل أفق مفتوح.
ووجّه في ختام المحاضرة نقدًا لما أسماه بـ"الهوس المنهجي"، مؤكدًا أن استخدام المناهج المتضادة دون وعي يجعل الدراسة بلا ملامح، داعيًا إلى وعي نقدي بالتوجهات الفكرية والمنهجية.
الرواية والفلسفة: سرد يتفلسف وفلسفة تسرد
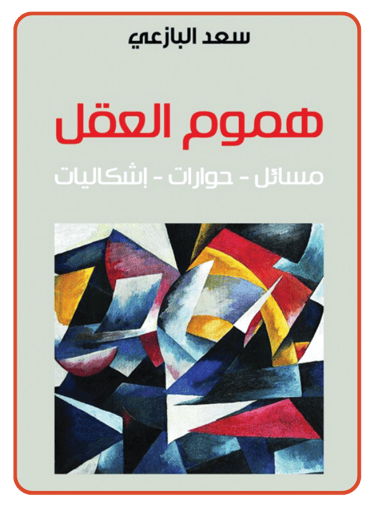
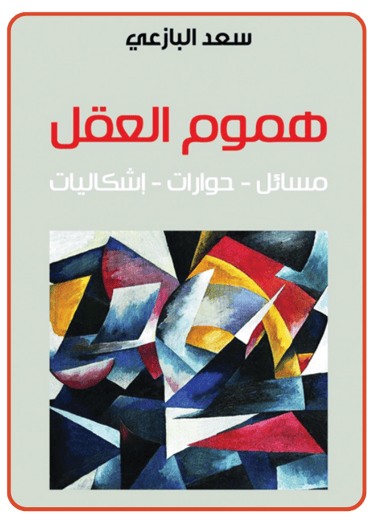
ديكارت والحداثة: الشك بوصفه ولادة جديدة للعقل
في محاضرة في مقهى نادي الكتاب بتاريخ ٠٨ مايو ٢٠٢٣، التي خُصصت لقراءة كتاب "مقالة في المنهج" لرينيه ديكارت، قدّم الدكتور سعد البازعي تحليلًا متعمقًا لموقع ديكارت في تاريخ الفلسفة، مبرزًا كيف مثّل مشروعه نقطة تحول أساسية في انبثاق الحداثة الأوروبية. يعرّف البازعي الحداثة بوصفها تحولًا جذريًا في بنية التفكير الغربي، يقوم على مركزية العقل بحيث يصبح الإنسان العاقل هو مصدر المعرفة والسلطة بدلًا من التقاليد أو الدين أو الوحي. كذلك على الشك المنهجي كوسيلة لتقويض المعارف القديمة وإعادة بناء المعرفة من أساس يقيني لا يُشك فيه. أيضاً النزعة الذاتية حيث يصبح الفرد معيار الحقيقة، وتتأسس المعرفة من منظور "الأنا" المفكرة.وأخيراً فصل المعرفة عن الإيمان: وتطوير منهج تجريبي – رياضي يُطبّق على كل ما هو قابل للقياس.
في هذا السياق، يرى البازعي أن ديكارت لم يكن مجرد فيلسوف عقلاني، بل مهندس التأسيس المعرفي للحداثة. لقد دشّن حقبة جديدة ينظر فيها الإنسان إلى العالم كآلة يمكن فهمها بالعقل والتجريب، لا كغيب يُفسَّر بالإيمان. يناقش البازعي عبارة ديكارت الشهيرة "أنا أفكر إذن أنا موجود" بوصفها اللبنة الأولى في بناء الذات الحداثية. هذه الذات المفكرة، المفصولة عن الجماعة والدين والماضي، أصبحت مرجعية مستقلة تُعيد تشكيل العالم من حولها. ومن هنا، فإن الحداثة التي أسسها ديكارت – بحسب قراءة البازعي – ليست فقط تغييرًا في أدوات المعرفة، بل تحولًا في تصور الإنسان عن نفسه وموقعه في الكون. لم يعد الإنسان مخلوقًا تابعًا، بل أصبح صانعًا للمعنى، وسيدًا على الطبيعة، وعقلًا مركزيًا يُنظّم الوجود.
وقد ربط البازعي بين هذا التحول وبين مشروع طه حسين في "في الشعر الجاهلي"، حيث استخدم طه الشك الديكارتي ليعيد قراءة التراث العربي، متحدّيًا الروايات السائدة انطلاقًا من معيار العقل. واعتبر البازعي أن هذا التأثر يبيّن كيف أن الفلسفة الحديثة وجدت طريقها إلى العرب، لكنها غالبًا ما قوبلت بممانعة تقليدية. ينتقد البازعي أيضًا بعض مآزق الحداثة، مثل المركزية العقلية التي تجاهلت الحدس والخيال، والرؤية الآلية للكون التي أفرغت الطبيعة من روحها، والازدواج الديكارتي بين الجسد والروح، الذي كرّس قطيعة لا تزال تُناقش حتى اليوم.
ويختتم البازعي المحاضرة بسؤال تأملي: هل انتهت الحداثة؟ ويجيب بأنه "إذا كانت قد انتهت فلسفيًا في الغرب، فإنها لم تبدأ بعد بشكل حقيقي في العالم العربي"، في إشارة إلى أن التحولات الحداثية لم تُستوعب بعد ثقافيًا ومؤسساتيًا في مجتمعاتنا، مما يستدعي قراءة نقدية جديدة لهذا الإرث.
خاتمة الفصل: بين القلق والسؤال
من خلال محاضراته ولقاءاته ومؤلفاته ودوره الدائم في حلقة الرياض الفلسفية التي أسهم في تأسيسها، تتجلّى الفلسفة عند الدكتور سعد البازعي لا كحقل معرفي معزول، بل كمنهج حياة، وكموقف نقدي متصل بجوهر الإنسان الحديث. إنها الحافز الذي يدفعه نحو التساؤل، والقلق، والبحث المستمر عن المعنى في عالم يزداد تعقيدًا وتشظيًا. في رؤيته، لا يُختزل الفيلسوف في الأكاديمي أو المتخصص، بل في كل من يملك الجرأة على إعادة النظر في المسلّمات، والسير في دروب الشك المثمر، والتفكير في ما وراء الظواهر. لقد واجه البازعي سؤال الفلسفة في السياق العربي بوعي مزدوج: وعي المثقف العارف بتاريخ الفلسفة ومرجعياتها، ووعي الإنسان المنخرط في واقعه الثقافي المحلي. رفض المركزيات الغربية التي تنكر على العرب قدرتهم على التفلسف، وفي ذات الوقت، انتقد التوجّسات المحلية التي ترى في الفلسفة خطرًا أو ترفًا لا طائل منه. وبموقفه هذا، فتح مجالًا جديدًا للتفلسف العربي، الذي لا يبدأ من الصفر، بل من التفاعل مع التراث والمعاصرة معًا.
كما برزت فلسفة البازعي في اشتغاله على "المنهج"، لا بوصفه تقنية بحثية، بل كبنية عقلية تعكس رؤيتنا للعالم. وهنا تتلاقى الفلسفة مع النقد، حيث لا يمكن ممارسة نقد حقيقي بدون تفكير فلسفي واعٍ بمفاهيمه وحدوده وأدواته. وهذا ما انعكس أيضًا في تحليلاته للرواية والفكر الحداثي، وخصوصًا في قراءته لمشروع ديكارت، الذي اعتبره البازعي لحظة تأسيس للعقل الحديث، لكنها لحظة لا تزال غير منجزة بالكامل في السياق العربي. إن الحضور الفلسفي في مشروع سعد البازعي لا يقتصر على تنظير مفاهيمي، بل يظهر أيضًا في قدرته على إدماج الفلسفة في اليومي، في السرد، في القلق المعرفي، وفي أسئلة الهوية والانتماء. ولذلك، فإن هذا الفصل لا يُختتم بخلاصة، بل يُفتتح بأسئلته، لأن الفلسفة – كما يفهمها البازعي – لا تنتهي بإجابات نهائية، بل تبدأ حيث يعلو صوت السؤال.
لم تكن "الحداثة" في الخطاب الثقافي السعودي مسألة جمالية فنية فحسب، بل تحوّلت منذ لحظة ظهورها إلى قضية وجودية وهوياتية، انقسمت حولها المواقف، واشتعلت بسببها المعارك، وأعيد من خلالها التفكير في دور المثقف، ووظيفة النص، وحدود التراث. وفي هذا السياق المتوتر، يبرز الدكتور سعد البازعي لا كمجرد شاهد على جدل الحداثة، بل كأحد أهم مفكّريها، ممن ساهموا في رسم حدودها، وتحليل أبعادها، وتفكيك مفاهيمها، والاشتباك مع الأسئلة التي فجّرتها.
لم يكن دخوله ساحة الحداثة ناتجًا عن انتماء أيديولوجي، أو سعيًا لمجابهة التقليد، بل عن وعي معرفي يقرأ التحوّلات الثقافية بوصفها نتائج لتغيّرات اجتماعية وتاريخية عميقة. ومع عقود من الكتابة والمحاضرة والترجمة والتأمل، تشكّل في خطابه مسارٌ حداثي متعدد الطبقات، يتراوح بين التحفّظ والإقدام، بين التبني النقدي والمراجعة المستمرة.
الحداثة
أشار البازعي في لقاءه في برنامج المقابلة مع علي الظفيري في أبريل 2023 إلى أن أولى معارك الحداثة في السعودية لم تبدأ في الجامعات، بل في الصحف، تحديدًا في الملاحق الثقافية. كانت الكتابات الحداثية آنذاك تلقى رفضًا شرسًا من التيارات المحافظة، ويُتهم أصحابها بـ"التغريب"، و"طمس الهوية"، و"تفكيك القيم".
لكن ما يلفت في تحليل البازعي هو أنه لم يتبنَّ خطاب المظلومية، بل قرأ هذه المعارك بوصفها لحظة وعي جماعي. فالجدل نفسه – حتى وإن كان خصوميًا – كشف حجم الاهتمام بالتحول الثقافي، وعمّق الجدل العام حول مستقبل الكتابة والأدب والدين.
تحدّث سعد البازعي في حلقة مخيال رمضان بتاريخ 5 مارس 2025 عن علاقته بحركة الحداثة بوصفها إحدى المحطات الأساسية في تشكّله الفكري والنقدي، مؤكدًا أنه انخرط مبكرًا في هذا التيار فور عودته من البعثة إلى الولايات المتحدة عام 1983. فقد بدأ بتقديم محاضرات عن الشعر السعودي والاستشراق، وانخرط في المشهد الثقافي سريعًا، على خلاف كثير من زملائه الذين احتاجوا وقتًا أطول للتفاعل مع الساحة.
أوضح البازعي أن المشهد الأدبي في تلك المرحلة كان متمحورًا حول الشعر والقصة، بينما لم تكن الرواية قد أخذت مكانها البارز بعد. ومن هنا نشأت علاقته الوثيقة بشعراء الحداثة، مثل محمد الثبيتي، ومحمد جبر الحربي، وعبدالله الصيخان، وكتب عن تجاربهم بقدر من الحماسة النقدية، متفاعلًا مع ما تمثله من تجديد في الشكل والرؤية.
في ذروة معركة الحداثة التي شهدتها السعودية خلال الثمانينات، اختار الدكتور سعد البازعي ألا ينخرط في الصراع بوصفه أيديولوجيًا صداميًا، بل كمثقف أكاديمي يسعى لتأصيل الحداثة من الداخل. كانت مساهمته في ذلك التأسيس واضحة مبكرًا، حين أصدر كتابه المفصلي "ثقافة الصحراء"، والذي شكّل محاولة واعية لتقديم رؤية "داخلية" للحداثة، تستند إلى التراث المحلي والشفاهة الصحراوية، لا إلى المفاهيم المستوردة فقط.
كان البازعي يدرك أن أحد أكبر الاعتراضات على الحداثة يتمثّل في اتهامها بالتغريب والانفصال عن البيئة الثقافية المحلية. ولهذا سعى في ثقافة الصحراء إلى إثبات أن القصيدة الحديثة، في الخليج والسعودية تحديدًا، ليست انفصالًا عن التراث، بل امتدادًا له. لقد قرأ الشعر الحديث بوصفه وارثًا للشعر النبطي، متغذيًا على الشفاهة والأسطورة والحكاية الشعبية، ومُحاطًا بجمهور يستهلكه عبر الإلقاء أكثر من القراءة. وهكذا، لم يعد الشعر الحداثي في أطروحته "اعتداءً على الموروث"، بل مظهرًا من مظاهر تطوره الطبيعي.
إلا أن موقفه من الحداثة لم يكن انتماءً صريحًا إلى تيارها، بل عبّر عن موقع نقدي وصفه بـ"المنطقة الرمادية" أو "البينية"، حيث كان مؤيدًا للتجديد الأدبي ومعارضًا للجمود، لكنه في الوقت ذاته متحفظًا على بعض مظاهر الإفراط في الحداثة الشعرية، خاصة ما يراه من ضعف في بعض النصوص. هذا الموقف جعله عرضة لاعتراضات من داخل التيار الحداثي نفسه، حيث اعتبره بعض الشعراء – كما أشار – متساهلًا في تقديم ملاحظات قد تُستغل من قبل خصوم الحداثة، لكنه كان يرى أن مهمته النقدية تقتضي الوضوح والاتزان دون مجاملة أو تحزّب.
يرى البازعي أن الحداثة في السعودية لم تكن قطيعة مع التراث، بل امتدادًا لتحولات سابقة بدأت منذ مرحلة السياب ونازك الملائكة، وأنها لم تكن مشروعًا دخيلًا كما صوّرها بعض خصومها، بل تفاعل طبيعي مع الحراك الشعري العربي والإنساني. في الوقت ذاته، لا ينكر تأثرها بالفكر الغربي، لكنه يميز بين التقليد الأعمى والتفاعل النقدي الواعي، ويرى نفسه ضمن الاتجاه الذي يستفيد من الفكر الغربي دون أن يذوب فيه.
كما تحدّث عن اختلافه مع المفكر عبدالوهاب المسيري، الذي كان يرفض الحداثة بوصفها مشروعًا علمانيًا غربيًا، في حين أن البازعي يرى أن حداثة الأدب تختلف عن الفلسفات الحداثية الغربية، وأنه من الممكن تبني أدوات وأشكال تعبيرية جديدة دون التخلي عن الهوية أو الإرث الثقافي.
بالنسبة له، تمثل الحداثة طاقة إبداعية دفعت بالأدب العربي إلى الأمام، لكنها مثل كل تحوّل معرفي، تتضمن الغث والسمين، ولا ينبغي تبنيها على نحو أيديولوجي أو رفضها جملة واحدة. بل المطلوب هو أن تُخضع للنقد والتحليل، كما فعل في كثير من مقالاته وكتبه التي تناولت هذا الحراك بقدر من التوازن والانضباط المنهجي، متأثرًا بتكوينه الأكاديمي في حقل الأدب المقارن.
كما يرى البازعي أن الرواية مثّلت مرحلة جديدة من التعبير الحداثي في السعودية، وبخاصة في التسعينات، حين تراجع الصراع حول قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة، وبدأ الاهتمام يتجه نحو الرواية بوصفها جنسًا أدبيًا أكثر شمولًا للمجتمع وتعقيداته. الرواية، في رأيه، لا يمكن أن تُكتب ضمن شروط رقابة صارمة، لأنها "تتسع للمجتمع" وتقدّم صورًا بانورامية لعناصره. وهو يرى أن هامش الحريّة الأدبية اتّسع مع انتشار الرواية، ولكن ليس بوصفه منحة، بل نتيجة تحوّل الحداثة إلى تيار عام، واندماجها في البنية الثقافية، بحيث لم يعد أحد يحتج على قصيدة نثر أو رمز أسطوري أو بناء غير تقليدي للنص.





سعد البازعي والمنطقة البينية في خطاب الحداثة
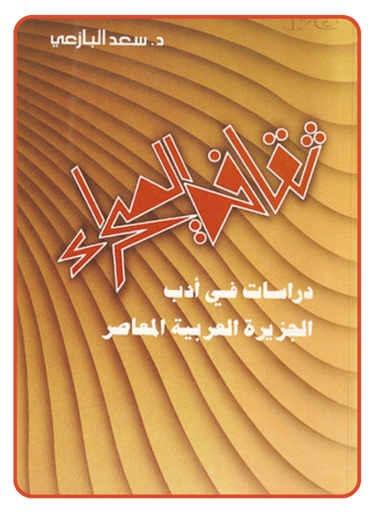
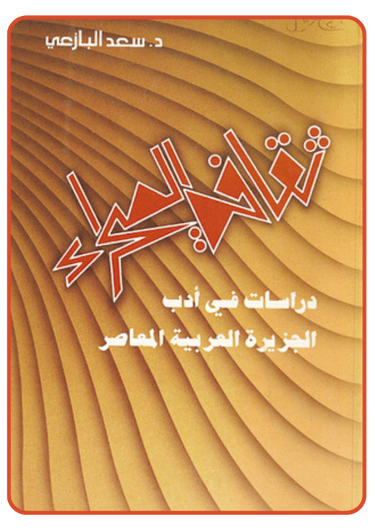
في افتتاح موسم جديد للملتقى الثقافي، وتحديداً في سبتمبر 2015، ألقى الدكتور سعد البازعي محاضرة بعنوان "الحداثة السائلة"، اختار فيها أن يكون العنوان مدخلًا لإثارة السؤال، لا تقديم الإجابة. افتتح البازعي حديثه بتأمل في مفهوم الحداثة، مؤكّدًا أنه من أكثر المصطلحات إثارة للجدل، وأن كثرة تداوله لم تسهم بالضرورة في توضيحه. وأشار إلى أن المصطلح – في شيوعه – لا يصف شيئًا محددًا، فالحداثة تعني "الجِدة"، وكل عصر يحمل شيئًا جديدًا؛ لكن الجديد وحده لا يصنع حداثة، ما لم يرتبط بتغيّر عميق في القيم والبُنى. وحين يتحوّل الجديد إلى حالة تاريخية واجتماعية، يصبح المصطلح محتاجًا لإعادة ضبط أو حتى إعادة تسمية. من هنا، انتقل البازعي إلى الحديث عن مفهوم "ما بعد الحداثة"، بوصفه أحد أكثر المفاهيم تعقيدًا في الفكر المعاصر. إلا أن هذا المصطلح، بحسب باومان، لم يعد قادرًا على الإحاطة بواقع ما بعد الحداثة، فاقترح بديلاً عنه: "الحداثة السائلة". هذا الاقتراح، كما يرى البازعي، أنقذ المصطلح من عموميته، وحرّره من التعويم المفاهيمي، إذ أضفى عليه ملمحًا توصيفيًا ماديًا "السيولة" يدل على التحول الدائم، وعدم الثبات، والانزلاق المستمر.
قدّم البازعي لمحة عن سيرة زيجمونت باومان، موضحًا أنه مفكر يهودي الأصل، وُلد في بولندا، وطُرد منها في سبعينيات القرن العشرين بتهمة "معاداة السامية"، رغم كونه يهوديًا، فانتقل إلى بريطانيا، وعمل أستاذًا في جامعة ليدز، وأصبح من أبرز منظّري علم الاجتماع المعاصر. كتب عن الحداثة، الأخلاق، العولمة، الهولوكوست، والاستهلاك، ومن أشهر كتبه: الحداثة السائلة، الحياة السائلة، الخوف السائل، والحداثة والهولوكوست. يرى باومان، بحسب شرح البازعي، أن العالم الحديث بات يعيش في حالة من "السيولة" الشاملة، تتجلى في مظاهر عدة:
- تدفق البشر: عبر موجات اللاجئين والمهاجرين بعد الحرب العالمية الثانية، أو في الهجرات المعاصرة من جنوب العالم إلى شماله.
- تدفق رؤوس الأموال: في نظام مالي عالمي لم يعد تحكمه حدود وطنية.
- تدفق المعلومات: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل العالم "قرية صغيرة"، يتأثر بعضه ببعض في التو واللحظة.
- تغير الهويات: حيث لم يعد الإنسان يحتفظ بهويته الثقافية أو الاجتماعية أو النفسية بشكل ثابت، بل يعيد تشكيل ذاته استجابة للموضة والسوق والمتغيرات اليومية.
يشير البازعي إلى أن باومان لا يكتفي بوصف الظاهرة، بل يُبدي أسفًا عميقًا على هذا التحوّل. فالحداثة السائلة، في منظور باومان، عصر استهلاك مفرط لا يتيح فرصة للتأمل أو التوقّف. حتى العلاقات الحميمية – كالحب والعائلة – أصبحت تُعبّر عنها بالسلع لا بالمشاعر. ففي مثال طريف أورده البازعي عن موظفي الشركات الذين يعملون لساعات طويلة، أشار إلى أن هؤلاء يعوّضون غيابهم بهدايا مادية لأسرهم، فيتحوّل الحب إلى سلعة، ويصبح المال لغة التعبير عن العاطفة.




أنا اختلفت حتى مع بعض الزملاء الحداثيين، واعتبر أن الاختلاف داخل التيار يمنحه مصداقية لا يضعفه
معارك الحداثة: الصحافة كساحة صراع
"ثقافة الصحراء" والدفاع من الداخل


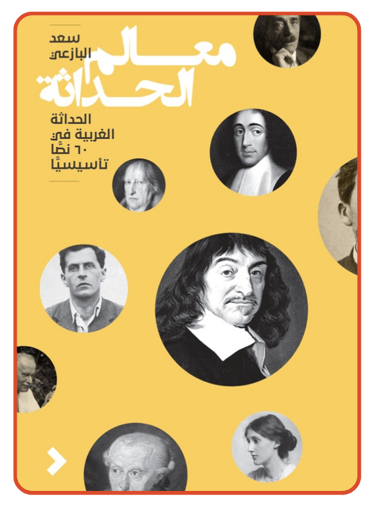
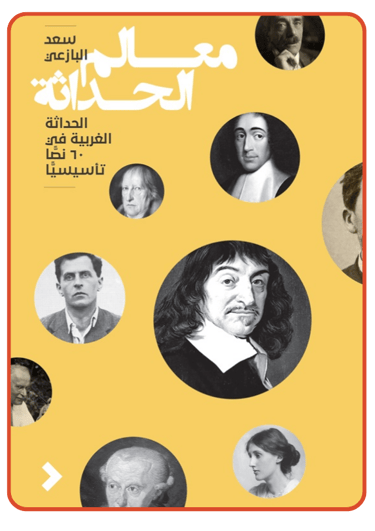
يمثّل كتاب "معالم الحداثة" أحد أبرز المشاريع الفكرية التي أنجزها الدكتور سعد البازعي، وقد جاء نتاج مسيرة طويلة من الترجمة والنقد والتأمل الفلسفي. يضمّ الكتاب 60 نصًا تأسيسيًا يعتبرها البازعي علامات بارزة على الطريق الذي سلكته الحداثة الغربية، بدءًا من القرن السابع عشر حتى بدايات القرن العشرين، مع التركيز على مفكرين مثل ديكارت، سبينوزا، كانط، هيغل، ماركس، نيتشه، هايدغر وغيرهم.
في حواره ضمن برنامج "محاور" على قناة فرانس24 بتاريخ 27 مايو 2023، أوضح البازعي أن الهدف من هذا الكتاب ليس تقديم تعريف حاسم أو نهائي للحداثة، بل تقريب معالمها عبر النصوص نفسها. فالحداثة عنده ليست مفهومًا جامدًا، بل هي عملية تحوّل متعددة الوجوه والمجالات: في الفلسفة، والعلم، والسياسة، والفن، والدين. وقد وصفها بأنها "ركام هائل" نقل الحضارة الغربية من مرحلة إلى أخرى.
الحداثة السائلة وزيجمونت باومان
هل نعيش نحن في العالم العربي داخل هذه الحداثة السائلة؟ أم أن ما يصفه باومان لا ينسحب تمامًا على مجتمعاتنا؟




هذا اللقاء يكشف تحوّلًا مهمًا في خطاب البازعي: من كونه ناقدًا أدبيًا انشغل بالحداثة الشعرية، إلى مفكر ثقافي يعيد قراءة العالم من خلال المفاهيم العابرة، والمرجعيات المتغيرة. كما يُظهر كيف يُوظّف البازعي المفكرين الغربيين، لا بوصفهم نماذج يُحتذى بها، بل كمداخل لإثارة السؤال وفتح النقاش حول المصطلح، والواقع، والذات. أنهى البازعي المحاضرة بسؤال مفتوح للجمهور:
بوصفه اليوم عضوًا في مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، لم يعد الدكتور سعد البازعي مجرد ناقد أو مراقب من الخارج، بل أصبح مشاركًا فعليًا في صياغة السياسات الثقافية الوطنية. لقد أغلق البازعي قوس الحداثة المفتوح منذ الثمانينات، لا بالانسحاب، بل بالدخول في عمق المؤسسة، فاعلًا لا متفرجًا. من موقعه هذا، يُطرح صوته في صلب النقاشات المؤسسية حول مستقبل الأدب والنشر والترجمة، حاملاً معه تاريخًا طويلًا من الاشتباك النقدي الذي تحوّل الآن إلى ممارسة تنظيمية واستراتيجية. وهو يرى أن خطاب الحداثة في السنوات الأخيرة لم يعد صداميًا كما كان، بل أصبح يُدرّس ويُنشر ويُناقش في مؤسسات الدولة، وهي نقلة يرحّب بها لكنه لا يغفل ما تحمله من مخاطر. فبحسب تحذيره، فإن الحداثة حين تُحتوى مؤسسيًا دون حيوية نقدية قد تتحوّل إلى "زينة ثقافية" فاقدة لقوتها الجدلية. بذلك، لا يمثّل دور البازعي في الهيئة مجرد تفوّق رمزي على خصومه السابقين، بل انتقالًا واعيًا من حقل الجدل إلى حقل الفعل، مع حرص دائم على ألا تفقد الحداثة معناها وهي تتكيّف مع المؤسسات.
خاتمة الفصل: البازعي في موقع صناعة القرار
منذ بداياته النقدية، ظلّ الشعر حاضرًا في خطاب الدكتور سعد البازعي ليس بوصفه مجرد موضوع للقراءة، بل كعلامة على التوتر بين الإبداع والتلقي، وبين اللغة والهوية، وبين الموروث والحداثة. ورغم ابتعاده عن ميدان النظم، إلا أن علاقته بالشعر اتخذت شكلًا مختلفًا: علاقة القارئ المبدع، والناقد المتذوّق، والمفكّر الذي يرى في الشعر مرآة عاكسة لتحولات الثقافة العربية، بل والإنسانية عمومًا. ينطلق الدكتور سعد البازعي في حديثه عن الشعر من قناعة جوهرية: أن الشعر ليس شكلًا، بل فعل دهشة. لا يحدّه الوزن والقافية، ولا تقف دلالاته عند التخوم البنيوية للنص، بل يتجاوزها إلى التأثير الوجداني، والوعي الثقافي، وحساسية التلقي.
الشعر
في إطار اهتمامه النقدي الطويل بالشعر، أنجز الدكتور سعد البازعي مشروعًا نقديًا متماسكًا ومتشعبًا يتتبع تحولات القصيدة العربية والخليجية، من خلال سلسلة من الكتب التي يمكن عدّها بمثابة تأريخ ثقافي وجمالي للشعر الحديث والمعاصر في الجزيرة العربية والعالم العربي، بل والعالم.
حين يُسأل الدكتور سعد البازعي: "لماذا لم تستمر شاعرًا؟"، فإن الإجابة التي يقدمها تتجاوز السرد الشخصي أو المجاملة السائدة، لتكشف عن رؤية فكرية عميقة لمفهوم الشعر ذاته، ولموقع الذات الكاتبة في الخريطة الإبداعية.
في لقاء بودكاست الرياض (فبراير 2025)، يستعيد البازعي بداياته الشعرية، حين كان ينشر قصائد في جريدة الرياض، ويشعر بامتلاكه تلك "الطاقة الشعرية" التي تدفعه للكتابة. لكنه يقرّ أن شيئًا ما قد تغيّر حين انخرط في مسار النقد والدراسة، حتى وجد نفسه – دون قرار واعٍ – قد ابتعد عن نظم الشعر.
البازعي لا ينظر إلى النقد بوصفه فعلًا جافًا أو بعيدًا عن الإبداع، بل يراه شكلًا من أشكال التذوق الخلّاق. فالقارئ الجيد لا يستهلك النص، بل يعيد إنتاجه ذهنيًا، ويكشف ما يختبئ فيه من دلالات وإيحاءات، بل وقد يمنحه حياة أخرى عبر التأويل. ولذلك، فإن التخلّي عن كتابة الشعر لم يكن انقطاعًا عن الحقل الإبداعي، بل انتقالًا إلى مسار موازٍ لا يقل أثرًا أو عمقًا.
في هذا السياق، تظهر رؤية البازعي للشعر على أنه تجربة شعورية وفكرية، لا يمكن حصرها في الوزن أو القافية. الشعر عنده ليس مرتبطًا بالبنية فقط، بل بالقدرة على إثارة الدهشة وكسر المألوف والتعبير عن ما يتجاوز الكلمات. لهذا السبب، دافع مبكرًا عن قصيدة النثر، ورأى فيها تعبيرًا صادقًا عن تحوّل عميق في طبيعة الشعر، لا عن نقص أو تراجع. فالإبداع، في نظره، لا يُقاس بشكل القصيدة، بل بالوعي الذي يحركها، وبالأثر الذي تتركه في المتلقي.
هذا الموقف يعبّر عن حساسية نقدية تجاه المفاهيم الجاهزة حول الشعر، ويؤسّس لفهم أكثر اتساعًا للكتابة الإبداعية. فالمبدع ليس فقط من يكتب النصوص، بل من يمتلك القدرة على تذوّقها، وتحليلها، وإضاءة ما فيها من علاقات جمالية وثقافية. والبازعي اختار أن يكون هذا النوع من المبدعين؛ من يقرأ الشعر لا كمتلقٍ سلبي، بل كمن يُعيد تشكيله ويمنحه طبقة جديدة من المعنى.
بذلك، لا يُعدّ ابتعاد سعد البازعي عن نظم الشعر تخليًا بمفهومه السلبي، بل ترجمة لتحوّل عميق في فهمه للكتابة واللغة والجمال، تحوّل جعله يرى الشعر في التحليل بقدر ما يراه في الإبداع، وفي الفهم بقدر ما يراه في الإنشاد، وفي التأويل النقدي بقدر ما يراه في الإلقاء الشعري.
هو أول كتاب أصدره البازعي، ويعدّ تأسيسيًا لفهمه المبكر لمفهوم "الأدب الجديد" في الخليج والسعودية. تناول فيه موضوعات مثل الهوية، الوطن، الحداثة، والقصيدة الحديثة، وناقش شعراء التفعيلة واستدعاء الأسطورة والرموز المحلية. كما اقترح مفهوم "ثقافة الصحراء" كإطار لقراءة الشعر، ربطًا بالبيئة والشفوية، مؤكدًا أن الشعر الحديث آنذاك يمرّ بتحولات بنيوية وثقافية، مما يجعل هذا الكتاب من أوائل الدراسات النقدية التي واكبت الحداثة الشعرية في السعودية.
في لقاء نادر يعود إلى أواخر التسعينات ضمن برنامج "وجهًا لوجه" حول مهرجان الجنادرية، تحدّث البازعي عن الشعر الشعبي بوصفه مكوّنًا من مكوّنات الثقافة السعودية. أشاد بدور المهرجان في حفظ التراث، لكنه حذّر من الوقوف عند التلقي العاطفي، ودعا إلى تحليل الموروث بعين نقدية.
انطلق البازعي في حديثه من الإشادة بالدور الإحيائي الذي لعبه مهرجان الجنادرية في صيانة التراث الشعبي، مشيرًا إلى أن هذا الجهد لا يقتصر على الشعر، بل يشمل عناصر متعددة من الموروث مثل الحرف اليدوية، الأهازيج، والعروض الشعبية. لكنه في الوقت ذاته، نبّه إلى أن مجرد الحفظ أو الاحتفاء العاطفي لا يكفي، بل لا بد من تفكيك هذا التراث بمقاربات ثقافية حديثة، تأخذ في الاعتبار السياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأ فيه، وتقرأ تحوّلاته وتداخلاته مع بقية عناصر الثقافة الوطنية.
أحد المحاور الرئيسة التي تناولها البازعي في هذا اللقاء كان العلاقة بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح، مؤكدًا ضرورة التفريق بين الشعر النبطي بوصفه تعبيرًا تاريخيًا ضاربًا في عمق الجزيرة العربية، وبين الشعر الشعبي المعاصر الذي تأثر بوسائل الإعلام الجديدة وبذائقة جماهيرية لا تخلو من التشويش. وقد لاحظ أن بعض الشعراء الشعبيين، خصوصًا من فئة الشباب، يتجهون في لغتهم إلى الاقتراب التدريجي من الفصحى، سواء بقصد جمالي أو بدافع التلقين المدرسي، مما يشير إلى إمكانات تداخل لغوي قد تكون خصبة للنقد الأدبي.
من هذه الزاوية، يرى البازعي أن العامية لا يجب أن تُقصى أو تُقلَّل من شأنها، لكنها في الوقت نفسه لا يجب أن تُفرض بوصفها النموذج الأعلى للتمثيل الثقافي. وقد أشار إلى أن تضخيم حضور الشعر الشعبي في الإعلام والفعاليات الثقافية قد يؤدي إلى نوع من "الازدواجية الثقافية"، إذ يتلقّى الجمهور العامية بوصفها لغة الثقافة، بينما تنحسر مكانة الفصحى ومفرداتها في الأذهان.
كما تطرّق البازعي إلى الجانب الجمالي للشعر الشعبي، وأكّد أن بعض النماذج الشعبية تمتلك ثراءً تصويريًا ولغويًا لا يقل عن الفصحى، لكن التلقي الغالب لها يبقى حبيس الاستجابة الوجدانية، لا التحليل النقدي. لذلك دعا إلى تجاوز العلاقة العاطفية مع هذا الشعر، والنظر إليه بوصفه نصًا أدبيًا قابلًا للقراءة الجمالية والتأويل الفني.
وفي نهاية اللقاء، وجّه البازعي نقدًا ضمنيًا لتوجّهات بعض المؤسسات الثقافية والإعلامية التي سمحت بنشوء صورة أحادية للثقافة السعودية تتمحور حول الشعر النبطي. وأكّد أن توجيه الذائقة العامة مسؤولية تربوية ومؤسساتية، لا مجرد خيار إعلامي أو استجابة للطلب الجماهيري. فالثقافة، من وجهة نظره، يجب أن تتسع للتعدد دون أن تتنازل عن معيار الجمال واللغة، لأن هذا التوازن هو ما يضمن أصالة الموروث، وفاعليته في الحاضر، واستمراريته في المستقبل.



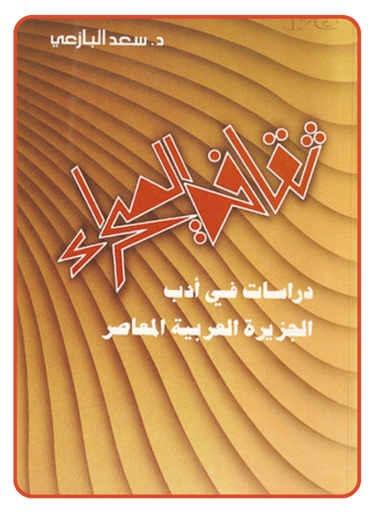
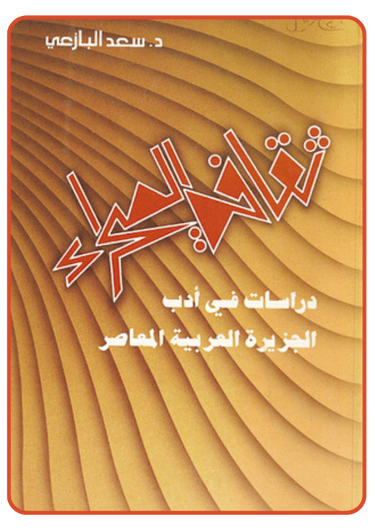
الشاعر سعد البازعي
إحالات القصيدة (١٩٩٨)
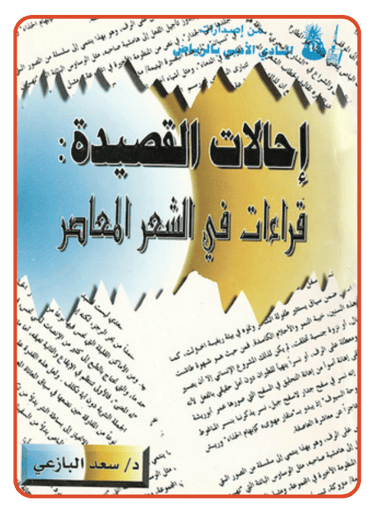
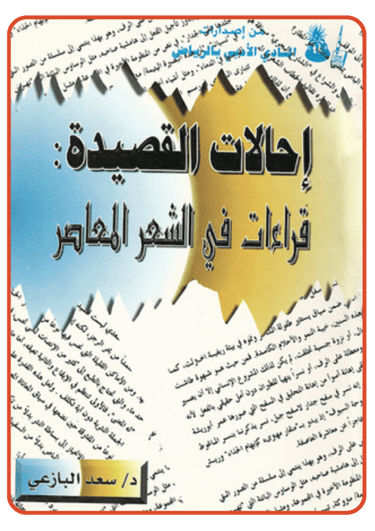
في جلسة حوارية نظمتها دارة الشعر العربي ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، قدّم الدكتور سعد البازعي قراءة معمّقة لإشكالية ترجمة الشعر، مسلطًا الضوء على التوتر الدائم بين جمالية النص الشعري واستعصاءه على النقل إلى لغة أخرى. وتحت عنوان "ترجمة الشعر: الجدوى والضرورة"، تناول البازعي المسألة من منظورين متداخلين: الشعري والنقدي، مؤكدًا أن الترجمة الشعرية ليست فقط محاولة فنية، بل هي فعل تأويلي وجمالي بامتياز.
يرى البازعي أن الشعر هو أكثر أشكال اللغة كثافة وإيحاءً، وهو ما يجعل ترجمته إلى لغة أخرى عملية محفوفة بالفقد. اللغة الشعرية، كما يراها، لا تنقل المعنى فقط، بل تنقل الإيقاع، والصورة، والانفعال، وهذه العناصر مجتمعة يصعب إيجاد مقابل مباشر لها في لغة أخرى. ولهذا السبب، يصف ترجمة الشعر بأنها نوع من "الناقص الضروري"، أو ما يمكن تسميته بالعجز المقبول. فالترجمة قد تقترب من النص، لكنها لا تتطابق معه، ولا تدّعي التماثل الكامل.
استعرض البازعي في الجلسة عددًا من الأمثلة التي توضح أن كل ترجمة شعرية هي قراءة شخصية للنص، لا إعادة إنتاج له، مستشهدًا بحالة رباعيات الخيام، حيث تعدّدت ترجماتها حتى تجاوزت السبعين، وكل واحدة منها تُظهر وجهًا مختلفًا من النص الأصلي. هذا التعدد لا يدل على الخيانة، بل على ثراء النص، وعلى أن الشعر، بطبيعته، يدعو إلى التفسير والتأويل.
وفي هذا السياق، شدّد البازعي على أن الترجمة الشعرية تتطلب وعيًا نقديًا حادًا، لأنها تبدأ بقراءة عميقة للنص، وتتحول إلى مشروع تأويلي يُعيد إنتاج النص بلغته الجديدة، وفق معطيات ثقافية وجمالية مختلفة. وهي بهذا لا تختلف عن الكتابة النقدية الجيدة، التي تستكشف طبقات المعنى وتحاول إيصالها بلغة جديدة، وإن لم تكن مطابقة للأصل.
كما سلّط الضوء على تجربة مركز "إثراء" في ترجمة المعلقات العربية، واعتبرها تجربة رائدة في تقديم الشعر العربي الكلاسيكي لجمهور جديد، حيث جمعت بين النص الأصلي، والترجمة المبسطة، والتعليق النقدي. وهي في نظره محاولة مهمة لتحرير النصوص القديمة من قيد الشروح التقليدية الجامدة، وإعادة تقديمها بروح نقدية معاصرة تحافظ على جمالها وتمنحها حياة جديدة.
وفي ختام مداخلته، قدّم البازعي تصورًا فلسفيًا دقيقًا لترجمة الشعر، معتبرًا أن الترجمة لا تنقل النص بقدر ما تُقربه، وتُضيئه، وتجعله ممكنًا بلغة أخرى. وهي إذ تفعل ذلك، تعترف ضمنًا بأن الشعر أكبر من أن يُختزل في لغة واحدة، وأوسع من أن يُستنفد في ترجمة واحدة. ولذلك، فإن ترجمة الشعر ليست مجرد ممارسة لغوية، بل هي مشاركة وجدانية وجمالية مع النص، تفتح آفاقًا جديدة للقراءة، وتُعيد تعريف حدود اللغة، والمعنى، والجمال.
الشعر الشعبي: بين الموروث والهوية الثقافية
قصيدة النثر: شرعية الإبداع خارج التقاليد
ثقافة الصحراء (١٩٩١)
يركّز البازعي في هذا الكتاب على مرجعيات الشعر الثقافية بدلًا من البنية الشكلية، ويُعنى بمفهوم "الإحالة" كأداة لفهم علاقة القصيدة بموروثها الثقافي، خاصة في ما يتعلق بالشفوية، والموروث الشعبي، والهوية الوطنية. وقدّم فيه قراءات تتنوع بين العمودي، التفعيلة، والنثر، مسلطًا الضوء على شعراء سعوديين وخليجيين من منظور نقد ثقافي يتجاوز حدود النص.
أبواب القصيدة (٢٠٠٤)
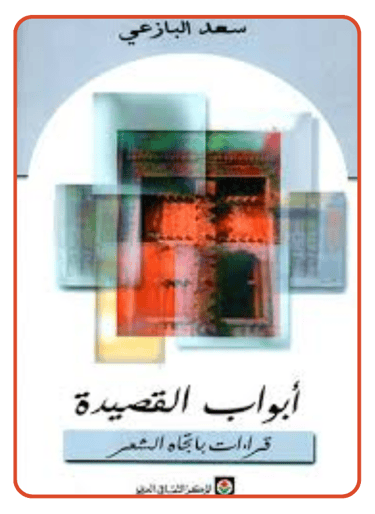
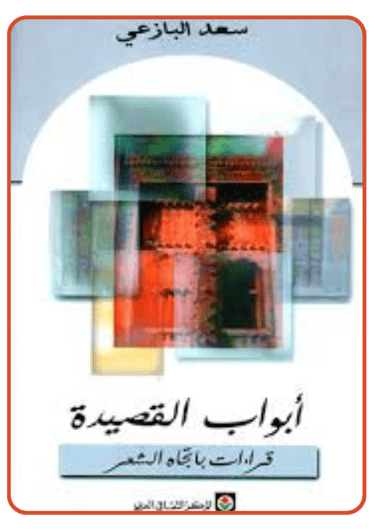
في هذا الكتاب، يعطي البازعي اهتمامًا خاصًا لمفاهيم مثل الشفوية، المثاقفة، وجماليات العزلة، ويتناول قصيدة النثر بوصفها شكلًا شعريًا مثيرًا للجدل والجمال. ويقارب الشعر من خلال أسئلته الجوهرية: ما الذي يجعل الشعر شعرًا؟ كيف تتحول اللغة إلى دهشة؟ وهذا المنحى التأملي يجعل من الكتاب مفترقًا بين التحليل الأدبي والتفكير الفلسفي.
لغات الشعر (٢٠١١)
يُعد هذا الكتاب خلاصة رؤية البازعي للشعر كخطاب إنساني كوني، حيث جمع فيه ترجمات شعرية من لغات متعددة (التركية، الفارسية، الإنجليزية، وغيرها) إلى جانب قراءات نقدية مقارنة. يرى البازعي أن "لغات الشعر" ليست لغات النطق فحسب، بل لغات الرؤية والتجربة الجمالية، مؤكدًا على أن القصيدة ليست بالضرورة مرادفًا للشعر، بل إن الشعر لحظة كشف تتجاوز حدود اللغة. كما تناول فيه قصيدة النثر، الشعر العالمي، إشكالية الترجمة الشعرية، والمجاز الثقافي.

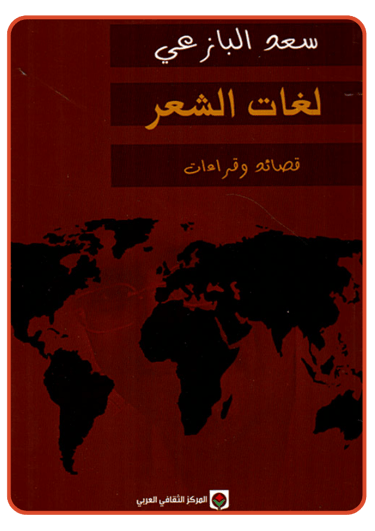
جدل الألفة والغربة (٢٠١٦)
يستكمل البازعي في هذا الكتاب جدلية قائمة في صميم الإبداع: بين ما نألفه وما يغرّبنا. يرى أن من مهام الشعر كشف القشرة الصلبة للعادي والمألوف، عبر تجارب شعرية عربية معاصرة تعيد ترتيب الإحساس واللغة. ويبرز هذا العمل تماهي النقد مع الشعر بوصفه أداة حسّية ومجازية لإدراك العالم.
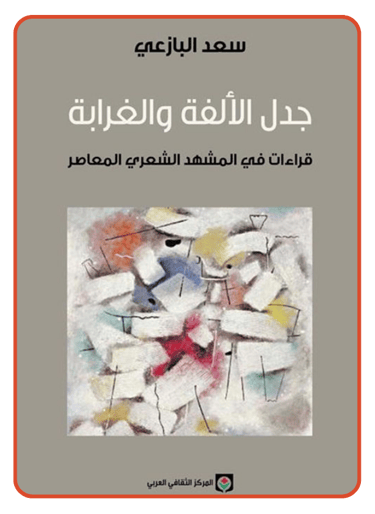
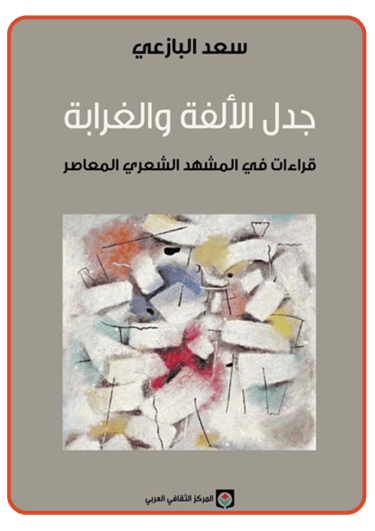
القصيدة الشعبية: سمات التحضر وتحديات التجديد (٢٠١٨)
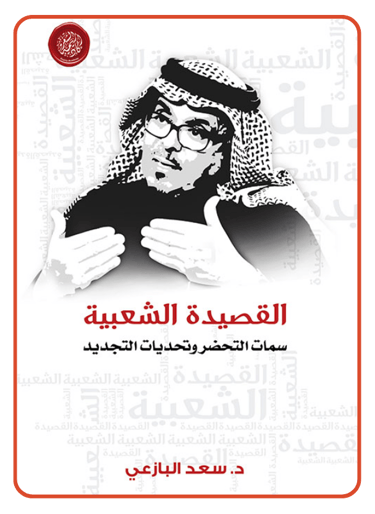
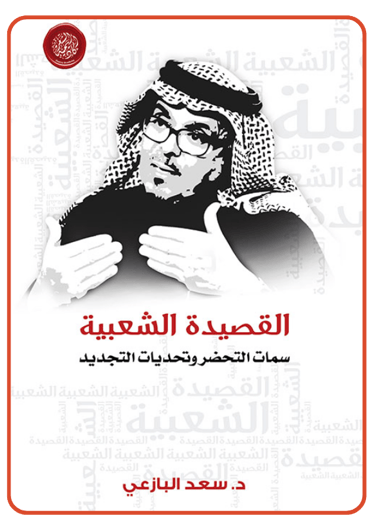
في كتابه هذا، يغامر البازعي بالدخول في نقد الشعر النبطي، ويعيد تأطيره في سياق تحضري وثقافي يتجاوز الثنائية التقليدية بين البدوي والحضري. حلّل فيه أشعار ابن لعبون، الحميدي الثقفي، بدر بن عبدالمحسن، مساعد الرشيدي، وآخرين، واقترح مفهوم "الشعر البرزخي" الذي يتوسط عالمين: الصحراء والاستقرار. واهتم فيه بتحليل الصورة الشعرية، الإيقاع، المجاز، وجرأة الأسلوب، مبرزًا كيف عبر الشعر الشعبي الحديث عن تحولات اجتماعية وثقافية عميقة.
الفرح المختلس (٢٠٢٠)
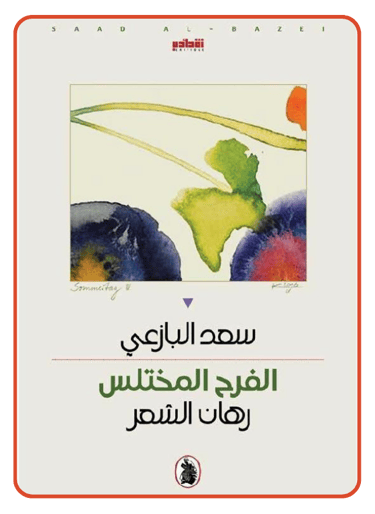
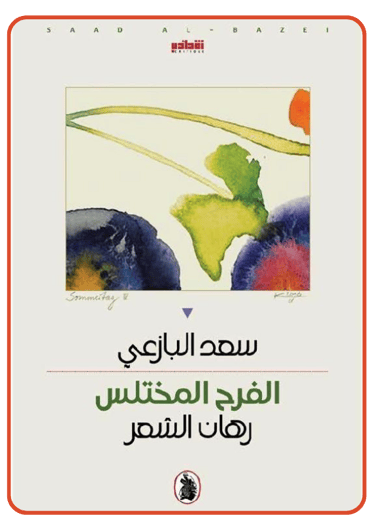
يراهن البازعي هنا على الشعر كفعل مستقبلي، ويستعير عنوانه من أمل دنقل. يتناول رهانات متعددة منها: الحداثة، السياسة، المأساة، اللغة، والترجمة، ويجمع بين العمودي، التفعيلة، والنثر، ويستعرض تجارب شعرية من طيف واسع. كما يعيد التأمل في سؤال الشعرية ذاتها، مذكّرًا بأن النقد أحيانًا يرتفع إلى مستوى الشعر، إن لم يتفوق عليه، ويستعرض نماذج من ريلكه، عزرا باوند، محمود درويش، وغيرهم.
الشعر والترجمة: المستحيل الجميل
لم يتعامل الدكتور سعد البازعي مع قصيدة النثر بوصفها تمرّدًا على التقاليد فحسب، بل بوصفها تحوّلاً تاريخيًا طبيعيًا في بنية الشعر العربي، نابعًا من تحولات أعمق في الوعي واللغة والمعنى. في عدد من حواراته، وخصوصًا في بودكاست "1949"، أوضح أن قصيدة النثر ليست اختراعًا عربيًا بل هي جزء من حركة شعرية عالمية، استوعبت أشكال التعبير الحداثي خارج الإيقاع الخليلي، وانفتحت على التجربة والداخل والعادي والرمزي.
الدفاع الذي قدّمه البازعي عن قصيدة النثر لا ينبني على رفض الشعر العمودي أو التفعيلة، بل على توسيع مفهوم الشعر نفسه. فالشعر عنده لا يُختزل في الوزن، بل في الكثافة، والتوتر الداخلي، واللغة الموحية. ولذلك فهو يرى في قصيدة النثر فضاءً حرًا لتجارب لا تسمح بها البنية الإيقاعية التقليدية، خاصة حين ترتبط بتجارب وجودية أو فلسفية أو تأملية لا تتوسّل الغنائية أو الصنعة البلاغية.
كما بيّن البازعي أن قصيدة النثر قدّمت وجوهًا شعرية لافتة، وأنها ليست مجرّد نثر مكسو بالشعر، كما يروّج خصومها. فهي قادرة على صناعة الدهشة، ومراكمة الصور، وتوليد لغة قادرة على اختراق العادي واليومي. وهي في رأيه لا تُلغِي ما قبلها، لكنها تُضيف إليه، وتفتح بابًا جديدًا لـ"أبواب القصيدة" كما جاء في عنوان أحد كتبه. إن دفاع البازعي عن قصيدة النثر لا يكتفي بإضفاء الشرعية على وجودها، بل يكرّسها بوصفها امتدادًا طبيعيًا لقلق القصيدة نفسها، وتجريبها المستمر، وسعيها نحو التعبير الأكثر صدقًا وعمقًا.
عن قصيدة الهايكو
في واحدة من أمسيات الملتقى الثقافي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالرياض بتاريخ 17 مايو 2023 التي جمعت بين الشعر والبحث، قدّم الدكتور سعد البازعي تعقيبًا دقيقًا وثريًا على أطروحة الشاعر والباحث حيدر العبدالله الموسومة بـ"مهاكاة"، والتي تناولت محاكاة شعر الهايكو الياباني عبر تكييفه داخل البيئة الثقافية العربية من خلال نصوص ذي الرمة. وصف البازعي ما طرحه حيدر بأنه «غني بقدر ما هو مثير للخيال»، مشيدًا بالأسلوب البحثي والبنية المفاهيمية التي سعت إلى دمج فلسفة الزِن اليابانية بعناصر الشعر العربي القديم.
توقف البازعي عند قضايا رئيسية أبرزها صعوبة نقل الشعر بين اللغات، متحدثًا عن ظاهرة "التبيئة" التي تفرض على النصوص أن تتكيّف مع الشروط الجمالية واللغوية للغة المستقبِلة. وقد رأى أن الكثير من المحاولات العربية في كتابة الهايكو ظلت أقرب إلى اللغة العربية منها إلى جوهر الهايكو الياباني، معتبرًا أن الترجمة الحرفية أو حتى الشكلية لا تكفي، وأن القيمة تكمن في فهم روح القصيدة ونسقها النفسي والثقافي.
استحضر البازعي كذلك تجربة الشاعر الأمريكي "إزرا باوند" في التقاط جوهر الهايكو عبر قصيدة من سطرين كتبها بعد مشهد في محطة مترو باريس، وشبّهها بمحاولة للالتقاط الخاطف للصورة الشعرية الواحدة، تمامًا كما يفعل شعراء الهايكو اليابانيون. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن شعر البيت الواحد في التراث العربي قد يكون أقرب للهايكو من غيره، لكنه يختلف من حيث المرجعيات الروحية والبيئية.
وختم البازعي مداخلته بالتأكيد على أن التجارب من هذا النوع تكشف حاجة الثقافة العربية اليوم إلى استلهام أشكال أدبية عالمية دون أن تفقد هويتها، معتبرًا أن عمل حيدر العبدالله يمثّل محاولة واعية ومدروسة لإثراء القصيدة العربية بروح الاختزال والصفاء التأملي الذي يتسم به الهايكو.
غوته والشعر بوصفه مثاقفة
في أمسية أدبية نظمها "الشريك الأدبي – نادي الكتاب" بالرياض، قدّم الدكتور سعد البازعي قراءة ثقافية وشعرية معمقة في تجربة يوهان فولفغانغ غوته، مركّزًا تحديدًا على عمله الشعري الفريد "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي"، الذي مثّل نموذجًا مبكرًا للمثاقفة الشعرية بين الشرق والغرب. لم يكن حديث البازعي تقليديًا أو توثيقيًا، بل جاء محمّلًا بتأملات نقدية حول طبيعة الشعر، وحدود الترجمة، وسؤال الانتماء الجمالي العابر للثقافات. انطلق البازعي من تأكيده أن غوته كان، قبل كل شيء، شاعرًا ذا حساسية استثنائية، وأن هويته الشعرية هي التي منحته خلوده في الثقافة الألمانية والعالمية، رغم تعدد اهتماماته الأخرى في الرواية، والمسرح، والعلوم. واعتبر أن "الديوان الشرقي" لم يكن عملًا بحثيًا عن الشرق، بل نصًا شعريًا انفعاليًا استوحى فيه غوته صوت الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي، واستدخل روحه في نصوص شعرية ألمانية كأنها تنتمي لشرق آخر، أو كما قال البازعي: شرق متخيل بالشعر لا بالجغرافيا.
تمثّل مقاربة الدكتور سعد البازعي للشعر أحد أبرز تجليات مشروعه النقدي والفكري، ليس من موقعه كمبدع مباشر للنص الشعري، بل من موقعه كمؤوِّل له، ومُنقّب في طبقاته الجمالية والثقافية. لقد ظل الشعر، في خطاب البازعي، أكثر من مجرد نوع أدبي؛ إنه حقلٌ متحرّك للمعنى، ومختبرٌ مفتوح للأسئلة الكبرى حول اللغة، والهوية، والثقافة، والزمن. تكشف لقاءاته، منذ الجنادرية وحتى بودكاست "1949" ولقاء نادي الكتاب، عن مقاربة مزدوجة للشعر: فهو من جهة يُعلي من شأن التجربة الشعرية بوصفها مكثفة ودالة، لكنه في الوقت ذاته لا يفصلها عن سياقاتها المعرفية والتاريخية. فالشعر ليس انعزالًا لغويًا، بل تراكمٌ ثقافي يعبر عن الوعي الجمعي، ويتفاعل مع الترجمة، والسياسة، والفلسفة، والمكان.
في تناوله للشعر الشعبي، لم يكن البازعي ينطلق من موقع التحفظ أو الإدانة، بل من رغبة في فهم الوعي الثقافي الذي أنتج هذه النصوص، وكيفية تلقيها. وفي نقاشاته حول ترجمة الشعر، نلمس عمق إدراكه لتشابك المستويات الصوتية والدلالية، وحساسيته تجاه ما يُفقد وما يُستولد أثناء العبور من لغة إلى أخرى. أما كتبه النقدية، فتمثّل الحاضنة النظرية لهذه الرؤية، حيث راوح فيها بين دراسة الشعر بوصفه نصًا جماليًا، وتحليله كخطاب ثقافي متعدّد الأبعاد. من خلال هذا المسار، تتّضح مركزية الشعر في بنية تفكير البازعي، ليس بوصفه ترفًا بلاغيًا، بل بوصفه خطابًا رمزيًا يؤسّس للوعي، ويتيح مساحات للتأمل، والتفكيك، وإعادة بناء المعنى. فالبازعي لا يقرأ الشعر فقط، بل يصغي إليه كمن يصغي لضمير ثقافي خفي، يرى في القصيدة حوارًا بين الذات والعالم، وبين الجمال والقلق، وبين التراث والراهن.
وهكذا، يتجاوز البازعي في خطابه الشعري حدود التصنيف، ليرتقي إلى تأمل عميق في وظائف الشعر، وجمالياته، وتحولاته، في زمن تتعدد فيه اللغات وتتنازع فيه المرجعيات. إنه يُعيد للشعر مكانته بوصفه أحد أنبل أشكال المعرفة، وأدقّها. وهو بذلك لا يكتب عن الشعر فقط، بل يكتب بفكر شعري، يُحاور فيه القصيدة بعين الناقد، وبروح الشاعر الذي لم يكتب قصيدته… لكنه عاشها.
خاتمة الفصل: الشعر كمرآة للفكر وتجلٍ للجماليات الثقافية
مع تصاعد مكانة الرواية في المشهد الأدبي السعودي، رأى الدكتور سعد البازعي في هذا التحول أكثر من مجرّد تطور أجناسي؛ إنه انعكاس لتحول أعمق في الذائقة والوعي والبيئة الثقافية. فالرواية، كما يؤكد، ليست مجرد صيغة أدبية جديدة، بل هي ابنة المدينة بامتياز، وجاء صعودها ليعلن بداية أفول الحساسية الشعرية التي غذّتها تمثّلات الصحراء والبدوي والتمرد الرومانسي.
في حديثه مع الإعلامي يحيى الأمير في برنامج ياهلا عام ٢٠١٦، أشار البازعي إلى أن "ثقافة الصحراء" الموضوع الذي تحدث عنه كثيراً شكّل أحد مراحل التعبير الشعري في السعودية، حيث سعى الشعراء إلى تبني صورة البدوي المتمرّد، لا باعتباره حالة اجتماعية قائمة، بل كأسطورة مضادة للمدنية والقيم المؤسسية. هذه الثقافة عبّرت عن ذروة التوتر بين المثقف والواقع، بين المدينة كواقع عيني، والصحراء كحلم رمزي بالانفلات والحرية. إلا أن هذا الخطاب لم يصمد طويلًا أمام تحولات الواقع وانفجار الحياة المدينية.
هذا التحوّل، من "أنا البدوي" إلى "أنا ابن المقهى"، لم يكن مجرد نقلة في اللغة، بل تغييرًا عميقًا في النظرة إلى الذات والعالم. ومن هنا، تكتسب الرواية السعودية أهميتها، ليس فقط كجنس أدبي صاعد، بل كمؤشر على نقلة ثقافية كاملة في المخيال السعودي، وهي النقلة التي سنرصد ملامحها وتجلّياتها في هذا الفصل.
الرواية
مثّلت الرواية أحد أبرز انشغالات الدكتور سعد البازعي النقدية، إذ لم يقتصر في تناولها على بعدها الجمالي أو السردي، بل اتخذها مدخلًا لفهم التحولات الثقافية والاجتماعية الكبرى. وفي مؤلفاته يتبدّى مشروعه في تحليل الرواية كخطاب حضاري يعكس صراعات الهوية والمدينة، وتحولات القارئ، ومآلات الحكاية في عالم معقد. تتوزع قراءاته بين المحلي والعالمي، وتجمع بين عمق التأويل وسلاسة اللغة، في سعي دائم لربط النص بالسياق، والفن بالحياة.
في سياق تحليله للرواية العربية المعاصرة، قدّم الدكتور سعد البازعي في محاضرته بنادي حائل الأدبي عام 2016 رؤية شاملة حول تمثلات "المثقف" داخل النص السردي، مبينًا أن الرواية لم تعد مجرّد جنس أدبي يُعنى بالحكاية أو التسجيل، بل أصبحت مساحة لتمثيل التحولات الفكرية والاجتماعية التي يعيشها الإنسان العربي، وفي القلب منها صورة المثقف. صنّف البازعي هذه الصورة إلى أربع تمثيلات متكررة في المتن الروائي العربي: المثقف المضطهد، المثقف المنفي، المثقف المتأمل في عزلة، والمثقف الانتهازي، موضحًا أن هذه الصور تتقاطع مع التصنيفات التي وضعها هشام شرابي، خاصة في تمييزه بين المثقف الملتزم، والمهني، والتابع للأيديولوجيا، والمثقف المتذبذب.
اعتمد البازعي على نماذج سردية متنوعة لتجسيد هذه التمثيلات، من بينها شخصية "رجب" في شرق المتوسط، و"صبحي المحملجي" في مدن الملح لعبد الرحمن منيف، و"نمير" في فهرس لسنان أنطون، وأستاذ التاريخ المنفي في رواية أمرٌ كان لي لصلاح الراوي، و"زينة" المثقفة التونسية في الطلياني لشكري المبخوت، مؤكدًا أن الرواية العربية عبر هذه الشخصيات لا ترسم صورة واحدة للمثقف، بل تبرز معاناته بين القمع والتهميش، وبين الالتزام والانتهازية، وبين صوت الضمير وإغراءات النجاة الفردية.
وفي مقابل هذه الحيوية السردية في تقديم المثقف، لاحظ البازعي غياب هذه الشخصية عن الرواية السعودية المعاصرة، رغم اتساعها العددي ونجاحاتها الجوائزية، معتبرًا أن هذا الغياب ليس دليلاً على ضعف الرواية بل مؤشراً على خصوصية المشهد المحلي الذي ما زال يبحث عن المثقف داخل النص كما هو في الواقع.
يرصد البازعي في هذا الكتاب تحوّلات المدينة كحاضن للسرد، ويرى أن الرواية تَنمت بموازاة التحولات المدينية والاجتماعية، بل ويصف "نثر المدن" بوصفه لحظة فاصلة في تشكل الوعي السردي في السعودية والخليج. من خلال تحليل روايات مثل البحريات لأميمة الخميس، وجاهلية لليلى الجهني، وهند والعسكر لبدرية البشر، يتتبّع البازعي أشكال التوتر بين المدينة والصحراء، والمرأة والمجتمع، والخطاب الديني والخطاب اليومي. يتجاوز بعد ذلك الرواية السعودية ليقارب سرديات عربية وأجنبية ضمن محور "صورة الغرب"، ويصل في القسم الثاني من الكتاب إلى السينما كامتداد للحكاية.
في ندوة فكرية أقامها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة في يناير 2024، تحت عنوان "الرواية الخليجية وسؤال الهوية: السوسيولوجيا الموازية", طُرح أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في سياق الأدب الخليجي الحديث: كيف تعبّر الرواية عن هوية الخليج؟ وهل يمكن للأدب أن يُعيد تشكيل صور الذات في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة؟ جمعت الندوة عددًا من الباحثين والنقاد والروائيين الخليجيين، وانقسمت مداخلاتهم بين من يرى الرواية مرآة للتحولات الاجتماعية، ومن يرى أنها ممارسة تخييلية تتجاوز الواقع إلى مساءلته وتفكيكه.
من بين أبرز المداخلات، جاءت ورقة الدكتور سعد البازعي بعنوان "مدن التيه: سؤال الهوية في رواية عبد الرحمن منيف". وقدّم فيها قراءة مركبة لسؤال الانتماء والهوية في خماسية مدن الملح، مستعرضًا عبرها العلاقة المتوترة بين الداخل والخارج، بين الكاتب والمنطقة التي كتب عنها، دون أن يُقيم فيها إقامة جسدية أو يحمل جنسيتها.
في هذه الورقة، انطلق البازعي من سؤال محوري: هل عبد الرحمن منيف روائي سعودي؟ ليست المسألة هنا متعلقة بالجنسية فحسب، بل بالانتماء الثقافي والمعرفي والرمزي. يرى البازعي أن منيف ينتمي إلى المجال الثقافي العربي الأوسع، وأن رواياته، خصوصًا مدن الملح، تعبّر عن علاقة معقدة وغير مستقرة بالبيئة الخليجية، لا سيما السعودية. فهي رواية مكتوبة من الخارج، لكنها مشبعة بتفاصيل الداخل، تنظر إليه نظرة مؤرّخ سياسي لا نظرة كاتب محلّي.
يناقش البازعي هذا التوتر من خلال المقارنة بين من كتب من الداخل، كتركي الحمد، ومن كتب من الخارج، كمنيف. ويشير إلى أن الأخير استخدم تقنيات رمزية، مثل تغيير أسماء الأماكن والشخصيات، لا فقط كأدوات فنية، بل كاستراتيجية نقدية تحفظ له هامش الحرية في الكتابة. فالخوف من الملاحقة أو الإقصاء جعل من الرمزية السياسية أداة لحماية النص وكاتبه معًا.
من زاوية أعمق، يلفت البازعي النظر إلى المفارقة اللافتة في غياب موضوع النفط عن الرواية السعودية، رغم أنه عنصر تكويني في الهوية الخليجية الحديثة، في حين يتصدر هذا الموضوع نصوص منيف، مما يبرر - بحسب البازعي - وصف رواياته بوصفها "روايات النفط والسلطة والانتماء". كما يُقحم مفاهيم نقدية متعددة في قراءته، منها: الهوية المتخيلة (بندكت أندرسون)، الأرشيف (ميشيل فوكو)، التعدد الصوتي (باختين)، ليؤكد أن منيف يمارس كتابة تفاوضية مع السلطة والهُوية من موقع خارجي، لا من قلب البنية المحلية.
إن أبرز ما تطرحه ورقة البازعي، أنها لا تمنح عبد الرحمن منيف مكانة في الرواية الخليجية لمجرد كتابته عنها، بل تضعه في موقع إشكالي، بوصفه كاتبًا يكتب من الخارج عن الداخل، فتُعيد بذلك مساءلة مفاهيم مثل "الرواية الوطنية"، و"الانتماء الأدبي"، و"جنسية النص"، وتضع القارئ أمام سؤال أخير أكثر تعقيدًا: هل تكتب الهوية النص، أم يكتب النص هوية بديلة؟



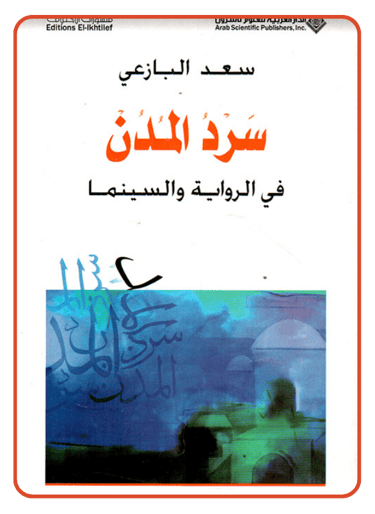
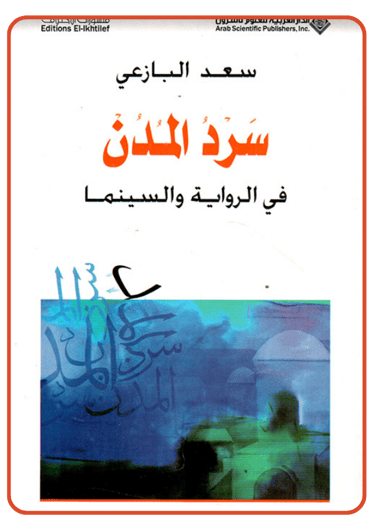
مشاغل النص واشتغال القراءة (2014)
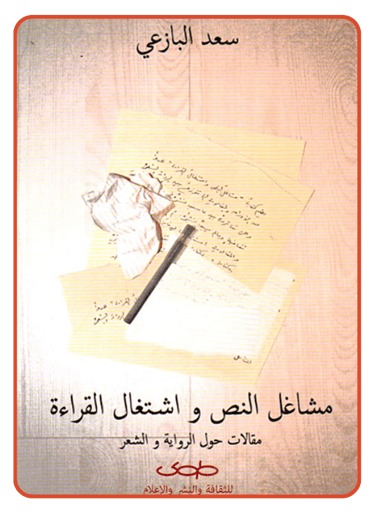
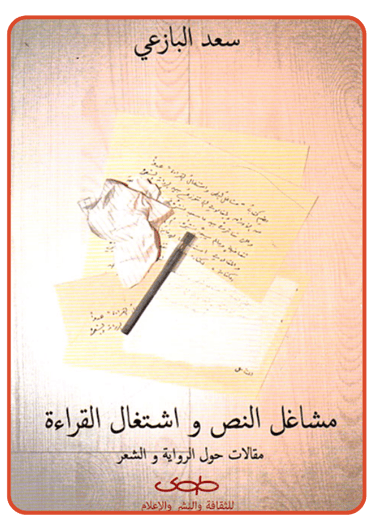
قدم الدكتور البازعي عدة محاضرات عن "الرواية المهاجرة"، آخرها كان في لقاء بتاريخ 16 يوليو 2025 بالتعاون نادي سمو الحرف، قدّم الدكتور سعد البازعي قراءة عميقة لظاهرة الروايات التي كتبها كتّاب عرب في المهجر، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وركّز على ما وصفه بـ"الكتابة تحت وطأة الهجرة" حيث لا تكون الغربة مجرد تجربة جغرافية بل معاناة وجودية وثقافية. يرى البازعي أن هذه الروايات تعبّر عن توتر الهوية، محاولة الاندماج، مقاومة التهميش، والتصالح مع الذات.
ركّز البازعي على ثلاثة نماذج رئيسية: الكاتبة السودانية المصرية ليلى أبو العلا، والكاتبة الفلسطينية اللبنانية ليلى حلبي، والروائي العراقي سنان أنطون، مع إشارات إلى كُتّاب آخرين كـ إنعام كجه جي وسحر مصطفى.
في روايتها "المترجمة", تصوغ ليلى أبو العلا نموذجًا لشخصية مغتربة عن المكان لكنها متجذّرة في العقيدة. فـ"سمر"، بطلة الرواية، تعيش في اسكتلندا وتعمل مع باحث غربي في دراسات الشرق الأوسط، لتخوض صراعًا داخليًا بين عاطفة الحب والتزام الدين، بين الانجذاب للآخر والوفاء للذات. وتؤكد أبو العلا في أحد الحوارات أن الإيمان لديها "أعمق من الهوية وأكثر أهمية من الجندر والجنسية والطبقة والعرق"، مما يجعل من الرواية وسيلة للدفاع عن الذات والثقافة، وتأكيد الانتماء في بيئة تُثير الشكوك حول هذا الانتماء.
أما ليلى حلبي، في روايتها "ذات مرة في أرض الميعاد"، فتتناول قصة زوجين من أصل فلسطيني في أمريكا بعد أحداث سبتمبر، حيث يتعرضان للتهميش والمراقبة، مما يعكس أجواء التوتر التي عاشها العرب والمسلمون في الغرب بعد تلك الأحداث. يلفت البازعي النظر إلى أن حلبي، رغم تناولها لموضوع إسلامي في ظاهره، إلا أن منظورها علماني، يعكس أزمة الهوية الثقافية أكثر من الدينية.
أما سنان أنطون، فهو المثال الأبرز على من ظلّ يكتب بالعربية رغم عيشه في أمريكا. في رواياته مثل يا مريم وفهرس ووحدها شجرة الرمان، يرسم أنطون صورة مزدوجة للمغترب الذي يشعر بالذنب تجاه وطنه، ويستخدم الرواية وسيلةً لـ"إعادة نسج الحبال السرية بين الأشياء وأمهاتها" كما يقول. يلاحظ البازعي أن الكتابة عند أنطون تلامس الشعر، وتبتعد أحيانًا عن السرد التقليدي، في محاولة لاستعادة العراق الذي فقده، واستعادة ذاته الممزقة بين المكانين.
يرى البازعي أن الرواية هنا لا تُكتب للترف، بل لتلبية حاجة داخلية، لحفظ الهوية، والتواصل مع الوطن، رغم بعد المسافة. كما أشار إلى أن هذه الكتابات تطرح سؤالًا معقّدًا حول تصنيفها: هل هي روايات عربية أم غربية؟ كتّابها لا يُعَدّون غربيين تمامًا، ولا يُقبلون دومًا في نادي الأدب العربي بحكم اللغة أو الموقع.
بذلك، فإن "هجرة الرواية" عند البازعي هي هجرة في اتجاهين: من الوطن إلى المنفى، ومن الغربة إلى الوطن عبر السرد. هي محاولة لترميم الذات واستعادة المعنى، وجعل الحبر وطنًا بديلًا حين تضيق الأرض.
تمثلات المثقف في الرواية العربية وغيابه في الرواية السعودية
الرواية والتاريخ: جدل الفن والوثيقة
سرد المدن في الرواية والسينما (2009)
في هذا الكتاب، تتسع مقاربة البازعي للرواية نحو قراءة تأويلية تجمع بين الحس الجمالي والانشغال الفلسفي، كما في تحليله لرواية الموت الذي اختفى أو كما تم ترجمتها "انقطاعات الموت" لجوزيه ساراماغو، حيث يتحول الحلم البشري بالخلود إلى كابوس وجودي. في مقالة أخرى، يتناول رواية كتاب خالد لأمين الريحاني كمثال على "الرواية المثاقفية"، ويقارب فيها قضايا المكان واللغة والهوية. يتجلّى في هذه القراءات تمسّك البازعي بمنهج مزدوج: انطباعي-تحليلي، حيث تمثل الرواية في نظره "ساحة تأويل" أكثر من كونها وثيقة سردية محايدة.
مصائر الرواية (2020)
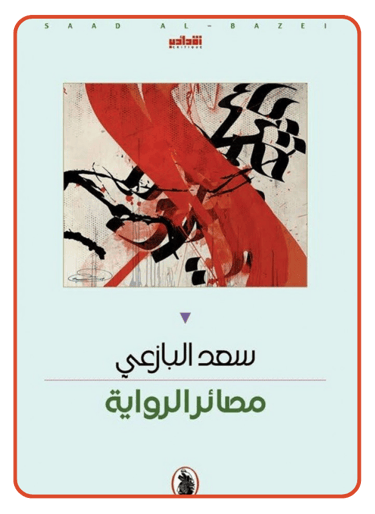
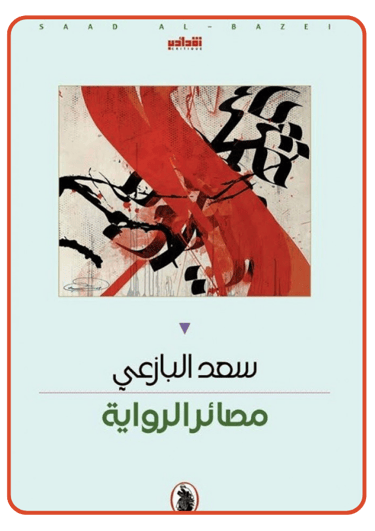
أما في كتابه مصائر الرواية، فيطرح البازعي مشروعًا أكثر تنظيرًا، فيجمع مقالاته المتفرقة داخل بنيات موضوعاتية واضحة، على رأسها "العنف" و"الأقليات". يقدّم الرواية بوصفها خطابًا اجتماعيًا وجماليًا، يشتبك مع الواقع عبر الحساسية اللغوية والفنية، ويرى أن القراءة النقدية الجادة لا تكتمل دون تذوق الجماليات. تنقسم فصول الكتاب إلى أربعة محاور: "رواية العنف"، "رواية الأقليات"، "الفكر الروائي"، و"الرواية المترجمة"، حيث يناقش نماذج من الروايات العربية مثل فرانكشتاين في بغداد، موت صغير، الطلياني، ويقاربها بمفهوم تأويلي لا يقف عند سطح القضايا بل يشتبك معها مفاهيميًا وفلسفيًا، كما في حديثه عن "مصائر الحكاية" والتحولات التي تطال "العين القارئة".
يرى سعد البازعي أن رواية الفنتازيا، رغم انتشارها الواسع بين القرّاء الشباب، لا تندرج في تصنيفه ضمن الرواية الجادة. في حديثه عن ظاهرة الكاتب أسامة المسلم، عبّر بوضوح عن تحفظه تجاه هذا النوع من السرد، واصفًا أعمال الفنتازيا ذات الطابع الترفيهي بأنها "فقاعات سردية" تُستهلك سريعًا ثم تُنسى، لأنها – بحسب رأيه – تفتقر إلى العمق الفكري والطرح الجمالي الذي يجعل الرواية تستحق الوقوف عندها نقديًا. وبرغم إقراره بصعوبة بناء عوالم فنتازية وشخصيات غير واقعية، فإنه لا يرى في هذه الأعمال سوى سرد مشوّق ومطاردات وإثارة دون مضمون معرفي أو قيمي.
البازعي يميّز بين الأدب الذي يُكتب للتسلية، وبين الرواية التي تناقش قضايا الحياة والمجتمع والأخلاق والفلسفة. وفي هذا السياق، يرفض مساواة روايات الفنتازيا – مهما بلغ انتشارها – بالروايات التي تمتح من الواقع وتخاطب الوعي، مثل أعمال أميمة الخميس وعبده خال وبدريّة البشر، التي يرى فيها امتدادًا للرواية العربية الجادة. وبرغم ترؤسه لجائزة القلم الذهبي، التي تضم مسارًا خاصًا برواية الفنتازيا، شدّد على أن الأعمال الفائزة بالجائزة الكبرى لم تكن من هذا النوع، مؤكدًا أن تقييم الجائزة يخضع للجان متخصصة لا لذوقه الشخصي، وأن الفنتازيا كغيرها تتفاوت في مستواها بين البسيط السطحي والعميق المؤثر.
بهذا الموقف، لا يرفض البازعي الفنتازيا بوصفها نوعًا أدبيًا قائمًا بذاته، بل ينتقد مستوى ما يُنتج تحت هذه اليافطة في المشهد العربي والخليجي المعاصر، داعيًا إلى تمييز بين النجاح الجماهيري والقيمة الأدبية، وإلى تقديم أدب يخاطب خيال القارئ دون أن يتخلى عن وعيه.
الرواية المهاجرة: بين الاغتراب والعودة السردية
في مشاركته بحلقة تلفزيونية في برنامج هاش خليجي بتاريخ 25 نوفمبر 2013 التي خصصت للنقاش حول الرواية التاريخية، قدّم الدكتور سعد البازعي موقفًا واضحًا من حدود العلاقة بين الفن الروائي والتاريخ بوصفه علمًا. أكد منذ البداية أن «الرواية إذا لم تتلاعب بالأحداث فلن تكن رواية»، موضحًا أن جوهر العمل الروائي يقوم على إعادة صياغة الأحداث لا تقديمها كما هي، وأن الكاتب حين يكتب رواية تاريخية لا يُطلب منه الدقة التوثيقية، بل يُنتظر منه أن يقدّم رؤيته الخاصة للحدث من منظور فني، وهذا ما يُضفي على الرواية قيمتها الجمالية.
غير أن البازعي في المقابل نبّه إلى إشكالية "تقمص دور المؤرخ" حين يتجاوز الروائي الفني إلى تقرير حقيقة تاريخية مثيرة للجدل، كما حدث في رواية "سلام" للكاتب هاني نقشبندي، التي اعتبرت الفتح الإسلامي للأندلس احتلالًا وطالبت العرب بالاعتذار للإسبان. يرى البازعي أن هذا الطرح يخرج من وهم الفن إلى صلابة التاريخ، ويتحول إلى ادعاء تصحيحي يستوجب مساءلة نقدية، لأن الرواية عندئذ لا تكتفي بإضاءة التاريخ، بل تنحاز إلى حكمٍ قاطع يُربك المتلقي بين الرواية والتوثيق.
في تفسيره للفارق الجوهري بين الرواية والتاريخ، يذهب البازعي إلى أن الرواية التاريخية ليست مصدرًا للتاريخ، لكنها تضيف إلى فهمه عبر قراءة مغايرة للأحداث، بل تُبرز ما لم يبرزه المؤرخون. ضرب لذلك أمثلة من الرواية العالمية والعربية: "الحرب والسلام" لتولستوي، وثلاثية نجيب محفوظ، حيث لم تكن الغاية نقل وقائع دقيقة بقدر ما كانت تقديم رؤية الفنان للمرحلة ولشخصياتها وأزماتها. فالروائي – كما يرى البازعي – لا يوثق، بل يُحلل من زاوية شعورية ونقدية.
لكنّ البازعي لم يرفض تمامًا فكرة التداخل بين التاريخ والرواية، بل دعا إلى استثمار هذا التماس داخل الجامعات، مقترحًا إدخال الرواية التاريخية ضمن مناهج أقسام التاريخ، ليقرأها الطلاب بوصفها نصوصًا تحليلية تُثري الجانب الإنساني للتاريخ الجاف، وتُدرَّس جنبًا إلى جنب مع النصوص التوثيقية، فيُدرَّب الطالب على التمييز بين الرؤية الأدبية والرؤية الوثائقية.
وفي ختام اللقاء، عبّر البازعي عن إيمانه بدور الرواية في تمثيل التحولات المدنية للمجتمع، مؤكدًا أن ازدهار الرواية في السعودية يعكس نمو الوعي المدني، وأن الرواية «ابنة المدينة»، تُكتب حين يصبح للإنسان صوت فردي، وهمّ سردي، وذاكرة تحتاج إلى تأويل. لكنه شدّد على أن الحكم على الرواية ينبغي أن يكون من خلال القارئ الواعي العارف بالأدب والتاريخ، لا عبر ردّات فعل عاطفية أو قراءات متعجلة.
الفلسفة والرواية
توقّفنا في فصل "الفلسفة" من هذا التقرير عند العلاقة العميقة بين السرد والتفلسف، كما قدّمها الدكتور سعد البازعي في محاضرته "الرواية والفلسفة" (2019)، وهي علاقة لا تنفصل عن رؤيته الأوسع لمفهوم الرواية بوصفها خطابًا متشابكًا مع أسئلة الفكر والوجود والمعنى. يرى البازعي أن هذه العلاقة ضاربة في التاريخ، تعود إلى محاورات أفلاطون، وحكايات نيتشه، وتأملات كيركجارد، حيث لم تكن الفلسفة يومًا حكرًا على الجملة النظرية المجردة، بل كثيرًا ما استعانت بالحكاية لتوصيل أفكارها، تمامًا كما توظف الرواية بنية التأمل كي تطرح أسئلتها.
منذ أول لقاء وأول كتاب عن الرواية، مازال البازعي يُرسي دعامة مركزية لفهم موقع الرواية في الثقافة السعودية الحديثة: فهي ليست مجرد تطور أجناسي، بل تحوّل في البنية الشعورية للمجتمع، وانتقال من الميثولوجيا الصحراوية إلى سرد الحياة اليومية، من الجَماعيّ القبليّ إلى الفرديّ المدنيّ. لقد قاربت قراءاته النقدية الرواية باعتبارها وسيطًا لتحليل الأسئلة الكبرى: الهوية، السلطة، التاريخ، الهجرة، الفقد، والانتماء. وفي كل ذلك، ظل البازعي مخلصًا لرؤية تجعل من الرواية أفقًا للتأمل لا منصة للوعظ، ومن السرد فعلًا فلسفيًا لا مجرد حكاية.
الرواية في خطاب البازعي ليست أدبًا للترف، بل شكلًا من أشكال المعرفة، ومختبرًا للهويات المتنازعة، وللغة وهي تفتش عن معناها في عالم مضطرب. من المدن الخليجية إلى منافي الهجرة، ومن أسئلة الانتماء إلى تشكّلات الأقليات، ومن الحاضر المُعاش إلى الماضي المتخيَّل، ظلّ مشروعه النقدي يقرأ الرواية بوصفها وثيقة جمالية تتقاطع مع التاريخ دون أن تنحني له، وتفكك الواقع دون أن تستسلم له.
وبينما تتجه الرواية اليوم إلى مسارات جديدة من التجريب والتخييل العلمي والكتابة النسوية والرقمية، يبقى صوت البازعي ضروريًا، لا ليصنّفها أو يحاكمها، بل ليرشد قارئها إلى ما وراء النص: إلى ما تقوله الرواية عن زمنها، ومجتمعها، وعنّا نحن الذين نقرؤها. هكذا لا تكتمل الرواية عند البازعي إلا بالقارئ: ذاك الذي يتذوق الجمال، ويشتبك مع المعنى، ويحمل الرواية إلى الحياة لا إلى الرفوف.
خاتمة الفصل: البازعي ناقداً للرواية
مدن التيه: سؤال الهوية في رواية عبد الرحمن منيف
رواية الفنتازيا بين السهولة والجاذبية
البازعي رئيساً لجائزة القلم الذهبي
في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها المشهد الثقافي السعودي، حضرت الرواية بوصفها ميدانًا مركزيًا تتقاطع فيه الفنون، ولعل أبرز ما يُجسّد هذا التداخل في السنوات الأخيرة هو تأسيس جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، التي يترأسها الدكتور سعد البازعي، جاءت فكرتها لتجسر المسافة بين الرواية والسينما، عبر استحداث مسارات تُشجّع الروائيين على تقديم أعمال قابلة للتحوّل إلى أفلام، دون التفريط بالقيمة الأدبية للنص.
وبين هواجس "الجماهيرية" و"النخبوية"، يؤمن البازعي أن العمل الروائي الناجح هو ذاك الذي يقنع الجمهور من دون أن يهبط إلى التبسيط المبتذل. ويُحذّر من أن بعض الجوائز قد تدفع الكاتب لكتابة ما تريده الجائزة، لا ما يمليه عليه فنه. ومع ذلك، يرى أن هذا الانزلاق يحدث غالبًا لدى الكتّاب المتوسطين، بينما المبدع الحقيقي يكتب بشروطه الخاصة. جائزة القلم الذهبي، من وجهة نظر البازعي، ليست مجرّد مسابقة، بل مشروع تأسيسي لرواية عربية قابلة لأن تُشاهَد لا أن تُقرأ فقط. إنها تجربة لا تسعى لحل أزمة النص فحسب، بل إلى بناء "بنك روائي" يُغذّي السينما العربية لسنوات مقبلة. هكذا، تتحوّل الرواية من جنس أدبي مغلق إلى بنية سردية متعددة الوسائط، وتغدو الجائزة نفسها معبرًا نحو التأسيس لمرحلة ثقافية جديدة، قوامها التلاقي بين النص والصورة، بين القارئ والمشاهد.
في الرابع عشر من أكتوبر لعام 2019، خصص نادي القصيم الأدبي أمسية لتكريم الدكتور سعد البازعي، لكنها لم تكن مجرّد لحظة احتفاء، بل تحوّلت إلى لحظة تأمل نادرة في المسيرة النقدية لأحد أبرز الأصوات التي أسهمت في صياغة الوعي الأدبي في المملكة. لم يقدّم البازعي محاضرة بالمعنى التقليدي، بل اختار أن يحاور تجربته، أن يعرضها على مهل، من الداخل، كمن يعيد قراءة نفسه بصوت مسموع.
في تلك الليلة، أوضح البازعي كيف تشكّلت علاقته بالنقد بعيدًا عن قاعات الجامعة، وإن لم تكن منفصلة عنها. فقد بدأ مبكرًا بنشر مقالات ثقافية أثناء دراسته في أمريكا، قبل أن يتلقى نصوصًا شعرية سعودية معاصرة دفعته للانخراط في ما عُرف لاحقًا بحراك الحداثة. ورغم انشغاله الأكاديمي المتخصص في الأدب الإنجليزي، ظل يرى أن الجامعة لا تكفي لتأدية دور الناقد، وأن المساهمة في المشهد الثقافي تتطلب حيوية وقلقًا لا توفرهما المؤسسات الجامدة.
استعرض البازعي ملامح مشروعه النقدي من خلال تقسيم أعماله إلى ثلاث مجموعات رئيسية: كتب تعنى بالنقد الأدبي الحديث، وأخرى تتبنى منهجية أكاديمية صارمة، وثالثة ذات طابع فكري وثقافي عام. كان وعيه متماسكًا حول طبيعة هذا التوزيع، مدركًا أن النقد لا يتحدد بمنهج واحد، بل يتطلب مرونة تتحرك بين اللغة والتحليل والفكر والمجتمع.
النقد بالنسبة له لم يكن يومًا وسيلة لتثبيت السلطة أو لتأكيد الذوق، بل ممارسة معرفية قلقة، تقوم على الفحص، والتحليل، وإثارة الأسئلة. وعلى امتداد تجربته، ظل ملتزمًا بالتحقق والتأني، متجنبًا الانسياق وراء التعميمات السريعة أو الانطباعات الخفيفة. هذه النزعة جعلته، من جهة، ناقدًا حذرًا من السجال العقيم، ومن جهة أخرى، حاضرًا في النقاشات الأساسية التي شكّلت مشهد الثقافة السعودية الحديثة.
حديث البازعي عن النقد لم يأتِ من موقع التنظير المعزول، بل من سيرة ممتدة، خاضت معارك المفاهيم، وواجهت تحولات الأجيال، وحافظت رغم كل شيء على مركزية السؤال النقدي بوصفه فعلًا ضروريًا في الثقافة.
النقد
على امتداد مسيرته النقدية الممتدة منذ الثمانينيات، قدّم الدكتور سعد البازعي إسهامات نوعية في النقد الأدبي، متجاوزًا حدود القراءة المدرسية إلى أفق المقاربة الحضارية والتاريخية للنصوص. تميزت كتبه النقدية بالتنوع من حيث المنهج والمحتوى، وجمعت بين التأصيل النظري، والتحليل التطبيقي، فيما يلي استعراض لأبرز كتبه عن النقد:
في واحد من أكثر اللقاءات وضوحًا وتفصيلًا في خطاب الدكتور سعد البازعي، عرض الناقد والكاتب السعودي رؤيته النقدية تجاه ما يُعرف اليوم بـ"النقد الثقافي"، وذلك ضمن حلقة تلفزيونية تناولت هذا المفهوم الجدلي، الذي يرى فيه البازعي حقلًا غير متبلور، يفتقر إلى الأسس المنهجية والمصطلحية. افتتح اللقاء بعرض الجدل حول قُصور النقد الأدبي عن تحليل الثقافة والبُنى المضمرة والأنساق الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن بعض الأصوات طالبت بـ"نقد جديد" يتجاوز الشكل الفني والبلاغي، نحو تفكيك الخطاب الثقافي الجمعي. هنا، يضع البازعي حدًا فاصلاً بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، مؤكدًا أن الأخير ليس بديلاً عن الأول، بل لا يمكن أن يكون كذلك.
أوضح البازعي أن النقد الأدبي يمتلك تاريخًا طويلاً، ومناهج راسخة، ومصطلحات دقيقة، منذ أرسطو وحتى النظريات الحديثة كالبنيوية، التفكيكية، والنقد الماركسي. أما ما يُطلق عليه "النقد الثقافي"، فهو عنده اتجاه هلامي، لم يطور منهجًا خاصًا به، بل يستعير أدوات من الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، النقد النفسي، وغيرها. يميز البازعي بين الدراسات الثقافية بوصفها فرعًا أكاديميًا مؤسسًا داخل الجامعات وله جذور في النظرية الماركسية، وبين النقد الثقافي بوصفه خطابًا فضفاضًا. الدراسات الثقافية، كما يوضح، تملك اهتمامات واضحة كتحليل الألعاب، النكت، المظاهر اليومية، بينما النقد الثقافي كما يُمارَس عربيًا ينتهي غالبًا إلى تحليل الشعر من منظور أخلاقي أو رمزي، فيُعيد إنتاج ما يفعله النقد الأدبي باسم جديد.
أحد أكثر المفاهيم التي يرتكز عليها النقد الثقافي هو "النسق المضمر"، أي الأفكار المهيمنة التي لا يُصرح بها النص لكنها تشكله من الداخل. هنا، يعترض البازعي على اعتبار هذا المفهوم فتحًا جديدًا، مؤكدًا أن النقد الأدبي كان يدرس الأنساق منذ قرون، بدءًا من الجرجاني وابن قتيبة، وحتى الدراسات الحديثة التي حللت الغزل، المديح، صورة المرأة، وغيرها من الظواهر الأدبية بوصفها أنساقًا ثقافية. في نقطة لافتة، يُضيء البازعي على العلاقة بين الناقد والسلطة من خلال مثال شوقي ضيف، الذي عدّل طبعة كتابه "دراسات في الشعر العربي المعاصر" بعد ثورة يوليو، ليُبرز شاعرية حافظ إبراهيم المقاوِمة. يرى البازعي أن هذا التعديل لم يكن تزييفًا، بل شكلًا من أشكال المقاومة النقدية الهادئة.
ينفي البازعي الاتهام الشائع بأن النقد الأدبي حبيس المجازات والصور فقط، مشيرًا إلى أن النقد الواقعي، النفسي، التاريخي، وحتى الماركسي، كلّها مناهج نقدية تُعنى بالمضامين والمضمرات، وتستطيع تحليل النصوص في سياقاتها الثقافية والاجتماعية والسياسية. في ختام اللقاء، يُجدّد الدكتور سعد البازعي موقفه وهو أنه لا مانع من نقد الثقافة، بل هو مطلوب وضروري، لكن لا ينبغي ادعاء استقلالية وهمية لحقل لم يُنتج أدواته بعد. إن أراد مناصرو النقد الثقافي تأسيس حقل جديد، فعليهم أن يقدّموا مفاهيم، ومصطلحات، ومناهج واضحة، وإلا فإنه يبقى تكرارًا بأسماء جديدة.
يعد هذا الكتاب واحد من أهم المراجع المعجمية في النقد العربي الحديث الذي صدر بعدة نسخ. يقدم الكتاب تعريفًا وافيًا ومبسطًا لأهم المصطلحات والمفاهيم النقدية المعاصرة، من البنيوية إلى ما بعد الكولونيالية، ومن نظريات التلقي إلى التفكيك. يتميز بمواكبة دقيقة لتحولات النقد الغربي، ويهدف إلى تمكين القارئ العربي من الانخراط الواعي في النقاش النقدي العالمي، دون الوقوع في الترجمة الحرفية أو التلقي السلبي.
في واحدة من أبرز محاضراته حول النظريات النقدية والتي أقيمت في جمعية الثقافة والفنون بتاريخ 10 يوليو 2024، استعرض الدكتور سعد البازعي نشأة الدراسات الثقافية وتداخلها المعقد مع النقد الأدبي. لم يكن الهدف من المحاضرة تأسيس حقل جديد، بل الكشف عن أفق نقدي جديد يتجاوز حدود النصوص "الرفيعة"، ويفتح المجال لفهم الثقافة بوصفها حياة يومية وتعبيرًا عن اللامرئي والمهمش.
يرى البازعي أن النقد الأدبي، في تقليده الكلاسيكي، اهتم بالنصوص الكبرى والمكرسة، وهو ما جعل من "الثقافة" حكرًا على فئة محددة من الأدباء والمفكرين. في المقابل، جاءت الدراسات الثقافية – التي نشأت في بريطانيا على يد مفكرين مثل ريموند ويليامز، ريتشارد هوغارث، وستيوارت هول – لتطرح أسئلة جديدة: من يملك الحق في تعريف الثقافة؟ وما علاقة المسلسلات، والإعلانات، واللباس، والأغاني الشعبية، برؤية المجتمع لنفسه؟ كان للنقد الأدبي، وفق البازعي، دورٌ تأسيسي في نشأة هذا الحقل، من خلال مهارات تحليل النص التي انتقلت من النصوص الأدبية إلى قراءة المجتمع بوصفه نصًا.
يشرح البازعي كيف انتقلت الدراسات الثقافية من قراءة الرواية والشعر إلى تحليل تفاصيل الحياة اليومية، من رموز اللباس إلى شعارات النوادي، ومن فن الجداريات الشعبية إلى ثقافة الشارع. ويرى أن الرواية، أكثر من غيرها، كانت القادرة على التقاط هذه التفاصيل الهامشية، مستشهدًا برواية الدحو لعبد الله بخيت التي ترصد ثقافة السجن والمدينة، بل وتوثّق تحوّلات شارع الوزير في الرياض بوصفه سردًا حضريًا لطبقات المجتمع، تتجاور فيه مقبرة عتيقة مع إعلان عن ساعة يابانية.
ينبه البازعي إلى أن غياب الدراسات الثقافية في العالم العربي – بوصفها حقلًا أكاديميًا مستقلًا – لا يعني غياب مادتها، فالرواية، كما يقول، "هي التي ترسم ملامح المهمّش"، لكن دون أن تُعامل منهجيًا كما تفعل الدراسات الثقافية الحديثة. ومن هنا، فإن نقد الأدب في صورته المتجددة مطالب بأن يتجاوز "البلاغة والجماليات"، لينفتح على الأسئلة العميقة حول الطبقة، والمعنى، والهوية، وهي الأسئلة ذاتها التي تتقاطع مع مشروع النقد الثقافي بوصفه امتدادًا أو تطورًا للنقد الأدبي، لا نقيضًا له.



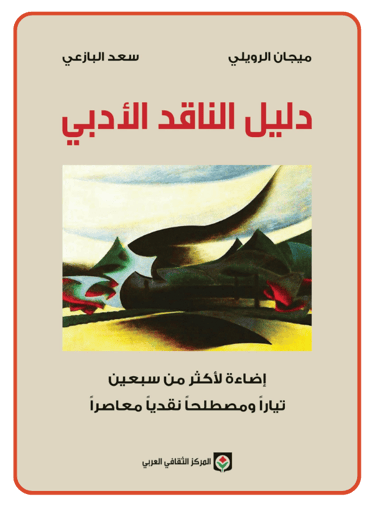
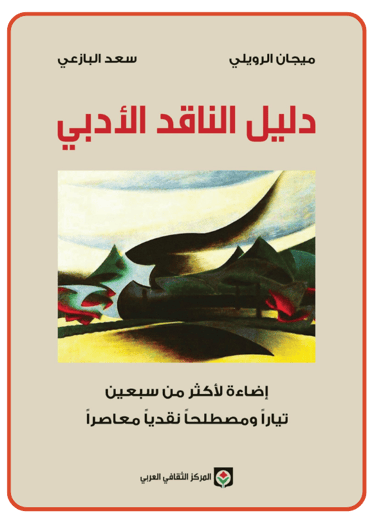
مقاربة الآخر: مقارنات أدبية (1999)
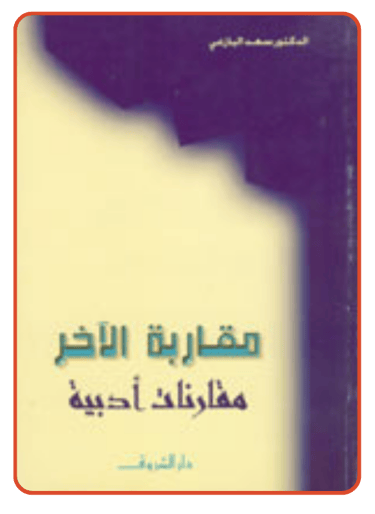
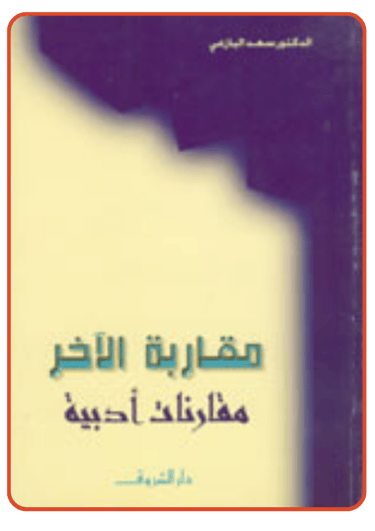
في محاضرته حول "النقد البيئي" بتاريخ 28 يوليو 2024، قدّم الدكتور سعد البازعي قراءة موسعة لهذا الحقل بوصفه امتدادًا من امتدادات النقد الثقافي، مشيرًا إلى أن النقد الذي يستحق هذا الاسم هو ما تجاوز كونه ممارسة مهنية إلى التزام معرفي وإنساني أعمق. أوضح أن النقد البيئي، رغم انطلاقه من صلب الأدب، لا يقتصر عليه، بل يتقاطع مع الفنون التشكيلية والسينما، ويتغلغل في الأسئلة الكبرى حول علاقة الإنسان بالطبيعة، وحضور الكائنات غير البشرية في الأعمال الفنية، وتمثيلات البيئة بوصفها كيانًا مستقلًا لا مجرد خلفية لخدمة الإنسان.
تتبع البازعي نشأة هذا النقد في الغرب، انطلاقًا من ردّات الفعل الرومانسية ضد الثورة الصناعية، مستعرضًا حضور الطبيعة في الأدب الأوروبي ثم الأمريكي، حيث برزت أعمال مثل "والدن" لثورو بوصفها نصوصًا مؤسسة لهذا التيار. وانتقل إلى تأملات نقدية في الرواية العربية، مستشهدًا بروايتي البحريات ومسرى الغرانيق لأميمة الخميس، وناقة صالحة وأسفار مدينة الطين لسعود السنعوسي، مبينًا كيف تكشف هذه النصوص عن تباينات عاطفية ومعرفية في تمثيل البيئات الصحراوية والبحرية وعلاقة الإنسان بالحيوان.
كما عرض نماذج من الفن التشكيلي، مثل أعمال عبد الجبار اليحيى ومحمد السليم، التي تُجسّد تآلف الإنسان مع بيئته أو تمثّل الأمل في استيقاظ العملاق الصحراوي، مقابل الرؤية العنيفة والرهبة التي تظهر في لوحات تيرنر. وفي السينما، توقّف عند فيلم بس يا بحر باعتباره وثيقة بصرية لصراع الإنسان مع البحر، وفيلم ران الياباني كمثال على دمج الطبيعة المهددة بالعنف ضمن البنية السردية والفنية.
واختتم البازعي بالإشارة إلى البعد السياسي للنقد البيئي، لا سيما في السياق ما بعد الكولونيالي، منبهًا إلى علاقة الاستعمار بتدمير البيئات الطبيعية، سواء في إفريقيا أو الهند أو فلسطين. وأشاد بكتاب "منح الحجارة صوتًا" بوصفه مثالًا على توظيف النقد البيئي في الدفاع عن القضايا العادلة. كما أشار إلى تنامي هذا الحقل عربيًا، وصدور دراسات سعودية حديثة عنه، مؤكدًا أن النقد البيئي لا يبحث عن الجماليات فقط، بل يضيء المسكوت عنه في علاقة الإنسان بعالمه، ويفتح زوايا جديدة لإعادة قراءة الأدب والفن بوصفهما حوارًا متوترًا مع الطبيعة.
جدل النقد الثقافي
سياسات النقد الأدبي
دليل الناقد الأدبي (1995)
يرتكز هذا الكتاب على رؤية تنطلق من التقاطع الثقافي في الأدب، حيث يسعى البازعي إلى تفكيك الحدود المغلقة للنصوص من خلال دراسات مقارنة تربط بين سياقات متباينة. يرى أن الآخر الثقافي لا يشكل تهديدًا، بل فرصة لاكتشاف الذات من خلاله. المقارنات التي يطرحها تجمع بين أدباء من العالم العربي والغرب، وتبحث عن الجذور الجمالية والدلالية التي لا تظهر إلا عبر الانفتاح النقدي.
استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث (2004)
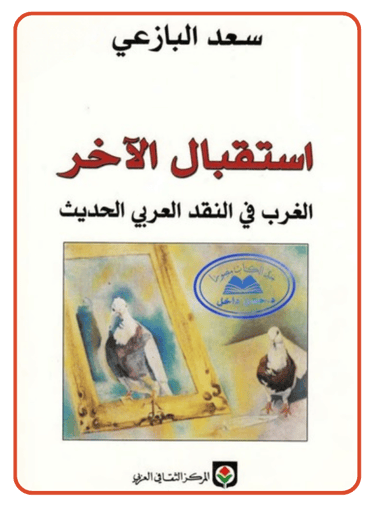
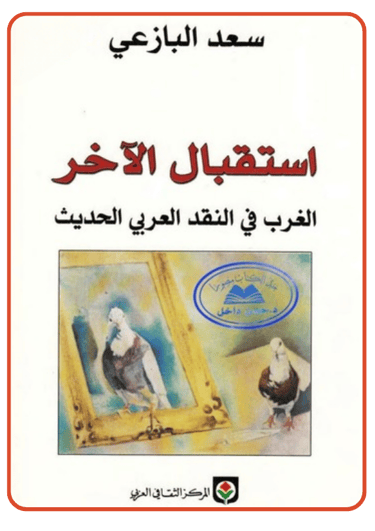
كتاب يقع في حقل نقد النقد، ويعالج إشكالية التلقي العربي للمناهج الغربية في النقد الأدبي. يتتبع فيه البازعي كيف تعامل النقاد العرب مع الغرب بوصفه مرجعًا ثقافيًا، وأحيانًا قبلته. ينتقد حالات التهالك النظري، ويقترح بديلاً يقوم على المثاقفة الواعية لا على التبعية. ينقسم الكتاب إلى قسمين: الأول يناقش مفهوم "الآخر" في النقد الغربي، والثاني يستعرض أبرز ملامح النقد العربي الحديث وتفاعله مع هذا الآخر حتى نهاية التسعينيات.
النقد والمقاومة (2024)
يتناول هذا الكتاب الأدب من زاوية التحرر والممانعة، ويبرز دور النقد في تفكيك السلطة والهيمنة من خلال تحليل الأعمال الأدبية. يشتبك البازعي مع نقد ما بعد الاستعمار، ويستعرض كتابات تناضل من أجل الهوية أو العدالة أو الحرية، كما يتوقف عند روايات وأشعار تحمل همًّا إنسانيًا أو سياسيًا. يوسع الكتاب فهم "المقاومة" لتشمل كل موقف نقدي واعٍ ضد الاستلاب أو التسلط، سواء كان ذلك في السياسة أو الثقافة أو حتى اللغة.
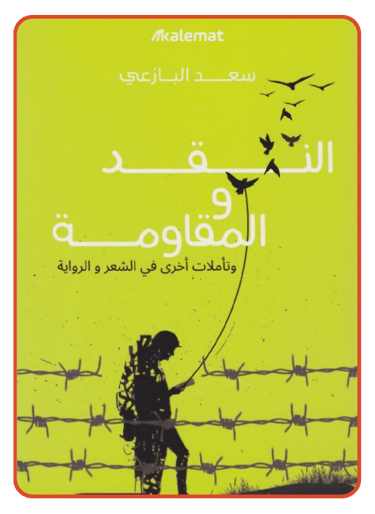
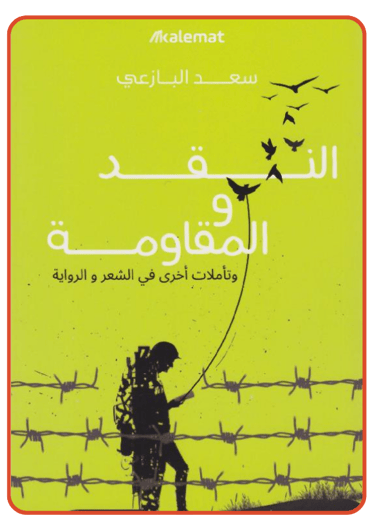
في لقائه على برنامج فكر وقلم على قناة الشارقة بتاريخ 20 يوليو 2025، تناول الدكتور سعد البازعي جملة من القضايا النقدية المثيرة، من أبرزها المقولات الحداثية التي راجت حول "موت المؤلف" و"موت الناقد". فعن الأولى، يرى البازعي أن مقولة رولان بارت الشهيرة لا ينبغي التعامل معها كمسلّمة، بل كموقف نقدي ضمن سياق نظري محدد. فمعرفة المؤلف – برأيه – لا تزال ضرورية في فهم كثير من جوانب النص، خاصة في المناهج التي تعتمد على السيرة أو التحليل النفسي. وهو يرفض الفصل الحاد بين النص وصاحبه، ويعتبر أن القول بموت المؤلف لا يعكس حقيقة الممارسة النقدية التي ما زالت تستند إلى حياة الكاتب وسياقاته لفهم العمل الأدبي.
أما عن "موت الناقد"، فيؤكد البازعي أن ما يواجهه الناقد اليوم ليس موتًا بل تحوّل في الحضور. فبينما تراجع النقد العميق في الإعلام العام ومنصات الثقافة الجماهيرية، ظل حاضرًا ومؤثرًا في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الثقافية. ويرى أن تراجع النقد في الإعلام لا يلغي الحاجة إلى الناقد، بل يؤكد أهميته في زمن كثرت فيه الانطباعات وتراجعت المعايير. الناقد، بحسب البازعي، هو منتِج للمعنى، وليس مجرد مُصدِر لأحكام أو قارئ مسطّح للنصوص.
وبين هاتين المقولتين – "موت المؤلف" و"موت الناقد" – يضع البازعي تصورًا متوازنًا يعيد الاعتبار للدورين في آن. فالنص لا يُكتب في فراغ، بل يتشكل في تفاعل دائم بين وعي المؤلف وسياقه، وبين تأويل المتلقي وما يقدّمه الناقد من قراءة مُؤسَّسة. يرى أن هذه المقولات الحداثية لم تُلغِ الأدوار، بل أعادت تشكيلها: فالمؤلف لم يعد سلطة مطلقة، والناقد لم يعد قاضيًا منزّهًا، بل كلاهما شريك في إنتاج الدلالة. وهي، كما يقول، ليست نهاية للمؤلف أو الناقد، بل بداية لنصٍ يُقرأ بوعي متعدّد، لا بصمتٍ معزول.
النقد البيئي: الطبيعة ككائن مستقل في الأدب والفن
في محاضرته الموسّعة بعنوان "سياسات النقد الأدبي"، التي ألقاها الدكتور سعد البازعي ضمن فعالية مشتركة نظمها ملتقى "باحثون" والملتقى الثقافي بتاريخ 15 نوفمبر 2017، عاد البازعي إلى إحدى أكثر الإشكاليات حساسية في الخطاب النقدي العربي ، وهي علاقة النقد بالإيديولوجيا، أو ما سمّاه بـ"السياسيات" – مقابل المصطلح الشائع "السياسات" – كترجمة دقيقة لمصطلح politics حين يُستخدم في سياق الحقول المعرفية. وقد ميز البازعي بين السياسات بوصفها مجموعة استراتيجيات رسمية واضحة، والسياسيات بوصفها ممارسات خفية وغير معلنة، تتجلى في الخطاب الثقافي والنقدي حين يتورط الناقد – بوعي أو بغير وعي – في تبنّي مواقف منحازة تؤطر قراءاته وتحكم أحكامه.
ينطلق البازعي من فرضية أن النقد الأدبي لم يكن يومًا نشاطًا معرفيًا بريئًا أو محايدًا تمامًا، بل هو – شأنه شأن أي ممارسة إنسانية – محكوم بالسياقات الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويستبطن مصالح وتحيزات وأهواء قد لا تكون ظاهرة على السطح، لكنها تشكّل جوهر التلقي والتأويل. فالنقد ليس مجرد كشف عن جماليات النص أو تفكيك لبنيته، بل هو أيضًا خطاب يشارك في تشكيل الثقافة، بل في توجيهها أحيانًا. وفي هذا الإطار، يُقارب البازعي السياسيات لا بوصفها انحرافًا طارئًا على النقد، بل كعنصر متأصل فيه، يتطلب وعيًا نظريًا ورقابة ذاتية مستمرة.
استعرض البازعي مجموعة من النماذج النقدية التي مثّلت بوضوح تداخل الإيديولوجي بالنقدي، وبدأ من الغرب، حيث تناول كتابات إدوارد سعيد، لا سيما مقاله الشهير عن "النقد اليساري الأمريكي" وكتابه العالم والنص والناقد، باعتبارها نماذج لنقدٍ مسيّس، لكنه واعٍ بموقفه السياسي، يستخدم الأدب أداة لمساءلة الخطاب الإمبريالي ومقاومة الهيمنة الثقافية. وعلى الطرف المقابل، استعرض موقف إعجاز أحمد في كتابه In Theory، الذي انتقد سعيد ونقّاد ما بعد الاستعمار بوصفهم منغمسين في امتيازات الغرب، مع استمرارهم في ادعاء تمثيل "العالم الثالث". هذه المفارقة بين خطاب يتبنى قضية عادلة ويؤدلج النقد لصالحها، وآخر ينقض هذا الخطاب باسم الكشف عن التناقضات البنيوية فيه، شكّلت عند البازعي خلفية لتأمل تعقيدات السياسيات داخل الحقل النقدي. ثم انتقل البازعي إلى المشهد العربي، ليحلل ثلاثة نماذج عربية بارزة مثل محمد لطفي اليوسفي، وكتابه فتنة المتخيل، الذي يُهاجم فيه رموز الحداثة العربية، مثل أدونيس، بوصفهم مروّجين لرؤية قمعية ومؤدلجة للتاريخ الأدبي العربي، لكنه في المقابل – كما يرى البازعي – يقع هو نفسه في خطاب مؤدلج لا يقل حدّة، يستخدم مفردات عالية التسييس من قبيل "المؤامرة" و"المكائد" و"الاندساس".
كذلك أمينة غصن، وكتابها نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقافة، حيث تنتقد من وصفتهم بـ"النقاد الذكور" وتخضع خطاباتهم لتحليل صارم، لكن دون أن تخضع خطابها الشخصي لنفس المعايير، ودون أن تعترف بتأثرها بالخطاب الغربي ما بعد البنيوي، لا سيما مفاهيم الخطاب والتفكيك. أما شوقي ضيف، في طبعة 1959 من كتابه دراسات في الشعر العربي المعاصر، التي يرى البازعي أنها جاءت كردّ ضمني على سياسات عبد الناصر بعد التأميم، مستخدمًا صورة حافظ إبراهيم وخليل مطران بوصفهما أصواتًا وطنية ترفض الاستبداد. في هذا النموذج، يرصد البازعي كيف يمكن للناقد المحافظ، الذي لم يُعرف بتسييس خطابه، أن يُقحم السياسة في قراءته الأدبية ضمن ظرف تاريخي معين.
لكن البازعي لا يتوقف عند الرصد، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك مفهوم التحيّز النقدي ذاته. فهو لا يرى أن التحيّز في النقد أمر مذموم دائمًا، بل يعتبره أمرًا لا مفر منه، لأن الناقد يتفاعل مع النص من خلال تكوينه المعرفي، وخلفياته الثقافية، ورؤيته للعالم. غير أن المشكلة – كما يقول – تكمن في غياب الوعي بهذه التحيزات، أو ادعاء الموضوعية الكاملة. فالمطلوب هو التحيّز الواعي، التحيز الصادق، الذي يعترف بموقعه وبمرجعيته وبالمنطلقات التي ينطلق منها، دون ادعاء "نقاء" نقدي أو علمية زائفة.
وفي ختام المحاضرة، دعا البازعي إلى مثاقفة نقدية واعية، تنطلق من فهم دقيق للمفاهيم المستوردة، وإدراك لتجذرها الفلسفي في ثقافاتها الأصلية، ومن ثمّ إعادة تشكيلها داخل السياق العربي، لا عبر النقل الحرفي أو الرفض الكامل، بل عبر التفاعل الإبداعي الذي يُنتج قراءة عربية أصيلة، تعرف ذاتها كما تعرف الآخر، وتُدرك أن النقد ليس فقط ما نقوله عن النص، بل ما يقوله النص عنّا حين نقرأه.
هذه المحاضرة تُعد من أكثر محاضرات البازعي كشفًا لتفكيره النقدي من الداخل، ولحساسيته العالية تجاه العلاقات الخفية بين المعرفة والسلطة، والتأويل والمصلحة، والناقد والنص. وهي تقدم إضافة نوعية لفهمه العميق لماهية النقد، وحدوده، ومسؤوليته في العالم العربي المعاصر.
نظريات الهامش وتحولات الخطاب النقدي
ضمن ورقة نقدية ألقاها في الملتقى الثقافي بالرياض بتاريخ 07 نوفمبر 2018، قدّم الدكتور سعد البازعي مراجعة تأملية لما أسماه "نظريات الهامش"، متتبعًا تحوّلات النقد الأدبي المعاصر في ضوء النظريات التي نشأت خارج المركز الأكاديمي التقليدي، مثل دراسات ما بعد الاستعمار، النسوية، الإعاقة، ما بعد الإنسانوية، والنقد البيئي. وأوضح البازعي أن هذه التيارات لم تأتِ استطرادًا أو ترفًا نظريًا، بل كانت غالبًا ردود فعل على تهميش مزمن، أو نابعة من معاناة وجودية عاشها أصحابها، كما في حالة فوكو أو إدوارد سعيد. ومن هنا رأى أن التحول النقدي الأبرز منذ ستينيات القرن الماضي تمثل في زحزحة المركز، وتحويل الاهتمام من البنية الجمالية المجردة إلى الخطاب الثقافي المهمّش.
لم يكتفِ البازعي بالتأطير الفلسفي، بل قدّم أمثلة تطبيقية من الشعر والرواية العربية، مقارنًا بين الصورة المثالية للمرأة في قصائد نزار قباني وصورة المرأة العادية أو المعاقة في قصائد وليد خزندار، ليدلّل على نقد الجماليات المألوفة. كما استعرض روايات مثل الآخرون لصبا الحرز والطلياني لشكري المبخوت بوصفها أعمالًا تسائل السلطة الأخلاقية والثقافية السائدة. وفي تعليقه على هذه النظريات، نبّه البازعي إلى ضرورة تحليل النصوص العربية بمرجعية نقدية تراعي خصوصياتها، محذرًا من خطر التماهي الكامل مع أدوات نقدية غربية ولدت في سياقات مختلفة.
في هذا السياق، يعكس خطاب البازعي انتقال النقد الأدبي من كونه تحليلًا لجماليات النص إلى كونه تفكيكًا للأنساق، ورصدًا للتمثيلات، ومحاورةً للسلطة والهوية والمعرفة. ومن خلال حديثه عن "نظريات الهامش"، يبرز مدى انشغاله بتحرير النقد من ثوابته القديمة، وتجديد عدّته المفاهيمية بما يواكب أسئلة الثقافة والمجتمع.
ي ختام هذا الفصل، يتبدّى لنا أن مشروع الدكتور سعد البازعي في النقد ليس مجرد تراكم قراءات أو تطبيق نظريات، بل هو مسار فكري متوتر، يعيد مساءلة ذاته باستمرار. فمنذ لحظة انخراطه في المشهد الثقافي، مرورًا بتجربته الأكاديمية الطويلة، ووصولًا إلى مداخلاته الفلسفية حول النظريات والمناهج، ظل البازعي واعيًا بحدود ما نمارسه من نقد، وبالإمكانات التي يتيحها عندما يتحرّر من أسر التكرار والتقليد. يتحرك نقد البازعي في حقل متشظٍّ، لا يطمئن إلى يقين واحد، بل ينفتح على أسئلة تتكاثر: عن اللغة، والهوية، والمضمر، والسلطة، والبيئة، والهامش، والسياسات الخفية التي تشكّل ما نقرأه وما نكتبه. وهو إذ يُبدي حذرًا من غواية "النقد الثقافي" بوصفه حقلًا فضفاضًا، فإنه لا يرفض أسئلته، بل يدعو إلى تعميقها وتأصيلها منهجيًا، بما يعيد الاعتبار للنقد الأدبي لا كممارسة جمالية فقط، بل كأداة لفهم الإنسان وثقافته.
في تصور البازعي، لا يعود النص مجرد موضوع للتحليل، بل فضاء لتقاطع القوى، وميدانًا يتجاور فيه المؤلف والناقد والقارئ، ويُعاد فيه بناء المعنى عبر الحوار لا الحكم. يتبنّى موقفًا نقديًا قائمًا على الوعي بالموقع، لا على ادعاء الموضوعية، ويجعل من الانحياز الواعي شرطًا للقراءة الصادقة، لا آفة ينبغي التخلص منها. لقد أعاد البازعي الاعتبار للناقد بوصفه مثقفًا عضويًا لا مجرد شارح أو مُصنّف، مثقفًا يعي أن كل تأويل يحمل أثرًا، وأن كل قراءة تترك ندبة في جسد النص. وبين مراجعة المناهج، واستعادة النظريات، وتفكيك المفاهيم، ينهض مشروعه على توتّر دائم بين الحذر المعرفي، والجرأة الفكرية، ليؤكد أن النقد، في جوهره، ليس قولًا عن النص فقط، بل قولًا عن ذواتنا حين نقرأ، وعن العالم كما نراه ونخوضه.
خاتمة الفصل: بين مساءلة المنهج وتحرير النقد
النقد الأدبي والدراسات الثقافية: من الأدب الرفيع إلى ثقافة الهامش
بين موت المؤلف وموت الناقد: عودة الوعي بالنص
وعي نقدي بمحدودية المناهج والنظريات
في محاضرته حول "مفهوم النظرية والمنهج" التي ألقاها في جمعية الثقافة والفنون بتاريخ 06 يونيو 2024، قدّم الدكتور سعد البازعي مراجعة نقدية عميقة لأدوات التفكير النقدي نفسها، منبهًا إلى أن كثيرًا من القراء والباحثين يتعاملون مع مفاهيم مثل "المنهج" و"النظرية" وكأنها أدوات صمّاء ومحايدة، بينما هي في حقيقتها محمّلة بإرث فلسفي وثقافي طويل، ومرتبطة بسياقاتها التاريخية والميتافيزيقية.
لم تكن المحاضرة درسًا تقنيًا في تصنيف المناهج، بل دعوة إلى إعادة التفكير في الأسس المعرفية للنقد نفسه. فالبازعي يرى أن كل منهج يحمل في داخله رؤية للعالم، وكل نظرية تتكئ على افتراضات أيديولوجية قد لا يعيها الناقد. واستنادًا إلى أمثلة فلسفية ونقدية من أرسطو وابن سينا إلى فوكو وتوماس كون وإدغار موران، شدد على أن صرامة المنهج لا تضمن الحقيقة، كما أن انسجام النظرية لا يعني اكتمالها.
ما يميز هذا الطرح هو الوعي النقدي الذي يمارسه البازعي على النقد ذاته، حيث يفضّل الانغماس في النصوص على الجمود النظري، ويحث على استخدام المناهج لا كقوالب جاهزة بل كأدوات مرنة تخضع للفهم لا للتقديس. ومن هنا تتكامل هذه المحاضرة مع مشروعه الأوسع في الدفاع عن النقد الأدبي كممارسة إنسانية تتسم بالتعدد والانفتاح، لا كمنظومة دوغمائية تسعى إلى السيطرة على النص.
تحدّث الدكتور سعد البازعي في برنامج وجوه من الخليج، بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٥، عن نفسه كما لم يتحدث من قبل، في حوار اتّسم بالهدوء والبساطة والصدق الشخصي. ترك وراءه مؤقتًا مشروعاته الفكرية ونظرياته النقدية، ليكشف للمشاهدين عن تفاصيل نادرة من يومياته، وملامح صوته الداخلي، ومساراته العائلية والثقافية التي صاغت رؤيته للعالم. في هذا اللقاء، كان التركيز على الجانب الشخصي حاضرًا بوضوح: من طفولته المبكرة التي بدأت مصادفة في القريات شمال المملكة، حيث ولد في بيت خاله أمير المدينة آنذاك، إلى عودته إلى الرياض في سن الثالثة، المدينة التي احتضنت ذاكرته الأولى، وصاغت حواسه الأولى تجاه اللغة والمكان. روى البازعي كيف أثّر عليه والده وأخوه الأكبر محمد، ثم أخ غير شقيق وجّهه لقراءة الأعمال الأدبية الكبرى مثل «الجريمة والعقاب» وأدبيات الفكر الماركسي، وهي قراءات مبكرة صنعت نواته النقدية الأولى. كما أضاء على عاداته اليومية؛ استيقاظه المبكر عند الخامسة صباحًا، لحظات القهوة الصباحية، وقطعة الشوكولاتة الداكنة التي لا يتنازل عنها، وجلوسه لساعات في مكتبته بين الكتب، وحده، بهدوء كامل. أظهر اللقاء صورة مثقفٍ متفرّغ بالكامل للمعرفة، يعيش خارج دوائر الانشغال اليومي، بلا أعباء منزلية، متأملًا، قارئًا، ومترجمًا. تحدث عن ابنته علياء، الفنانة التشكيلية، وكيف حاولت الربط بين الفن البصري وعالم الكتب، متأثرة ببيئة بيتها المشبعة بالثقافة والفكر. كما لم يخلُ اللقاء من لمسات وجدانية، حين تحدّث البازعي عن شعوره بالغربة داخل الرياض الحديثة التي لم تعد تشبه المدينة التي عرفها في صباه. تغيّرت الأحياء، تغيّر الناس، وبقيت الذاكرة فقط ترافقه في جولات متقطعة مع زوجته إلى الأماكن القديمة. في وجوه من الخليج، لم يكن البازعي ناقدًا ولا محاضرًا، بل كان إنسانًا يروي نفسه: مزيجًا من العزلة والعطاء، من الترحال والحضور، من الصحارى الرمزية والحواضر الثقافية. لقاء كشف عن "وجهه الآخر"، الذي يُضيء كثيرًا مما خفي في كتبه ومحاضراته.
الذات
في عام 2000، وفي مرحلة مبكرة من حضوره الإعلامي، قدّم الدكتور سعد البازعي واحدة من أكثر إطلالاته التلفزيونية عمقًا عبر برنامج "ما بين أيديهم" مع الإعلامي محمد رضا نصرالله على شاشة التلفزيون السعودي. جاء هذا اللقاء في وقت كانت تتبلور فيه ملامح نقد جديد داخل المملكة، ويشكّل حينها توثيقًا أوليًا لتحوّلات سعد البازعي الفكرية والنقدية. تحدّث فيه عن رحلته من كتابة الشعر إلى دروب النقد الصارم، مشيرًا إلى أن تجربته الأكاديمية في الولايات المتحدة ساهمت في تفكيك لغته الشاعرية لصالح لغة تحليلية دقيقة، وأن بداياته في الترجمة الأدبية كانت بمثابة البذرة الأولى لتكوينه النقدي. كشف البازعي في هذا الحوار عن رؤيته الناشئة لما سيُعرف لاحقًا بمشروعه النقدي الممتد، فناقش مفهوم "ثقافة الصحراء" وتوقف عند لحظة فارقة حين طُلب منه – وهو في أمريكا – الكتابة عن الأدب السعودي، فكانت تلك الدعوة نقطة تحوّل جعلته يرى الأدب المحلي من منظور الباحث لا المتابع. اللقاء لم يكن مجرد بوح شخصي، بل كان تمرينًا أوليًا على التفكير النقدي الممنهج، ظهرت فيه البدايات الأولى للخطاب الذي سيتبلور لاحقًا في كتبه ومقالاته، خطابٌ يزاوج بين الأدب والنقد الثقافي، بين النص وسياقه، وبين المحلي والعالمي.
يُعد هذا اللقاء من أوائل إطلالات الدكتور سعد البازعي التلفزيونية في التسعينات، وقد مثّل لحظة مبكرة لصوته النقدي في المشهد الثقافي السعودي، حيث شارك في برنامج "وجهًا لوجه" على القناة السعودية، ضمن إحدى دورات مهرجان الجنادرية، إلى جانب الدكتور مرزوق بن تنباك والأستاذ عثمان الخزيم. دار النقاش حول مكانة الشعر الشعبي، والعلاقة بين بين الفصحى والعامية، والذوق العام، ودور المهرجان في الاحتفاء بالموروث الثقافي. وقد اتّسم حضور البازعي بنبرة متزنة، لا تنطلق من موقع الصراع أو الدفاع، بل من رغبة واعية في إضفاء بعد نقدي على ما يُقدَّم من شعر، وطرح أسئلة جمالية وفكرية تتجاوز الانبهار السطحي. وفي سياق مداخلته، قرأ البازعي مقطعًا للشاعر فهد عافت كنموذج على الحداثة الشعرية الممكنة في القصيدة النبطية، مؤكدًا أن نقد الشعر الشعبي لا يُقصد به النفي أو الإقصاء، بل الفهم والتقييم، وأن تثقيف الذائقة هو المشروع الحقيقي الذي ينبغي أن يُعطى الأولوية. هكذا ظهر صوت البازعي في التسعينات ناقدًا متفهمًا، لا يستسلم للرومانسية الشعبية ولا ينغلق في برج الفصحى العاجي، بل يدعو إلى مساءلة الشعر أيا كان لونه، وإلى احترام التعدد دون تفريط بالهوية اللغوية.
في عام 2000 أيضاً، استضاف الإعلامي محمد العوين الدكتور سعد البازعي في برنامج مراجعات ثقافية، لمناقشة كتابه المشترك مع الدكتور ميجان الرويلي دليل الناقد الأدبي. خلال اللقاء، قدّم البازعي صورة واضحة لنفسه كناقد يتحرّك خارج التصنيفات الصارمة للمدارس النقدية. قال بوضوح إنه لا يصنّف نفسه ضمن أي تيار نقدي بعينه، ولم يفكر يومًا أن يكون بنيويًا أو تفكيكيًا أو واقعياً. هو لا يذهب إلى النص بنية إخضاعه لنظرية، بل يقرأه من منطلق تكوينه الثقافي، ووعيه الخاص، وانشغالاته الفكرية. وأكّد أن دخول الناقد في تيار معين يجب أن يكون نتيجة تفاعل حي مع النص، لا تقليدًا لموضة نقدية أو تماشياً مع اتجاه شائع. وعندما تأمل مسيرته، اكتشف أنه ينحو غالبًا منحى اجتماعيًا تاريخيًا، لا بوصفه قرارًا واعيًا، بل لأن هذا المنحى ينسجم مع طريقته في قراءة الأدب وفهمه. كما عبّر عن رفضه لما سماه "نقد الموضة"، حيث ينتقل بعض النقاد العرب من البنيوية إلى التفكيكية ثم إلى النقد النفسي وفق الموجة الرائجة، دون امتلاك موقف نقدي راسخ. ووصف هذا التقلّب بأنه علامة على هشاشة فكرية وغياب الرؤية الذاتية الصلبة. في تلك الحلقة، لم يكن البازعي يعرض أفكارًا نظرية فحسب، بل كان يرسم بورتريهًا دقيقًا للناقد الذي يسعى أن يكونه: ناقد حرّ، لا يخضع لهيمنة المصطلح، ولا يذوب في الأنساق، بل يتعامل مع التيارات بوصفها أدوات لا مقدسات.



في لقاءين بارزين يفصل بينهما خمس سنوات، فتح الدكتور سعد البازعي نوافذ ذاته الفكرية والإنسانية أمام الإعلامي عبد الله المديفر، الأول في ١٣ مارس ٢٠١٥ عبر برنامج لقاء الجمعة، والثاني في ٣ مارس ٢٠٢٠ من خلال برنامج في الصورة. كلا اللقاءين شكّلا محطتين فريدتين في بوح البازعي، وعبّرا عن تدرجه من التأمل في دور المثقف السعودي ومآزقه الاجتماعية، إلى استبطان أعمق لإشكالات الترجمة والهوية وأسئلة اللغة. في ظهوره الأول، تحدّث البازعي بثقة هادئة عن الفجوة بين النخبة الثقافية والمجتمع، وعن إخفاق المثقف في مدّ الجسور مع جمهوره، مشيرًا إلى تجاربه الشخصية التي تكشف ضعف التلقي، إلا إذا ارتبطت الثقافة بأسماء شعبية أو عناوين مثيرة. لم يتعالَ في الطرح، بل حمّل المثقف جزءًا من المسؤولية، مؤكدًا على ضرورة أن يكتب "للناس"، دون أن يتخلى عن أدواته المعرفية. أما في لقائه الثاني، فقد بدا البازعي وقد غاص في قضايا أكثر تركيبًا: الترجمة كأداة حضارية، الشعر كلغة مستحيلة الترجمة، غياب المترجم خلف النص، جغرافية المعنى، والكتابة بلغة غير الأم. تحدث لا بوصفه ناقدًا وحسب، بل كمفكر يراجع أدواته، ويناقش مصير النصوص حين تُنقل بين الثقافات. هذان اللقاءان يكشفان معًا عن البازعي الإنسان: متأمل، ناقد لنفسه وبيئته، مؤمن بدور المثقف وإن عاتبه، ومتشبث برؤى تتطور مع الزمن دون أن تفقد ثوابتها النقدية. هما شهادتان على الذات المفكرة حين تواجه الإعلام والجمهور والمفاهيم الكبرى في آن واحد.
البازعي في التسعينات ناقدًا للشعر الشعبي
خاتمة: الذات كما رآها البازعي وكما رآها الزمن
شهادة الميلاد النقدية: البدايات التلفزيونية
من إضاءات إلى مخيال: البازعي في عقدين من التحوّل
في ٢٠٠٥، وقف الدكتور سعد البازعي أمام عدسة برنامج "إضاءات" ممسكًا بخيوط ذاته بحذر، ناقدًا دوره كمثقف من الداخل، موزّعًا الشك واليقين بين موقع الأكاديمي المتردد والمثقف الملزم بالمواقف. بعد عشرين سنة، في برنامج "مخيال رمضان"، يعود البازعي إلى الكاميرا نفسها، لكن بوجه مختلف: أكثر هدوءًا، أقل دفاعًا، وأكثر رغبة في التفسير منه في التبرير. ما تغيّر؟ وما بقي على حاله؟ في "إضاءات"، يقدّم البازعي نفسه كمثقف مشحون بالقلق، واعٍ بأن "مواقفه أتعبته"، محاصرٍ بين الانتماء لمجتمع محافظ، والتمرّد عليه من الداخل. أما في "مخيال رمضان"، فنلمح شخصية أكثر تصالحًا مع التوتر، لا تنفيه، لكنها لم تعد تدفع ثمنه الداخلي بنفس الحدة. يعترف بأنه ما يزال في "المنطقة الرمادية"، لكنه لا يرى ذلك ضعفًا، بل "طبيعة" و"تكوين"، ويذهب أبعد من ذلك: "أنا أميل إلى أن أخلق معرفة أكثر من أن أخلق موقفًا من المعرفة". في ٢٠٠٥، كان البازعي في قلب معركة الحداثة، يعيد تعريفها من الداخل، ويقف على الضد من بعض رموزها، خصوصًا الدكتور الغذامي، في لحظة بدا فيها المشهد النقدي السعودي كما لو كان يتشكل على وقع هذه الثنائيات. أما في ٢٠٢٥، فهو يتحدث من موقع الراصد، رئيس لجنة كبرى (جائزة القلم الذهبي)، اسمٌ أُطلق على شارع في الأحساء، ومثقف لا يبدو معنيًا بالصراعات الرمزية، بل بتقويمها من الأعلى، محذّرًا من تحوّل المشهد الثقافي إلى ساحة للفقاقيع السردية والنقدية. في "إضاءات"، بدا البازعي وكأنه يبرّر انخراطه في حركة الحداثة دون أن يتماهى معها، يقرّ بالمشاركة ويؤكد التحفظ. في "مخيال رمضان"، يتحوّل إلى شاهد على تلك المرحلة: يعترف أن الساحة شهدت "صراعات حقيقية"، وأنه كان من الأقل صدامًا، لكنه يوضّح أيضًا أن بعض خصومه لم يعرفوا أين يصنّفونه. اليوم، يعترف بأنه تأثّر بعبدالوهاب المسيري، وينتقد الإفراط في استيراد النظريات، بل يرى "التحيّز" مكوّنًا أصيلًا لأي قراءة نقدية. في ٢٠٠٥، كان صوت البازعي الشعري لا يزال حاضرًا، خاصة مع تاريخه في نقد الحداثة الشعرية. في ٢٠٢٥، يتحوّل الاهتمام إلى الرواية، لا من حيث بنيتها الفنية فقط، بل بوصفها عنصرًا من عناصر المشهد الثقافي العربي. يميز بوضوح بين الرواية "الجادّة" والرواية الفانتازية، ويخوض جدلًا علنيًا مع ظاهرة أسامة المسلم، مؤكدًا على حقه في الذوق، ورافضًا أن يُفرض عليه الإعجاب باسم "الشعبية". في "إضاءات"، ينأى البازعي بنفسه عن النخبوية، لكنه يعترف بأن خطابه ليس سهل التلقي. في "مخيال رمضان"، يبدو أكثر انخراطًا في سؤال الجمهور، يطالب بأن تكون الشوارع وسيلة تثقيف، يعبّر عن قلقه من ضياع الأجيال الجديدة في "الثقافة السطحية"، ويرى في الجوائز، مثل "القلم الذهبي"، وسيلة لإعادة بناء الجسور بين الإبداع والمتلقي. ربما كان الفارق الأكبر بين اللقاءين أن البازعي في ٢٠٠٥ كان يتحدّث بوصفه فردًا داخل ساحة متوترة، بينما في 2025 يتحدّث بوصفه شخصية مرجعية، يُسأل عن المشهد كله، ويُحمّل
من بين التجارب التي تكشف عن تمسّك الدكتور سعد البازعي برؤية المثقف المرتبط بمجتمعه، تأتي تجربة الملتقى الثقافي بوصفها أحد أبرز ملامح اشتغاله على تجسير الفجوة بين المؤسسة الأكاديمية والناس. ففي لقائه على شاشة تلفزيون الكويت ضمن برنامج صندوق بريد ١٩٣ بتاريخ ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣، تحدّث البازعي بصراحة عن رغبته في كسر الحاجز الذي يفصل الجامعة عن المجتمع، مؤمنًا بأن الثقافة لا تصنعها الصروح المغلقة وحدها، بل تتنفس من خلال التفاعل الحي مع جمهور متنوع. يقول البازعي إنه منذ سنوات طويلة يحرص على إقامة ملتقى ثقافي مفتوح يدعو إليه عبر وسائل التواصل، ويعلن عنه بوضوح للجميع، دون حواجز ولا نخبويات. لكن رغم الجهود، فإن الحضور لا يتجاوز غالبًا ٢٠ إلى ٢٥ شخصًا. بالنسبة له، هذه ليست مجرد أرقام، بل مؤشر دقيق على التحديات التي تواجه من يحاول الخروج من الدائرة الأكاديمية والانخراط في الفضاء العام. يرى البازعي أن المشكلة لا تكمن فقط في النخبة، بل في تصوّرات مسبقة راسخة لدى الناس أنفسهم، مثل الاعتقاد بأن الأندية الأدبية ليست سوى أماكن مخصصة لفئة بعينها. ولهذا، فإن تبديد هذه الصورة النمطية يتطلب جهدًا طويل النفس، ومثابرة لا تملّ من طرق الأبواب، ولو لم تُفتح بسهولة. تجربة الملتقى تُظهر جانبًا من الذات الثقافية للبازعي، تلك الذات التي لا تكتفي بالتنظير ولا تستقر في برجها العاجي، بل تتلمّس الطريق إلى الآخر، حتى لو كان الطريق موحشًا أحيانًا. إنه المثقف الذي لا يكتفي بدور المتلقي أو الشارح، بل يجرّب، يغامر، ويمدّ يده نحو الجمهور في كل مرة، ولو قابله الصمت.
مع المديفر: بين المثقف والذات
في تتبعنا لأثر الدكتور سعد البازعي عبر عقود من الحضور الإعلامي والثقافي، تتكشّف أمامنا ملامح ذات نقدية فريدة، لا تتوقف عن مراجعة نفسها ولا تنغلق على مرحلة أو تيار. من إطلالاته الأولى في التسعينات، ناقدًا شابًا يتلمّس طريقه بين الشعر الشعبي وقضايا الهوية، إلى ظهوره المتأمل في مطالع الألفية، حيث كان يعيد تشكيل لغته النقدية بعد تجربة أكاديمية صارمة في الغرب، ثم إلى لقاءاته الأحدث التي يكشف فيها عن وجهه الإنساني في أرقى تجلياته، ظل البازعي وفياً لما يسميه "معرفة الذات عبر الأسئلة"، تلك التي لا تحسم بقدر ما تنقّب. لقد عبّر البازعي عن نفسه بطرائق شتى: مرة عبر بوح وجداني كما في "وجوه من الخليج"، ومرة عبر مكاشفة فكرية كما في "لقاء الجمعة" و"في الصورة"، وأخرى عبر استعادة للماضي الشخصي كما في "مخيال رمضان"، أو عبر تفكيك تجاربه المؤسساتية في برامج مثل "صنوان" و"صندوق 193". ومع كل إطلالة، لا يقدّم نسخةً مكرورة من نفسه، بل ذاتًا تنمو، تتراجع، تتقدّم، وتُعيد التشكّل وفقًا لسياقها الزمني والثقافي. وما تزال هذه الذات الناقدة مستمرة في التعبير عن نفسها إلى اليوم، عبر لقاءات متجددة مثل "الشريك الأدبي" و"اثنينية البازعي"، وهي لقاءات تجمع بين العمق والحميمية، وتكشف عن شخصية مثقفة تُدير الحوار مع الآخر بنفس الشغف الذي تُدير به حوارها الداخلي. ومع إرثٍ كبير من اللقاءات على جميع القنوات التلفزيونية العربية، بات البازعي لا يُمثّل فقط مشروعًا نقديًا، بل سيرة فكرية حيّة تُضيء أطوار التحوّل في الثقافة السعودية، وتمنح "الذات" وزنها الكامل كعنصر من عناصر الفهم النقدي.
من الشورى إلى هيئة الأدب : محطات في سيرة المسؤول الثقافي
في برنامج صنوان بتاريخ 12 مارس 2022، قدّم الدكتور سعد البازعي قراءة شخصية لمسيرته العملية، متأملًا التحولات التي مرّ بها من الصحافة إلى العمل الثقافي ثم إلى الشأن العام، بوصفها مسيرة تنقلت بين التجريب والمسؤولية. بدأ الحديث من تجربة رئاسته لتحرير صحيفة الرياض ديلي في أواخر الثمانينات، تجربة وصفها بأنها "حساسة ومكثّفة"، إذ أخرجته من مناخ الجامعة إلى تحديات الصحافة اليومية، وأدخلته في منطقة تماس مباشرة مع الرقابة ومع التمثيل غير المقصود للدولة. ولأن الجريدة كانت تُقرأ في الخارج على أنها لسان رسمي، تحمّل مسؤولية مضاعفة، انتهت بانسحابه طواعية من المنصب بعد عامين فقط. ثم تحدّث عن مرحلة رئاسته للنادي الأدبي بالرياض، التي رأى فيها امتدادًا أكثر اتساقًا مع هويته الثقافية، لا سيما أنها أتاحت له المساهمة في صياغة مشروع جديد للنادي من خلال تنشيط الفعاليات وتأسيس برنامج نشر مشترك مع دور نشر عربية، بالشراكة مع الدكتور عبد الله الوشمي. اعتبر البازعي أن هذا التحوّل ربط النادي بالسياق الثقافي العربي، وأعاده إلى موقع فاعل في إنتاج المعرفة وتدويلها. أما عضويته في مجلس الشورى، التي بدأت عام 2009، فقد شكّلت بالنسبة له فضاء جديدًا لاختبار دور المثقف داخل المؤسسات الرسمية. أشار إلى أن المجلس مكّنه من الاطلاع على تفاصيل عمل الأجهزة الحكومية، وفتح له نافذة للتأثير عبر اللجان، ورفع التوصيات، والنقاشات المباشرة مع الوزراء. أكد على أهمية هذه التجربة في ترسيخ التمييز بين الدولة والحكومة، وهو تمييز يرى أنه مغيّب في وعي كثير من الناس، ويؤدي إلى خلط الأدوار والمسؤوليات. واختتم حديثه بالإشارة إلى موقعه الحالي في مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن الحراك المؤسسي الجديد لوزارة الثقافة. عبّر عن تفاؤله بهذه المرحلة، واصفًا إياها بأنها "فرصة غير مسبوقة لترسيخ ثقافة جديدة، أكثر انفتاحًا، وأكثر تنظيمًا، وأكثر قدرة على التأثير العميق"، مؤكّدًا أن دوره اليوم يُمارس من داخل مؤسسات تؤمن بالمثقف، لا تهمّشه.
بداية الناقد الأدبي المحترف
البازعي بين الجامعة والجمهور: الملتقى الثقافي نموذجًا
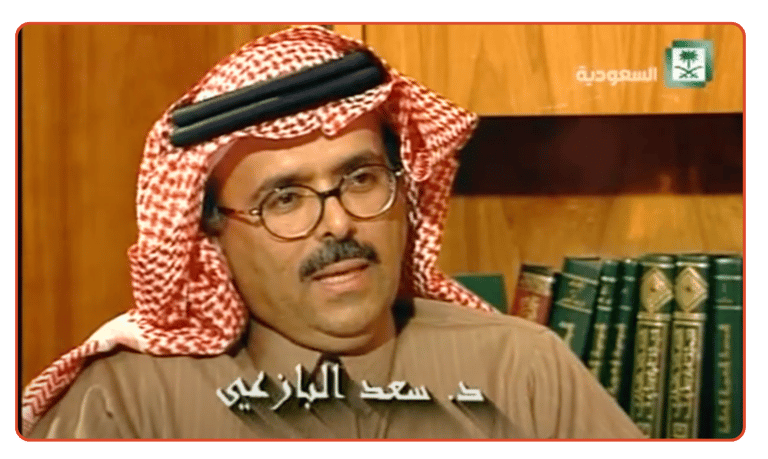
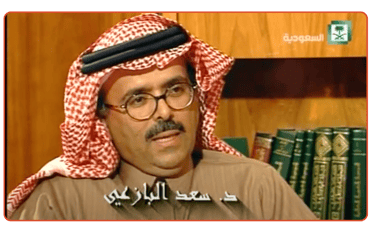








إذا كان من سمة تُميّز الدكتور سعد البازعي عن سواه من النقّاد والمثقفين، فهي حضوره الشفهي والكتابي المتكامل. فالبازعي ليس فقط مؤلفًا غزير الإنتاج، بل متحدث لا يكلّ؛ تجاوزت محاضراته المنشورة في يوتيوب وحدها أكثر من ٢٠٠ محاضرة موثقة، بينما تُقدّر لقاءاته غير المنشورة بأكثر من ٢٠٠ محاضرة أخرى. هذا الامتداد الزمني والمكاني يجعل من مشروعه الثقافي ليس مجرد مجموعة كتب أو أطروحات، بل سيرة فكرية حيّة تتشكل في القول كما في الكتابة، وفي الحوار كما في التأمل.
لقد تتبع هذا التقرير أبرز مسارات ذلك المشروع، من النقد الأدبي إلى الترجمة والمثاقفة، ومن الرواية إلى الفلسفة، مرورًا بمحطات متعددة في الاستشراق والمكون اليهودي والحداثة، وانتهاءً بما يمكن تسميته “الذات المفكّرة” في خطابه. واللافت في كل هذه المسارات أن البازعي لا يكرر نفسه، بل يعود إلى القضايا نفسها بزوايا جديدة، مستعينًا بخلفيته الفلسفية، وتجربته الأكاديمية، ووعيه النقدي العميق.
في تناوله للنقد، يظهر البازعي مؤمنًا بأن كل قراءة هي موقف، وأن الناقد لا ينفصل عن زمنه ولا عن لغته. وهو بذلك يعيد الاعتبار للنقد بوصفه فعلًا ثقافيًا لا مجرد تحليل أدبي. أما في دراساته للرواية، فقد منحها مكانة مركزية، معتبرًا إياها أفقًا لتحولات الوعي الحديث، ومساحة لطرح الأسئلة المرتبطة بالهوية والتاريخ والانتماء.
في الشعر، قدّم البازعي قراءة مزدوجة تجمع بين تقدير الجماليات والتفاعل مع الحمولة الثقافية للنص، بينما في الترجمة، نقل النقاش إلى مستوى فلسفي، يُعلي من شأن التأويل، ويرى في الترجمة فعلًا نقديًا لا نقلًا لغويًا فحسب.
أما المثاقفة، فقد طرحها بوصفها مشروعًا منفتحًا على الآخر دون ذوبان فيه، مؤمنًا بأننا لا نستطيع فهم ذواتنا بمعزل عن فهم ما يعاكسنا ويكملنا. وفي ملف الاستشراق والمكوّن اليهودي، ظهر البازعي مفكرًا عقلانيًا، يسعى إلى تجاوز الانفعالات الأيديولوجية نحو قراءة معرفية رصينة للتاريخ الثقافي. وقد شكّلت الفلسفة رافدًا عميقًا في مجمل خطابه، لا كاختصاص معزول، بل كطريقة في الرؤية، وفي تحليل الظواهر والنصوص والأسئلة المعقدة. وفي كل ذلك، ظل البازعي يربط الفكر بالممارسة، لا ينعزل في برج عاجي، ولا يتورط في السجالات العقيمة. اليوم، وبعد أكثر من أربعة عقود من الحضور الثقافي، يمكن القول إن مشروع سعد البازعي لم يكتفِ بأن يكون صوتًا سعوديًا مثقفًا، بل أصبح جزءًا من الوعي النقدي العربي الحديث. وهو لا يقدّم أجوبة جاهزة، بل يُحيل القارئ إلى متاهات الأسئلة، ويطالبه بالمشاركة، لا بالاستهلاك.
إننا أمام مشروع ثقافي متكامل، يُعلّمنا كيف نفكر، لا ماذا نفكر. كيف نعيد قراءة نصوصنا وتواريخنا وعلاقاتنا بالآخر، لا كيف نكرر ما قيل. ولهذا، فإن القيمة الأعمق لما كتبه وقاله سعد البازعي لا تكمن فقط في محتواه، بل في المنهج الذي يقترحه، وفي المسافة التي يدعونا أن نقطعها معه، من أجل أن نفهم أنفسنا والعالم، فهمًا أعمق، وأكثر مسؤولية.
ومن هنا، فإن هذا التقرير لا يكتفي باستعراض محطات فكرية أو إعادة عرض أقوال، بل يسعى لأن يكون مرجعًا متكاملًا لفهم الدكتور سعد البازعي، فكرًا وموقفًا ومشروعًا. لقد جمعنا فيه أطياف صوته كما ظهرت في كتبه ومحاضراته ولقاءاته، وتابعنا فيه تحولات لغته النقدية، وموقعه من أسئلة العصر، ومساهماته في بناء مشهد ثقافي سعودي أكثر وعيًا واتساعًا. هو تقريرٌ يُقرأ على مهل، ويُعاد الرجوع إليه لفهم أحد أهم المثقفين العرب الذين اختاروا أن يُفكّروا من الداخل، ويُجادلوا من موقع المسؤولية، ويكتبوا لا لأنهم يملكون الأجوبة، بل لأنهم يعرفون قيمة السؤال.
الخاتمة

أدب ماب
جميع الحقوق مسجلة لدى هيئة الملكية الفكرية © 2025
Adapmap
خريطة الموقع


